المقدمة:
قدمت الصين ومازالت تقدم نموذجاً غايةً في الفرادة في تحقيق النهضة التنموية على جميع الأصعدة التي اتخذت شكلاً تصاعدياً، فبالتالي فهم الصين المعاصرة اليوم هو أشبه بما يكون برحلة معرفية آسرة ومتعددة التخصصات والتشعبات، وليس هنالك بالضرورة نهاية لهذه الرحلة المعرفية لكونها سارية ومستمرة، ولفهم هذه التجربة التي لا تقيدها قيود زمنية أو حدود إقليمية يجب العودة بالبحث والنبش عن أسبابها وشروط تحققها.
لقد أثّرت الحضارات الصينية القديمة على البشرية بعمق لا يمكن تجاهله وألقت بظلالها الغنية على كل التاريخ الإنساني، بينما تتطور الإنجازات للصين المعاصرة بقوة وتجذب الانتباه الدولي؛ علاوة على ذلك، تتميز سياسات الصين الخارجية والاقتصادية بخصائص قوة عظمى ناشئة وصاعدة في عالم ما بعد حداثي يأخذ فيه الصراع الجيوسياسي أشكال متعددة ومعقدة، يصعب التنبؤ بمستقبلها ولا يمكن حصرها في إطار زمني محدد أو منظور أحادي التفسير، ورغم أن رحلة فهم الصين ليست سهلة وذلك بالنظر لقدم البلاد وكتلتها الجغرافية والسكانية الهائلة، إلا أن السفر والتوقف في البلاد نفسها يُسهّلها.
يبلغ عدد سكان الصين حوالي 1.4 مليار نسمة، وتمتد على مساحة شاسعة تضم عدة مقاطعات تضم العديد من مقاطعات الأقليات الأثنية والعرقية، وتتنوع طبيعة الأرض؛ فعلى سبيل المثال، في الصين يختلف مناخ الشمال عن مناخ الجنوب.
تحد الصين أربع عشرة دولة لكم أن تتخيلوا، وهو أكبر عدد من الحدود في العالم، ولديها 3 ملايين كيلومتر مربع من المياه الإقليمية الخاضعة لسيادتها وفق اتفاق قانون البحار التابع للأمم المتحدة وبينما تبدو واسعة وفوضوية وغامضة للمراقبين الخارجيين وغير المختصين خصوصاً إذا كان هؤلاء يحملون عقلية استشراقية فوقية ومؤمنين بنظريات وأوهام المركزية الغربية، إلا أنها تكشف عن صورة دافئة وودية وغاية في الإنسانية والتفرد لزائريها والمهتمين والباحثين غير المنحازين، إلا أن الاقتراب الموضوعي منها يكشف عن تجربة حضارة إنسانية عميقة ومتفردة، تتفاعل فيها التقاليد مع التنمية المعاصرة ضمن مشروع حضاري حداثي لا يزال في طور التشكل. إنّ ما يجعل التجربة الصينية مثيرة للإعجاب والتأمل هو قدرتها العالية على الجمع بين النقائض آنٍ واحد، الانفتاح والانضباط، الفرد والجماعة، فهي تُعيد إنتاج ذاتها دون أن تذوب في تجارب الآخرين، وتتعامل مع العولمة لا بوصفها تهديداً، بل كنظام عمل و فرصة لإثبات الخصوصية والمشاركة في صياغة المستقبل العالمي وفق منطقٍ دبلوماسي مختلف غير صدامي أو استعلائي

استهلال:
إن الموضوع الأساسي لهذه الدراسة يعنى بالدرجة الأولى بتقديم تحليل يرصد بشكل تاريخي سياسي كيف تحولت الصين المعاصرة إلى قطب دولي بعد انتعاشها الاقتصادي المذهل وتطورها التكنولوجي المهول في نهايات القرن المنصرم، إذ نحاول فيه رصد نسق التطور الحضاري للصين وحجمه وتسارع وتيرته واتساع رقعة تأثيره، على كافة القطاعات والصعد عبر بحثٍ جادٍ و علميٍ حول العديد من القضايا التي تحاول أن تقدم لقارئها عموماً والباحثين بوجهٍ خاص عدة أجوبةٍ وتساؤلات، وذلك نابع لكون تجربة الصين الحالية أشبه بأسطورة ومعجزة حضارية بما تطرحه علينا من أسئلة كبرى جوهرية غاية في التشعب والتعدد،وذلك بخصوص نظريات النمو المعاصر وأنماطه ومدارسه وأشكاله وإنعكاساته.
نعني ب«الاستثنائية في التجربة الصينية» إلى حدثٍ فريدٍ لا يمكن مقارنته بغيره، ولا يجوز إضفاء طابعٍ نسبي أو سياقي عليه، لأنه سيكون أشبه بحكم قيمة مزيّف يشكّل الكنابة والبحث والغوص فيه هماً معرفياً، يقلب الكثير من مفاهيمنا عن الذات والعالم وتصوراتنا للإنسانية وفهمنا لها. جوهر المسألة يكمن في الفرادة النوعية والوجودية للصين المعاصرة، التي صنعت نموذجاً لنهوضٍ شامل يتجاوز التفسير البسيط لعوامل القوة الاقتصادية أو العسكرية، ليطال عمق البنى الفكرية والثقافية والقيمية للمجتمع، فنحن هنا أمام تجربة حضارية رائدة، منظّمة، مؤدلجة ومبقرطة لها «علومها» وأخلاقياتها وجمالياتها، وقد اعتبرت تقدّمها وصعودها «حلاً نهائياً» وعقلانياً، ليس فقط لمشكلاتها الداخلية، بل كنموذجٍ أيقونيٍّ حيّ لمواجهة مشكلات كونية كبرى: من قضايا الإحياء الحضاري وصراعات الأيديولوجيا، إلى مواجهة الرأسمالية، ومن «روح الأمة» وتوحيدها إلى مسألة الأقليات و«السيادة في عصر العولمة» بكل إشكالياتها. يضاف إلى ذلك قدرتها على إنتاج سردية جامعة حول المستقبل، تستند إلى ثقةٍ متنامية بالذات التاريخية، وتقدّم نفسها كطريق مختلف نحو التحديث، لا يستنسخ التجارب الغربية ولا يتصادم معها تماماً، بل يعيد صياغة شروط اللعبة الدولية. لقد نجحت الصين في تحقيق أهدافها بكفاءةٍ إداريةٍ وسياسيةٍ وقانونيةٍ وتنظيميةٍ عالية، عبر حشد طاقات شعبٍ بأكمله عايش الانتكاس والانحطاط الحضاري بأقبح نماذجه: من الاحتلال والاستباحة والإبادة الاستعمارية، إذ تمكّنت من تحويل الذاكرة الجريحة إلى قوة دفعٍ حضاريةٍ كبرى، جعلت من «النهضة» مشروعاً وجودياً لا مجرد برنامج عملٍ سياسيّ طموح، فتلك تجربة غير مسبوقة في التاريخ الحديث على الأقل، وتطرح أسئلة شديدة الصعوبة والتعقيد حول العقل الإنساني نفسه ودوره، وحدود ما يمكن أن يبلغه التخطيط المنظم والعزيمة الثابتة حين يقترن بفاعلية الإرادة والعمل في حياة أمة وتاريخ شعب, لقد استطاعت الصين أن تُقدّم للعالم صيغةً ثالثة تتجاوز ثنائية الشرق والغرب الكلاسيكية، والتقليد والتحديث، متبنّية مشروعاً عقلانياً جمعياٌ بحتاٌ ذا طابعٍ أخلاقيٍّ، يؤمن بأن النهضة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تماهي الدولة المنظم مع المجتمع، والفرد مع الغايات الكبرى لللأمة، ومن هنا تغدو التجربة الصينية ليس فقط درساً في التنظيم والكفاءة، بل درساً في الفلسفة السياسية والاجتماعية، يطرح تساؤلاتٍ جديدة حول معنى الحرية وأخلاقيات السلطة، ودور الدولة المعاصر في تشكيل المصير الجمعي.
اعتمادنا الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لا يقلل من تاريخية بحثنا إذ سيتضح بصورة جلية للقراء أن موضوعات الدراسة تعنى بشكلٍ رئيسي ومكثف بعرض الجذور التاريخية للنهضة الصينية ومراحل تطورها والقضايا الإشكالية والأزمات التي واجهتها وتواجهها منذ قيام الجمهورية الشعبية وانتصار الثورة التي احتفلت هذا العام بعيدها السادس والسبعين، إذا أنه من المحال أن تقدم دراسة بحثية واحدة مكتفية بذاتها غوصاً تاريخياً يفصل حتى بالتلميح الموجز والمختصر حضارة عمرها يمتد لأكثر من خمسة آلاف عام عبر 24 مرحلة زمنية شهدت الكثير من الأحداث التي أثرت في البشرية جمعاء ولذلك فإن تاريخية البحث ومنهجيته هو أسلوب كتابته و نوعية صياغته, إنّ الغاية من اعتماد هذا المسار المنهجي ليست فقط الإحاطة بالتحولات الكبرى التي مرّت بها الصين المعاصرة، بل كذلك تقديم قراءة نقدية موضوعية تسائل مفاهيم النهضة والتنمية من منظورٍ مقارن، وتسعى إلى استنباط الدروس الحضارية التي يمكن الإفادة منها في سياقاتٍ ثقافات وبلدن أخرى. فالدراسة، بهذا المعنى، لا تُعنى بالسرد التاريخي فحسب، بل تهدف إلى بناء فهمٍ معرفيٍ شاملٍ ومتعدد الأبعاد للتجربة الصينية.

الفصل الأول: أفول إمبراطورية التشينغ:
“دخلت العصابتان البريطانية والفرنسية كاتدرائية آسيا، أحدهما قام بالنهب، والآخر قام بالحرق وأحد هذين المنتصرين ملأ جيوبه والثاني ملأ صناديقه، وعادا إلى أوروبا أيديهم في أيدي بعضٍ ضاحكين، إن الحكومات تتحول أحياناً إلى لصوص ولكنّ الشعوب لا تفعل ذلك“
فيكتور هوجو
إن نظام الإقطاع الزراعي الكامبرادوري الذي أبقى الصين بلداً متخلفاً، وفي حالة تبعية دائمة وشبه مستعمر نظام يمثل البرجوازية التقليدية في المدن الكبرى، فإلى جانب كل الطبقات المالكة الأخرى لوسائل الإنتاج ممثلة بالعائلات الزراعية الإقطاعية،.أعادت تلك الطبقة استثمار الثروات التي راكمتها عبر احتكارها وإشرافها الحصري على التجارة الخارجية، مما مكنها من مراكمة نفوذ سياسي هائل وارتباطها بالإمبريالية الدولية التي بدأ نفوذها الاستعماري يتغلغل في الصين منذ بدايات القرن التاسع عشر ووصل لذروته حين هزمت بريطانيا قوات الإمبراطور داو غوانغ في معارك بحرية وإنزالات برية عرفت بحرب الأفيون الأولى وانتهت بفرض «معاهدة نانجينغ» عام 1842.وبمقتضى شروط الاتفاقية المذلة، فُرضت على الصين فتح موانئ أخرى أمام التجارة الأجنبية الدولية كما تنازلت عن مقاطعة هونغ كونغ لبريطانيا مع دفع تعويضات للمستعمرين وزاد عدد الموانئ التي يمكن أن يستخدمها البريطانيون في التجارة والإقامة من ميناء واحد (كانتون) إلى خمسة من بينها شنغهاي، إذ كانت هذه البداية لسلسة من الكانتونات ((مناطق نفوذ أو محميات)) في المدن الكبيرة يتم فيها الحكم بالقانون الأجنبي وليس الوطني.
شكّلت المستعمرات التجارية الأمريكية والأوروبية ضغوطاً على الإنتاج القومي للبلاد الزراعي الطابع، والصناعة الحرفية البسيطة ؛ التي دمرتها الواردات الضخمة للسلع الأوروبية، فيما أدى التغير السريع في أنماط التجارة الريعية إلى تدمير مناطق عديدة في قلب البلاد والتي أصبحت تعتمد على نوع واحد من زراعة المحاصيل لتلبية حاجات التصدير.
تم توقيع معاهدة تيان-تسن عام 1858 بين الصين والدول الإمبريالية مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وذلك في قلب القصر الإمبراطوري، إذ فرضت هذه المعاهدة على الصين شروطاً قاسية، تعكس موقف القوى الأوروبية الاستعماري الظالم تجاه الصين وشعبها. من أبرز بنود الاتفاقية السماح بحرية تجارة الأفيون، مما أدى إلى زيادة إدمانه بين الصينيين، حيث ارتفع عدد المدمنين في الصين من مليوني مدمن عام 1850م ليصل إلى 120 مليوناً سنة 1878، وفتح أحد عشر ميناء صينياً لزيادة الاستيراد من المستعمرات الهندية وحق إنشاء السفارات في بكين، ويظل من أقسى وقائعها أنها شرعت لفرنسا حرية التبشير الكاثوليكي وحماية الإمبراطور لمعتنقي المسيحية من رعيته وهو كان من المحظورات في السابق حقاً في الصين، وثبتت لندن كحاكم فعلي للبلاد إذ ضمن لها الاتفاق حرية الدخول لأي جزءٍ من الإمبراطورية، بجانب حق الملاحة في نهر «اليانجستي» أهم ممرات البلاد المائية الذي يوصل شرقها بمغاربها. كان طبقة تجّار” الكُوهونغ “Cohong” من رموز قرن الذل وتولّوا احتكار التجارة الخارجية مع الغرب وتحديداً في القرنين الثامن عشر وبداية التاسع عشر وانتهت سلطتهم مع نهاية حرب الأفيون الأولى الحرب 1842 التي مهدت لزمن الوصاية الأجنبية الشبه المطلقة على البلاد قرن الذل الذي كانت العمالة الصينية فيه مادة للإتجار بالبشر برعاية الكولنيانات الأوربية.

“العبودية المقنّعة: الوجه الآخر للتراكم الرأسمالي الغربي”:
إن أبرز الميكانزيمات التي ساهمت نوعياً في عملية التطور والتراكم الغربي، لكونها في الأساس عملية تطور أنظمة النهب والسلب والاستعباد الحضاري فما عرف حينها بتجارة الخنازير (تجارة العمال الصينيين) كنوع جديد من العبودية المقنّعة، فقد كانت العمالة الصينية تكدس على ظهور السفن التي سميت ب “الجحيم العائم” كخامات البضائع وتشحن إلى المناجم والمزارع الكبرى التي شكلت مستعمرات ما عرف بالعالم الجديد ليحلوا محل الأرقاء الأفارقة بعد انتهاء تجارة الرقيق الأفريقي رسمياً في القرن التاسع عشر (خصوصاً بعد القرارات البريطانية والأمريكية بحظرها)، لم تتوقف حاجة القوى الاستعمارية إلى العمالة الرخيصة. فبدأت مرحلة جديدة من استغلال العمالة الآسيوية، وخاصة الصينية والهندية، عبر ما سُمّي بنظام “العمل المأجور المقيد (indentured labor)، فهؤلاء العمال كانوا يُجندون عن طريق عمليات سمسرة — غالباً بالخداع أو الإكراه — ويُرحّلون في ظروف قاسية إلى المستعمرات الزراعية والمناجم في الأمريكيتين وجزر الكاريبي وجنوب شرق آسيا، وكانوا يعيشون أوضاعاً غاية في البؤس لا تختلف كثيراً عن واقع العبودية الكلاسيكية، إذ كان هذا الإتجار بالبشر أحد طرق ممارسة العنف من قبل الإمبريالية على الشعوب الهامشية المظلومة لكي يخفف من تكاليف الإنتاج ويقلل من حصة هذه البلدان من ناتج قوى العمل، ويقود إلى فائض إنتاج في دول المركز الغربي، الذي هو ماينتج الهيمنة بمعناه كفائض قيمة مادي، هذا التهجير أدى إلى تشتيت واسع للسكان الآسيويين في أنحاء الإمبراطوريات الاستعمارية الغربية، مما ساهم في تكوين مجتمعات آسيوية مهاجرة في الكاريبي وأميركا الجنوبية وأفريقيا، غير أن هذه الهجرات لم تكن طوعية بالكامل، بل كانت جزءاً من عمليات هندسة ديموغرافية استعمارية هدفت إلى السيطرة على عمليات الإنتاج وانتظامها وضبط التوازنات العرقية والاجتماعية داخل المستعمرات.
ثورة عام 1911 التي أنهت حكم سلالة تشينغ، المعروفة أيضاً باسم سلالة مانشو، آخر سلالة إمبراطورية حكمت الصين لأكثر من قرنين، حيث أطاحت بالأسرة وأعلنت قيام الجمهورية الصينية، غير أنَّ سقوط العرش الإمبراطوري لم يُسقط البنى الاقتصادية التابعة والمتخلفة والفاسدة سياسياً التي نمت حوله، فالجمهورية الوليدة لم تمتلك الأدوات ولا الرؤى أو القيادة القادرة على تفكيك نظام التبعية الاقتصادي الذي كان يكبل البلاد ويسخرها لخدمة الإمبريالية الأوروبية التي كانت تعيش عصرها الذهبي، فمنذ البعثة بقيادة اللورد الإنجليزي ماكارتني 1793 التي طالبت بفتح أسواق التجارة الدولية الحرة وإقامة بعثة دبلوماسية دائمة ومطالبة الإمبراطور بإجراء إصلاح جذري على مجمل اقتصاد بلاده والعمل على تحديثه”تغريبه” على النهج الأوروبي، إذ لم يقبل الإمبراطور تشيان لونغ – بسهولة هذه الإملاءات ورفض تلبية معظمها لكونها في جوهرها تتناقض مع نهج البلاد القائم على سياسات صارمة تقنّن التعامل الاقتصادي، والتبادل التجاري مع الغرب، وتحصره عبر موانئ محدّدة وحصرية، فهذا النظام التجاري شبه مغلق و يُحدِّد طبيعة التبادلات مع العالم الخارجي في سلع محددة، فقد كانت الصين تُصدِّر الخزف والشاي والحرير إلى الدول الأجنبية مقابل الفضة، في إطار منظومة تجارية وقانونية مُحكمة تشرف عليها محكمة البلاط الإمبراطوري مباشرةً وكان هذا النهج معمول فيه بثبات منذ عهدِ أباطرة سلالة مينغ 1368-1644 .
عادَ الوفدُ الخائبُ أدراجَه، واستمرَّ حظرُ السِّلعِ الغربيّةِ في الأسواقِ الصينيّةِ حتّى اندلاعِ حروبِ الأفيون في منتصفِ القرنِ التاسعَ عشر، حين فُرِضَ الانفتاحُ على المبادلاتِ التجاريّةِ عُنوةً وبشكل إكراهي وفي ظروفٍ بالغةِ القسوةِ على الصينيين، ومنذ ذلك الحين، عبثت القوى الخارجيّةُ بمصيرِ البلادِ قرابةَ قرنٍ من الزمان، واستغرق استرجاعُ السيادةِ الاقتصاديّةِ مدّةً مماثلة، دفعَ خلالها الشعبُ الصينيُّ أثماناً باهظةً من الكوارثِ الإنسانيّةِ في سبيل ِالتحرر وبعثِ دورة النموِّ من جديد، ويعزو بعضُ المؤرّخين إلى سياسةِ الانزواءِ التي انتهجها تشيان لونغ ومن سبقه تفويتَ الصينِ فرصةَ التواصلِ والتكيّفِ مع معطياتِ القوّةِ الغربيّة والثورة العلمية الصناعية، بما كان من شأنه أن يبعثَ في الدولةِ إصلاحاتٍ ضروريّةً لتداركِ فجوةِ التقدّم الحضاري فيما بدأت نُذر التغيير تتصاعد من داخل المجتمع ذاته.

انتفاضات داخلية: تمرد تايبينغ:
في خضم هذه التحوّلات، تبلورت لدى النخبة المثقفة والجيل الشاب قناعةٌ متزايدة بأنّ الصين لا يمكن أن تستمر على ذات النمط التقليدي في الحكم والإدارة والتعليم، وأنّ النهضة لا بد أن تمر عبر إصلاحٍ شاملٍ في الفكر والسياسة والاقتصاد، فقد انعكست هذه الروح الجديدة في مشروعات تحديث البنية التحتية، حيث بدأ العمل في بناء السكك الحديدية وتوسيع الصناعات والتجارة، مع فسح المجال تدريجياً أمام المنظمات السياسية لتنشط داخل المدن الكبرى التي تحتك مع المصالح الأوروبية. كما شهدت البلاد في عدد من الصحف والمجلات وهي الأولى في تاريخ البلاد، وابتعاث الطلبة إلى الخارج لدراسة العلوم الحديثة، في محاولة متأخرة لتدارك التأخر المعرفي والاستفادة إقتباسياً من عناصر القوة في الغرب. بدأ التعليم السياسي يتسلل إلى الطبقة الحاكمة التي شرعت في التعرف على مبادئ الديمقراطية والنظم البرلمانية والفلسفات السياسية المعاصرة، في خطوة نحو إنفتاح سياسي داخلي محدود.
وفي عام 1908، أعلن البلاط الإمبراطوري الحاكم عن برنامج إصلاح شامل يهدف إلى التحول نحو نظام الملكية الدستورية خلال تسع سنوات، في محاولة لتدارك الأزمة الوطنية العميقة التي عصفت بالبلاد. إلا أنّ هذه الإصلاحات، على محدوديتها، لم تفلح في معالجة التناقضات البنيوية المفتتة التي كانت تمزّق المجتمع الصيني بين التبعية للإمبراطور وبين طموحات الجيل الجديد المتطلّع إلى الحرية والعلم والتغيير. من هذا التناقض بالذات، ستولد بعد عقدٍ من الزمن ثورة الرابع من مايو (1919)، بوصفها اللحظة المفصلية التي دشّنت ميلاد الصين الحديثة، وفتحت الطريق أمام بروز الفكر الماركسي الصيني ونشوء الحركة الشيوعية التي ستقود التحوّل التاريخي لاحقاً.
كانت محاولات الإصلاح الأخيرة في عهد تشينغ عديمة الجدوى تماماً، فقد حاول القصر الإمبراطوري، من خلال ترقيع سطح النظام، أن يخيط للسلطة المطلقة عباءة عصرية، فأنتج “دستوراً إمبراطورياً” يمنح الإمبراطور سلطة لا تنازع فيها، ثم أتبع ذلك بتشكيل “مجلس وزراء” كان مجرد ديكور يخفي وراءه قبضة العائلة الحاكمة الحديدية.
كان الفارق بين هذه الإصلاحات المتعرجة وطموحات الجماهير كالفرق بين الأرض والسماء، فتحولت قنوات الإصلاح إلى سدود منيعة، وتجمع السخط تحت الأرض كحمم بركانية تبحث عن منفذ. وعندما انطلقت الشرارة الأولى من ووتشانغ، تهاوى صرح الإمبراطورية العتيق في أربعة أشهر فقط، وكأنه قصر من ورق لم تكن تحتاج إلا إلى نفخة ليطير.
لم يكن سقوط تشينغ مفاجئاً، بل كان النهاية الطبيعية لشجرة جفت جذورها منذ زمن، وكانت الثورة مجرد منجل حصاد التاريخ. لكن المفارقة كانت أن الثورة التي أسقطت الإمبراطور لم تستطع أن تبني جمهورية حقيقية، فبقيت الأحلام الديمقراطية كطائرٍ حلق في سماءٍ مقفلة، تاركاً وراءه ظلاً طويلاً من التساؤلات على أرض الصين الحديثة.
لقد أكد تطور الأحداث مدى ضعف السلطة الحاكمة وعجزها عن الحفاظ على سيادة البلاد من جهة، وعدم قدرتها على التحكم في الأوضاع المضطربة وفشلها في مواجهة الانتفاضات الفلاحية من جهة ثانية، وقد كان من أخطرها انتقاضة التايبينغ ( 1850 – 1864 )، هذه الثورة التي يمكن تشبيهها بثورة الفلاحين في ألمانيا (1524–1525) التي هزت عرش الأمبراطورية الرومانية المقدسة وكانت أول ثورة فعلية ساهمت في إنهاء الإقطاع الزراعي.
تزعم حركة التمرد (هونج شيوى تشيوان) الذي اعتنق المسيحية وادعى أنه الشقيق الأصغر المسيح للسيد المسيح !!!! وأنه بإتصال مع السماء ودعى للتخلي عن الديانات و العقائد الممارسة واعتناق دينٍ جديدٍ فيه مكون من خلائط عقائدية من المسيحية مع مزيج من الديانات الشعبية وبمعنى آخر نسخة مسيحية صينية كانت نتاجاً مباشراً لعمل إرساليات التبشير الأوروبية
بتنظيم أتباعه في صفوف جيش تايبينغ، الذي تحوّل سريعاً إلى قوة عسكرية معتبرة شديدة التنظيم، وبحلول عام 1853، تمكن هذا الجيش من السيطرة على المدينة التاريخية نانجينغ عاصمة وآل مينغ السابقة والحاضرة الشرقية للبلاد، التي اتخذها عاصمة لدولته الجديدة في الشمال، وأسس بقوة السلاح مملكة السلام السماوي. واصل جيشه شمالاً وكاد يستولي على عاصمة تشينغ في بكين، حيث كان جيش تايبينغ مختلفاً جذرياً عن الجيوش التقليدية في الصين، إذ لعبت النساء فيه دوراً بارزاً كمقاتلات وقائدات، كما اتسمت الحركة بانضباط ديني صارم، حيث مُنع الجنود من شرب الخمر أو تعاطي الأفيون، وفُرضت عليهم قوانين أخلاقية دقيقة شملت جميع الأتباع دون استثناء.
وخلال هذا الصراع الداخلي الكبير الذي ربما قتل أكثر من 20 مليون صيني، في حين أن قوات تشينغ مع بعض المساعدة الخارجية البريطانية والأمريكية دمرت في النهاية جيوش تايبينغ، حيث أدى الضعف العسكري إلى مزيد من الهزائم ضد القوى الأجنبية، إذ استولت القوات البريطانية والفرنسية على بكين في حدثٍ أعقبه نهب واسع النطاق وتدمير عشوائي أُجبر الصين على توقيع معاهدات إضافية في عامي 1858 و1860، لتتنازل مرة أخرى عن الأراضي وتخضع للقوى الأجنبية بما في ذلك روسيا وألمانيا القيصريتان.
كان تمرد التايبينغ تعبيراً مبكراً عن الوعي الطبقي والتمرد على الظلم الاجتماعي في الصين التقليدية. فبالنسبة للزعيم ماو، لم تكن تلك الثورة مجرد حركة دينية أو تمرداً سياسيا،ً أنفصالياً، بل كانت نموذجاً أولياً للصراع بين الفلاحين والمستغِلين، بين القوى الشعبية والسلطة الإمبراطورية المتحالفة مع الإقطاعيين و المرعية من الأجانب. رأى فيها تأكيداً على أن الفلاحين هم القوة المحركة للتاريخ الصيني، وهي الفكرة التي ستصبح لاحقاً حجر الأساس في فكره الثوري وأهم إضافاته للفكر الاشتراكي

سقوط الإمبراطورية: ثورة شينهاي 1911 وإعلان الجمهورية بقيادة صن يات سين:
يُظهر المناخ العام الذي عاشته الصين في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين حجم التحوّلات العميقة التي كانت تمهّد لانفجار ثورة فكرية واجتماعية غير مسبوقة. فقد كانت البلاد آنذاك تعيش حالة من الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والانكسار الحضاري أمام القوى الأجنبية التي فرضت نفوذها على الموانئ والمدن الكبرى، فيما بدأت نُذر التغيير تتصاعد من داخل المجتمع ذاته.
في خضم هذه التحوّلات، تبلورت لدى النخبة المثقفة والجيل الشاب قناعةٌ متزايدة بأنّ الصين لا يمكن أن تستمر على ذات النمط التقليدي في الحكم والإدارة والتعليم، وأنّ النهضة لا بد أن تمر عبر إصلاح شامل في الفكر والسياسة والاقتصاد.
لقد انعكست هذه الروح الجديدة في مشروعات تحديث البنية التحتية، حيث بدأ العمل في بناء السكك الحديدية وتوسيع الصناعات والتجارة، مع فسح المجال تدريجياً أمام المنظمات السياسية لتنشط داخل المدن. كما شهدت البلاد نهضة إعلامية وفكرية غير مسبوقة تمثلت في صدور الصحف والمجلات الأولى، وابتعاث الطلبة إلى الخارج لدراسة العلوم الحديثة، في محاولة لاقتباس عناصر القوة من الغرب. وفي الوقت ذاته، بدأ التعليم السياسي يتسلل إلى الطبقة الحاكمة التي شرعت في التعرف على مبادئ الديمقراطية والنظم البرلمانية، في خطوة نحو الإصلاح السياسي الداخلي.
وفي عام 1908، أعلن البلاط الحاكم عن برنامج إصلاح شامل يهدف إلى التحول نحو نظام الملكية الدستورية خلال تسع سنوات، في محاولة لتدارك الأزمة الوطنية العميقة، إلا أنّ هذه الإصلاحات، على محدوديتها، لم تفلح في معالجة التناقضات البنيوية التي كانت تمزّق المجتمع الصيني بين التبعية للإمبراطور وبين طموحات الجيل الجديد المتطلّع إلى الحرية والعلم والتغيير.
بالتالي نشأت بذور التفتت والانقسام في غضون الحقبة التشينغية المتأخرة، حيث تنامت مراكز القوى الإقليمية وتشبثت التقاليد القديمة بمكامن النفوذ، وعندما سقط النظام الإمبراطوري، كان ذلك بمثابة إزالة الغطاء عن بركان كانت حممه تختمر منذ عقود، فما ظهر في مرحلة بييانغ لم يكن سوى تجليات لقوى قديمة تلبست ثوب العصر الجديد، وهي ظواهر لا تعكس بأي حال روح النظام الجمهوري الناشئ.
في أحضان مجتمع متأرجح تحت وطأة أواخر عهد أسرة كوينغ، برزت شرائح اجتماعية حملت في وعيها بذور التحول. لم يكن أبناء الموظفين والعسكريين، ولا أولئك المنحدرين من عوائل التجار الميسورين وأرباب الورش، مجرد ممثلين لطبقات محظوظة فحسب، بل شكلوا شريحةً واعية تمتعت بالاستقرار المادي والفرص – المشروعة وغير المشروعة – في ظل نظام آفل. لكن هذا الرفاه الهش لم يحجب عن أبصارهم عوار النظام، فاتجهت أنظارهم نحو الأفكار الوافدة كمنقذ.
في مساحات الحوارات الخافتة، بين طيات الكتب المهترئة، بدأت تتشكل قناعات جديدة. لم تعد النظريات الديمقراطية والاجتماعية الغربية مجرد فضول فكري، بل تحولت إلى إيمان راسخ: إن خلاص الصين لن يأتي إلا من الجمهورية. كانت هذه الفكرة تستقطب أولئك الذين رأوا في النظام الجديد نافذة أمل، وممراً يفتح أمامهم آفاقاً لم تكن متاحة تحت ظل الإمبراطورية البالية.
على الجانب الآخر، كان التجار وأصحاب الحرف والصناعات المحلية يخوضون معركة وجودية مختلفة. لقد وجدوا أنفسهم محشورين بين مطرقة المنافسة الأجنبية وسندان الضرائب المجحفة. كانت بضائع القوى الاستعمارية تتدفق إلى الأسواق محمية بامتيازات جائرة، بينما كانت منتجاتهم المحلية تتحمل أعباءً ضريبية خانقة، مما أفقر رأس المال الوطني وأعاق نموه. في هذا السياق، لم يكن الدعوة إلى طرد الأجنبي شعاراً وطنياً مجرداً، بل كان ضرورة اقتصادية، وخطوة للنجاة من اختناق السوق.
وفي قاع هذه المعادلة المعقدة، كانت تتراكم مظالم شريحة أخرى ناشئة: الطبقة العاملة البروليتاريا التي بدأت تتشكل في ظل التحول الرأسمالي، عانت من ظروف عمل قاسية، وسكن بائس، واستغلال مضاعف – حتى من أيدي أرباب العمل الصينيين أنفسهم. في تلك المرحلة المبكرة، كانت هذه الطبقة لا تزال تفتقر إلى الأدوات التنظيمية، والنظرية التي تستوعب خصوصية وضعها. لذا، تجمع غضبها الأولي تجاه النظام الحاكم، مانشو، باعتباره العدو الرئيسي. لكن بذور الصراع المستقبلي كانت قد زرعت، لتنمو لاحقاً وتكشف عن التناقض الحاد بين رأس المال والعمل، في فصل لاحق من دراما التحول الصيني العظيم.
وفي مهاجر البعيد، ظلّت قلوب المغتربين معلقة بأرض الوطن، تنتفض أرواحهم لوعةً على حاله المتداعي. كانوا يشعرون بأنّ جذورهم ما زالت مغروسة في تراب الصين، فلم تكن تحويلاتهم المالية مجرد أموال، بل كانت وقوداً للحراك الثوري، وحبال إنقاذ يرمونها لإنهاء مأساة وطن يغرق في وحل التخلف.
حتى داخل القلاع الحاكمة ذاتها، لم تكن الأمور على ما يرام. في جنوب البلاد، حيث تباعدت المسافات عن العاصمة بكين، بدأت بذور التمرد تنمو في قلوب كبار المسؤولين وبعض النبلاء. لم يعودوا يحتملون تلقي الأوامر من عاصمة بعيدة، فأخذت تظهر بينهم نزعات انفصالية، كأمواد خفية تهدد بزعزعة أركان النظام القائم.
وفي القرى، حيث يعيش قلب الأمة النابض، كان الفلاحون يئنون تحت وطأة ظروف معيشية قاسية، حيث أدى التضخم السكاني إلى ارتفاع جنوني في إيجار الأراضي، بينما ظلّت أحلام صغار المزارعين في توسيع ممتلكاتهم تتحطم على صخرة الواقع. حول المدن الكبرى، ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات بنسب خيالية تراوحت بين 60 و70%، في طفرة لم يشهدها السوق من قبل.
لكنّ هذه المعاناة لم تترجم إلى مشاركة فعّالة في ثورة 1911، حيث ظلّ الفلاحون مشاهدين على الهامش، بينما قاد المسرح أبناء المدن. كانت طاقة الثورة تحتاج إلى قائد جامع، يستطيع توحيد هذه القوى المبعثرة، فجاءت الإجابة في شخص الدكتور صن يات صن، الذي انطلق من بين صفوف الصينيين المغتربين ليحمل راية التغيير.
هكذا تشكلت اللوحة التاريخية: مغتربون يموّلون الحلم الجمهوري من بعيد، ونخبة حاكمة تتشرذم، وفلاحون يعانون في صمت، حتى أتى القائد الذي جمع الخيوط المتناثرة في يد واحدة.

عصر الأمراء: تفكك الصين وسيطرة الأمراء العسكريين:
في هذه الرؤية، تظهر الثورة كجهد تأسيسي واجه صعوبات خارجة عن إرادته، حيث حاول بناء صرح جمهوري على أرض مهتزة بفعل عوامل تاريخية عميقة. إن إرجاع فوضى مرحلة التأسيس إلى الثورة نفسها، يشبه إلقاء لوم الطبيب على تفاقم مرض كان يستشري في جسد المريض قبل أن يبدأ علاجه.
في بوتقة المعاناة، انصهرت مأساة الأمة وولادة أملها الجديد. بعد رحيل يوان شيكاي، تحولت خريطة الصين إلى لوحة ممزقة من التنافرات، حيث توزعت السلطة بين أمراء الحرب المتعاركين، يحمل كل منهم مشروعه الخاص، من تحالف أنهوي إلى جماعة تشيلي، في مشهد من الفوضى لم تشهد له الصين مثيلاً منذ عصور.
انتقلت السلطة فعلياً إلى ثلة من النخب التجارية والإقطاعية والعسكرية التي كانت في السابق صاحبة اليد الطولى وجزءاً لايتجزأ من منظومة الفساد والمحسوبيات داخل الإمبراطورية المنحلة، فهذه الثلة لم تعنى البتة بأي مشروع وطني جامع أو موحّد، بل كان حكمها نموذجاً من سلطات الأمر الواقع و الزعامة والسيطرة الوجاهية محلية الطابع، شديدة اللامركزية بحيث كان لكل متنفذ منطقة نفوذ يتصارع عليها مع متنفذ آخر فارقه الوحيد هو العمالة للخارج والقوى الاستعمارية التي انبرت كل واحدة منها لدعم وكيلها المحلي وتأجيج الصراعات.
عرفت المرحلة المتردية ب حكومة أمراء الحرب، حيث تحوّل كل قائد عسكري أو إقطاعي إلى حاكمٍ مطلق لإقليمه له قوات شبه عسكرية مدينة بالولاء لشخصه، فنظام أمراء الحرب هؤلاء قام إقتصاده على جباية الخوات الإكراهية على الفلاحين دون أن يقوموا بأي من وظائف الدولة الفعلية، مما أدى إلى حالة من التشظي الكامل في هيكل الدولة. في هذا السياق، قام رئيس الدولة، الجنرال يوان شيكاي في محاولة صورية لإحياء الملكية، وتوج نفسه إمبراطوراً بعد أن حل المجلس الجمهوري، وعطل العمل بالدستور وقام بحملة عسكرية ضد الكومينتانغ حلفاءه السابقين واضطرّ للقبول بأغلب البنود اليابانية الواحدة والعشرين تحت ظرف دولي معقَّد يميل للإعتراف بسطوة اليابان في الشرق الأقصى، إذ قوبل بمعارضة شديدة حتى من مؤيديه، فإثر محاولته إعادة الملكية أعلنت كثير من المقاطعات استقلالها الذاتي ولخوفه من احتمال زيادة موجات التمرد والانفصال وعدم قدرته على الإمساك بالحكم ومواجهة أمراء الحرب النافذين كل هذا أجبره على إلغاء الملكية آواخر العام 1916 هكذا استمر الحال على ماهو عليه أغلب سنوات العشرينيات من القرن الماضي بالعيش تحت نير كافة القوى الإمبريالية التي حكمت مقابل حقوق انتفاع احتكارية في المدن ذات الموانئ الساحلية وموانئ الأنهار الرئيسية.
وقعت غالبية أراضي البلد المستباح تحت حكم أمراء الحرب حتى عام 1928 في جنوبي البلاد، حيث شكَّل الحزب القومي الصيني (الكومينتانج)، الذي تأسس على يد السياسي الجمهوري سون يات سين بمدينة جوانزو (كانتون)، حكومةً إنقاذ وطنية وشن حملة عسكرية باتجاه الشمال في عام 1926 بهدف نية تحرير البلاد من قبضة الهيمنة الإمبريالية وعملائها من أمراء الحرب الإقطاعيين.
مع بروز تشيانج كاي شيك قائداً لجيش التحرير الوطني، انطلقت الحملة الشمالية عام 1926 كسهم مصوب نحو قلب التشرذم، مستهدفةً توحيد ما تمزق. وبحلول 1928، نجح في جمع شتات الأمة تحت راية واحدة، لكن شبح الحرب الأهلية كان يلوح في الأفق، ممثلاً بالصراع مع الشيوعيين الذي أضاف بُعداً جديداً لتعقيدات المشهد.
بينما يرى البعض في ثورة شينهاي مجرد بوابة عَبَرَت منها الصين من عهد الإمبراطورية إلى دوامة اضطرابات عصر أمراء الحرب، فإن الحقيقة أكثر تعقيداً من هذه السببية المُبسَّطة. لم تكن الثورة شرارة الفوضى، بل كانت الضوء الذي كشف عن أعطاب متراكمة في جسد الدولة العتيق، ولم تكن عبثاً تاريخياً بل كانت ضرورة حتمية واجهت تحديات لا مفر منها. لقد حملت على عاتقها مهمة جسيمة: اقتلاع جذور نظام إقطاعي ظل متجذراً لآلاف السنين، ليس في هياكله المادية فحسب، بل في عقلية المجتمع وترسبات ثقافته. كانت معركة ضد إرث من التخلف والانقسام، وليست سبباً له.
“كان يقول سون يات سن أنه لا يوجد في الصين أغنياء وفقراء، بل فقراء والأفقر منهم، ولو عاش لفترة أطول (فقد توفى في يناير من عام 1925) لرأى ماذا يحصل عندما تتضارب رغبة “الفقير” بأن يصبح “أقل فقراً” مع رغبة “الأقل فقراً” بأن يصبح غنياً.”
من كتاب “مأساة الثورة الصينية” لهارولد آيزاكس.
لا يختلف القوميون والشيوعيون في الصين المعاصرة حول رمزية ودور صن يات صن، مؤسس حزب الكومينتانج ( ففي الجمهورية الشعبية الشيوعية وعاصمتها بكين يعتبر مؤسس الصين الحديثة ورائد الثورة الديمقراطية)، (وجمهورية الصين في جزيرة تايوان القومية يطلق عليه أبو الأمة ومؤسس الجمهورية).
فهو الذي حاول لجم الفوضى، واستعاد السيطرة على البلاد بعد موت يوان شيكاي بصعوبة بالغة بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة، ومؤسس أول جمهورية في تاريخ الصين. ركز سون يات صين في إعادة هيكلة حزب ال”كومينتانغ” القومي على بناء جيش القوميين الذي كان يتألف أساساً من ضباط الصف والجنود أصحاب الرتب المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى المثقفين ذوي التوجه القومي ومجموعات من الطبقة الوسطى، وقد بنيت سياسته الجديدة على ثلاثة أركان رئيسية، أهمها التحالف مع روسيا البلشفية بقيادة لينين، ودعوة للتعاون والتحالف مع الشيوعيين المحليين لتحقيق أهداف الحزب الوطنية.
تسببت وفاته 1925 في حدوث انشقاق تدريجي داخل الكومينتانج بين اليمينيين واليساريين، ومساعدة العمال والفلاحين، ملغياً سلطة أمراء الحرب القدامى.
بينما كانت نيران الصراعات الداخلية تتأجج في فضاءات الصين خلال عصر أمراء الحرب، تشكلت على هامش تلك المعمعة لوحة قتالية ضخمة، تجسدت في حرب السهول الوسطى التي اجتذبت أرواح مليون مقاتل إلى ساحات الوغى.
وفي خضم هذا المشهد الدامي، كانت ولادة الحزب الشيوعي الصيني عام 1921، حاملاً معه تحولاً جوهرياً لم يكن للصين وحدها، بل للخريطة العالمية بأكملها. لم تكن هذه الولادة طفرة عابرة، بل كانت تتويجاً لرحلة تراكمية من الصحوة الثقافية التي نضجت في وجدان الأمة الصينية.
عبر مسيرته التي تشبه النهر المتعرج بين الجبال، اخترق الحزب حواجز الفكر المتصلب، وقاوم إغراءات الجمود الأيديولوجي، ليصوغ من معطيات العصر نظرية ثورية متجددة، مستلهماً روح الاشتراكية العلمية. لم يكن مجرد ناقل للأفكار، بل كان حارسة أميناً على الشعلة الحضارية للشعب الصيني، يعيد صياغتها في قوالب العصر الحديث، حيث منحت هذه الروح الجديدة معنى أعمق للوجود الصيني في العالم.

حركة الثقافة الجديدة و ثورة الرابع من مايو 1919:
كما صرخ لي دا تشاو (أحد المؤسسين الرئيسيين للحزب الشيوعي الصيني) خلال حركة الرابع من مايو: “تصرفاتنا اليوم تمثل انطلاقة باتجاه مستقبل الصين المشرق.”
خلال العقد التالي الذي أعقب تأسيس الجمهورية الصينية عام 1911، الذي ساد فيه الارتباك والتخبط في كل مناحي الحياة، قاد المثقفون بمختلف تياراتهم وتوجهاتهم الأيديلوجية حركة احتجاجية لم يُشهد لها تاريخ البلاد مثيلاً من قبل. ففي عام 1919، أدت المظاهرات والعصيان الطلابي والعمالي في ذلك التاريخ احتجاجاً على حصول اليابان الاستعمارية على امتيازات الأراضي التي كانت من حصة ألمانيا القيصرية إذ نقل الحلفاء بتوصية بريطانية السيطرة على مقاطعة شاندونغ الصينية من السيطرة الألمانية بعد إنهزام إمبراطورية الرايخ الثاني في الحرب العالمية الأولى إلى سيطرة طوكيو كجائزة ترضية لمشاركتها في إنهاء وجود البحرية الألمانية شرق آسيا، وذلك عند دخولها الحرب بغايةٍ واحدةٍ تتمثل في زيادة تأثيرها الإستعماري في الصين براً وبحراً في المستقبل وهذا تحقق لاحقاٌ عام 1938، وعلى الرغم من مشاركة بكين بصفتها “بلداً منتصراً”، في مؤتمر باريس للسلام في العاصمة الفرنسية، وعلى الرغم من أن الجمهورية الصينة كانت واحدة من الحلفاء في الحرب العالمية الأولى شكلياً ؛ حيث كانت الصين تقدم مساهمتها الخفية في المعركة عبر إرسال 175 ألف عامل إلى الجبهات البعيدة، ومن بينهم 400 مترجم من نخبة “جمعية الدراسة الشعبية الجديدة” يقف في مقدمتهم تشو إن لاي، إلا أن مشاركتها في هذا المؤتمر كانت تمثيلاً رمزياً مخزي الأداء فيه انعكاس للفشل الإداري للدولة الضعيفة مستلبة الإرادة والمرتهنة سيادتها لقوى دولية أخرى، حيث طرح الممثلون الصينيون الذين حضروا الاجتماع تنازلات لألمانيا المهزومة أضرت بالسيادة الوطنية بحيث رفضت بلدان أخرى في الاجتماع مطالب الصين، فبغض النظر عن اعتبارها بلداً شريكاً هم اعتبروا أن الصين الضعيفة جداً يومها كانت أيضاً “موضوعاً” لتقاسم النفوذ وليست لاعباً نافذاً ليفرض الشروط، لكن نشطاء حركة الرابع من مايو كانوا يحملون أجندة تجديدية أوسع بكثير؛ فقد كانت حركة الرابع من مايو، التي سيطرت على الحياة الثقافية في الصين لعقود، تعتبر أن العقبة الرئيسية أمام التقدم الاجتماعي والحداثة تتمثل في الثقافة الكونفوشية بنظامها البيروقراطي، وإرثها التقليدي، ومنهجية التعليم بالطرق القديمة، فقد كان أنصار حركة الرابع من مايو يؤمنون بالحرية التي يتيحها العلم، وبقدرة الديمقراطية على التغيير.
أثار الفشل الدبلوماسي لمؤتمر باريس للسلام احتجاجات طلابية واسعة النطاق في الرابع من مايو داخل الصين، وأطلق في النهاية “حركة الرابع من مايو” الشهيرة في التاريخ.
تلك الحركة ليست مجرّد انتفاضة سياسية ضد الإقطاع أو الاستعمار، بل كانت تحولاً بنيوياً في الوعي الجمعي والشعبي، أطلق ما عُرف ب«الثورة الديمقراطية الشعبية الجديدة»، التي مثّلت الجسر التاريخي بين مرحلة التحرر الوطني وبناء الدولة الحديثة. لقد أرست تلك الثورة رغم أنها لم تنتصر الأسس الفكرية والتنظيمية للنظام الاشتراكي الصيني،الذي سيحرر البلاد من اليابانين والقوميين بعد عشرين سنة.
تمثّل حركة الرابع من مايو (1919) نقطة التحوّل الحاسمة التي أنهت عملياً مرحلة الثورة الديمقراطية القديمة في الصين، لتفتح أفقاً جديداً لما سيُعرف لاحقاً ب الثورة الديمقراطية الشعبية الجديدة، وهي ثورة حملت في جوهرها نزوعاً أممياً يتجاوز الإطار القومي الضيّق، تعبيراً عن وعيٍ جديد تبلور في أوساط المثقفين والطلبة والشباب الذين رأوا في التحرّر الوطني جزءاً من مشروعٍ عالمي للتحرّر الإنساني.
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ومبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون كانت الحركة، في عمقها، انتفاضة فكرية قبل أن تكون سياسية، إذ مثّلت رفضاً جذرياً للنظام الإقطاعي القديم وللتبعية الفكرية غير المشروطة للغرب، وفي الوقت ذاته، بحثاً عن نموذج بديل للحداثة قادر على التوفيق والمزج بين الأصالة الثقافية والحضارية وخصائص التقدم العلمي الحداثية.
وفي هذا المناخ الفكري، تهيأت الأرضية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني عام 1921، بوصفه التعبير التنظيمي الأرقى عن ذلك النزوع الأممي الذي جمع بين الفكر الماركسي والمطلب الوطني، واعتبر أن تحرّر الصين لا يمكن فصله عن تحرّر الطبقة العاملة العالمية. ومنذ ذلك الحين، دخلت الثورة الصينية مرحلة تاريخية جديدة تبلورت فيها ملامح المشروع الاشتراكي الصيني، حيث بدأت الماركسية تنتشر بسرعة في أوساط المثقفين والعمال والطلبة، وتتكامل تدريجياً مع الواقع الاجتماعي المحلي ومع الحركة العمالية الصينية التي كانت آنذاك غير منظمة تنظيماً نقابياً فعّالاً بسبب الطبيعة الزراعية للمجتمع الصيني وهيمنة الاقتصاد الريفي على بنية الإنتاج.
لقد ساهمت حركة الرابع من مايو في إدخال الفكر الجدلي والمادي التاريخي إلى ساحة الوعي الصيني بمختلف طبقاته ونخبه، فغدت الماركسية إطاراً نقدياً لفهم التخلّف والاستعمار، ومنهجاً تحررياً لفعلٍ تغييريّ واعٍ. كما تزامن صعود هذا الفكر مع اشتداد الهجمة الإمبريالية العالمية التي واجهتها الحركات التقدمية، وعلى رأسها الثورة البلشفية المنتصرة في روسيا (1917–1921) وما تبعها من حربٍ أهلية دامية، والقضاء على الحركة العمالية في ألمانيا بعد مقتل روزا لوكسمبورغ وكارل لبخنت جعلت المثقفين الصينيين يربطون بين مصير بلادهم ومصير النضال الأممي ضد الهيمنة الغربية وهذه خطيئة تكتيكية تنم عن يسارية طفولية حسب تعبير فلاديمير لينين كما سنعرف تباعاً.
وهكذا، شكلت حركة الرابع من مايو المختبر التاريخي “كمهد” تبلورت فيه ونمت بذور الماركسية الصينية الأولى، إذ لم تكن مجرّد حدث احتجاجي رمزي لمثقفي المدن ودعاة الحداثة بكل أطيافهم، بل نقطة انعطاف معرفية أعادت توجيه الفكر الصيني من الإصلاح الليبرالي الوطني إلى التوجه لمفاهيم الثورة الاجتماعية الشاملة، أي من الوعي القومي إلى الوعي الطبقي الأممي، لتصبح الشرارة الأولى في مسارٍ طويل قاد إلى تأسيس الصين الحديثة.

تأثير روسيا على حرب التحرر من أمراء الحرب:
بينما كانت الصين الغارقة في غياهب التخلف تعاني من وطأة التمزق والاضطراب، لم يكن أحد ليصدق أن هذه الأرض العريقة ستشهد ميلاد فجرٍ جديد. كانت المدن الصينية آنذاك تحمل سمات إمبراطورية آفلة، بينما امتدت الريف بمساحاته الشاسعة كشاهد على واقع زراعي بائس. في ذلك المشهد، بدت الصين أبعد ما تكون عن التوقعات الماركسية الكلاسيكية التي رأت في العمال الحضريين وقود الثورة المنتظرة.
لم تكن الصين في مخيلة الفلاسفة الأوروبيين سوى مملكة للجمود والاستبداد، حيث لا أمل بتغيير يلوح في الأفق. حتى أن أفكار ماركس ولينين ظلت غريبة عن الأسماع الصينية حتى سنوات قليلة قبل انبلاج الثورة البلشفية.
لكن شرارة التغيير جاءت من حيث لا يتوقع أحد. حين اشتعلت الثورة في روسيا، التفتت أنظار المثقفين الصينيين نحو هذا النموذج المختلف. كان قد خاب أملهم بالثورة الجمهورية التي أطاحت بالإمبراطورية عام 1911، ليجدوا أنفسهم أمام واقع مرير من حكم أمراء الحرب والتمزق الداخلي.
قدمت البلشفية رؤية مغايرة، كانت روسيا القيصرية تشبه الصين في كثير من الجوانب: مجتمعات ريفية تقليدية، أنظمة مستبدة، وتدخل أجنبي مذل. لكن لينين أعاد تشكيل النظرية الماركسية لتتلاءم مع واقع المجتمعات غير الصناعية.
وجد الصينيون في تحليل لينين للاستعمار صدى لغضبهم المكبوت من الامتيازات الأجنبية والمعاهدات الجائرة. كما أثار إعلان الحكومة السوفياتية عن نيتها إعادة الأراضي التي استولى عليها القيصر في منشوريا اهتماماً واسعاً.
هكذا بدأت رحلة الاكتشاف، انطلق الشباب الصيني المتعطش للتغيير في رحلات إلى موسكو، بينما انتشرت حلقات الدراسة في كل مكان، تتناقل الكتب المترجمة التي تحمل أفكاراً جديدة، كانت تزرع بذور التغيير في تربة صينية خصبة، مستعدة لاستقبال فجر جديد.

تأسيس الحزب الشيوعي والحروب الأهلية (1921-1937)
“على الشيوعيين أن يكونوا مستعدين فى كلّ وقت للتمسّك بالحقيقة، فالحقيقة، أية حقيقة، تتفق مع مصلحة الشعب . و على الشيوعيين أن يكونوا فى كلّ وقت على أهبة لإصلاح أخطائهم، فالأخطاء كلها ضد مصلحة الشعب.”
ماو تسى تونغ، ” الحكومة الإئتلافية “، 24 أبريل – نيسان 1945، المؤلفات المختارة، المجلّد الثالث.
يسعى هذا الفصل إلى الكشف عن الروابط بين الصين المعزولة والمحاصرة في سبعينيات القرن العشرين الذي شهد ولادة الجمهورية وانقضاء عقد الذل، والصين المعاصرة التي تُقدَّم اليوم بوصفها قوةً صاعدة على الساحة الدولية بإستعادة تاريخية تقرأ تاريخ الصين الحديث بطريقة وصفية.
لا يشكّل هذان العالمان والبعدان الزمنيان نقيضين تامين متضادين أو عوالم معزولة عن بعضها في سياقاتها التاريخية؛ فثمّة خيطٌ دقيق متصل بينهما، إذ تشتركان في جذور واحدة من قلب النظرية الماوية، فهي قوانين موضوعية تؤمن بأن التاريخ الإنساني لا يتحرك وفق نزوات عابرة أو أهواء عشوائية عبثية. بل توجد خلف صخبه قوانين موضوعية تُوجّه دفّته، وكل تحوّل فيه هو نتيجة محتومة لصراعٍ يتفاقم، فالتغيّر ليس مزاجاً طارئاً عابراً، بل ضرورة فيها الكثير من الحتمية و تولد من قلب التناقضات الاجتماعية ذات نفسها وبالتالي يتمخض الحاضر، فقد طمح ماو تسي تونغ مثل غيره من قادة الصين في القرن العشرين إلى بناء دولة قوية وحديثة تحسم سؤال المسألة الوطنية: ما شكل النظام، طبيعة الدولة وموقع الثورة فيه، فقد أسهمت بعض سياسات الثورة الثقافية في الاقتراب من هذا الهدف، بينما أظهرت سياسات أخرى نتائج أقل نفعاً وكان أثرها كارثياً، رغم ذلك جميع تلك التوجهات كوّنت المسار الفريد الخاص الذي سلكته الصين وصولاً إلى حاضرها المزدهر حالياً.
ما هو الحيّ من المرحلة الماوية، وما هو الميّت منها، تعكس حقيقة أساسية جدلية تقتضي بأن تقدم البشرية إما تسبقه النظرية أو أنها تلحق به أو تتواكب معه في محاولة إنسانية طبيعية للتعرف على التغيير وأسبابه.

من الجماعات السرية إلى الحزب: مسار التأسيس:
في ربيع العام 1921، بينما كانت نيران الصراعات الداخلية تتأجج في فضاءات البلاد، أشرقت شمس جديدة من قلب الظلام. لم تكن مجرد نقطة تحول على مسرح الأحداث الصينية، بل كانت انعطافة تاريخية أعادت تشكيل ملامح العالم بأسره.
لقد نبتت هذه الشجرة العملاقة من تربة حضارة عريقة، كانت تترقب لحظة انبعاثها عبر رحلة متعرجة بين صخور التحديات، اخترقت جذورها أعماق التاريخ لتستمد القوة من تراث أمّة لم تنقطع حلقات وعيها. في هذه المسيرة الطويلة، لم يكن الحزب مجتازاً للعواصف فحسب، بل كان يحمل في يده مصباحاً يضيء دروباً جديدة.
لقد تحرر من قيود الأفكار الجاهزة، ورفض أن يكون صدى لأصوات الآخرين، فأبدع نظرية ثورية تحمل بصمة العصر، وتنطلق من حكمة الشعب وتراثه. لم يكن ناقلاً للمبادئ، بل كان خزّاناً للروح الحضارية الصينية، يعيد صياغتها في قوالب العصر الجديد، لتمنح وجود الأمة معنى أعمق في رحلة الإنسانية.
في يوم من أيام العام 1921، حينما كانت رياح التغيير تهمس في أرجاء الصين، قال ماو تسي تونغ كلمته التاريخية: “إن شرارة صغيرة قد تشعل نيراناً تضيء السهل بأسره”. كانت هذه الكلمات نبوءة تحققت باجتماع مصيري في شانغهاي.
وسط أزقة المدينة التي كانت مقسمة بين قوى استعمارية متعددة – من الإنجليزية إلى الفرنسية، مروراً بالألمانية والأمريكية – اجتمع اثنا عشر رجلاً في القطاع الفرنسي. كانوا يمثلون مجموع ما يعرفه الوطن من الشيوعيين في تلك الحقبة: سبعة وخمسون رجلاً فقط، كأوراق شجرة خريفية قليلة، لكنهم حملوا في قلوبهم بذور ثورة عظيمة.
شق ماو تسي تونغ طريقه من إقليم هونان ليشارك في اللحظة التاريخية المتمثلة بالاجتماع التأسيسي الأول للحزب الشيوعي الصيني عام 1921. كانت شنغهاي مسرحاً لهذا الحدث المصيري الذي سيغير وجه البلاد.
كان اللقاء التأسيسي للحزب الشيوعي الصيني على شفا جرف هار، وكادت أحلام الثوار أن تتبدد قبل أن تبدأ. لكن من بين ظلال المباني الاستعمارية وأصوات اللغات الأجنبية، كانت تتهيأ أولى خطوات رحلة الألف ميل.
كان الرابع من أيار/مايو 1919 بمثابة الحدث التأسيسي للوعي الثوري الحديث في الصين ككل، إذ شكّل منطلقاً لتبلور نواة حزب ماركسيّ التوجّه من حيث الفكر والكوادر، يمكن اعتباره الجسر الذي ربط بين المنطلق الفكري النظري والتنظيم البروليتاري العملي الذي سيتطور لاحقاً إلى الحزب الشيوعي الصيني. فالحركة الطلابية التي قادها الشباب المثقف في المدن الكبرى لم تكن مجرد احتجاجٍ على بنود معاهدة فرساي أو رفضٍ للهيمنة اليابانية، بل كانت في جوهرها بداية تشكّل وعي طبقي جديد يدرك أنّ خلاص الأمة لا يتحقق إلا عبر تغيير البنية الاجتماعية والاقتصادية نفسها.
لقد انطلقت شرارة هذا الوعي من الجامعات بقيادة طلاب ثوريين، حيث اكتشف كلٌّ من ماو تسي تونغ وتشو رفيق دربه ورئيس وزراءه لاحقاً تشون إن لاي في تلك الفترة المبكرة الأفكار الاشتراكية، وتفاعلاً مع الفكر الماركسي بوصفه منهجاً لتشخيص أمراض وأزمات الواقع الصيني وإعادة صياغته، ومع اتساع رقعة الحركة الطلابية تحوّلت الأفكار إلى تنظيمٍ سياسي ناشئ أخذ على عاتقه مهمة بناء نواة الحزب الثوري القادر على توحيد الطبقة العاملة ((العمال والفلاحين)) تحت راية حزبية واحدة، في مواجهة الاحتلال وتوابعه كالإقطاع والرأسمال الأجنبي على السواء.
كانت تلك المرحلة هي الفترة التي بدأ فيها ماو يبتعد عن الفكر الإصلاحي الذي ساد بين المثقفين الصينيين المتأثرين بالغرب (أمثال هو شيه وناقد أدبي وفيلسوف ومصلح اجتماعي)، ويتجه تدريجياً وبحزم نحو الاشتراكية العلمية ممثلة بالماركسية اللينينية .
في مقاله الشهير “دراسة الفلاحين” نشر عام (1919) أكد ماو على أن تحرير الصين لا يمكن أن يتحقق من دون إشراك وإقحام طبقة الفلاحين في لب الصراع الطبقي، لم يغفل مقاله واقع الطبقة الفلاحية كمجموعة اجتماعية مهمشة فحسب، إذ درس حياتهم اليومية، ظروفهم الاقتصادية، وأنماط استغلالهم من قبل الإقطاع فكان أشبه ببيان سوسيلوجي علمي مبكرً، ويؤسس لفهم عملياتي مختلف للثورة وشروطها، يستند على الواقع الشعبي ولا يكتفي بالأطر النظرية والثوابت العقائدية.
هذه الدراسة تظهر دور ماو في تحويل الوعي الوطني إلى وعي اجتماعي–طبقي، أي نقله من مستوى “الإصلاح الثقافي” إلى ما قصد به “الثورة الاجتماعية”. هذا كان انعكاس لتجربته إذ كان من الفاعلين بين سنوات 1920 و 1921 بتنظيم اتحادات الطلبة والتجار والعمال بالحركة الاحتجاجية والنقابية.
مجريات الرابع من أيار، شكلت لدى ماو الجامعي الشاب اليقين الكلي بأنّ التغيير كصيرورة لا يمكن أن يُصنع بالاحتجاجات والمناظرات الفكرية الصاخبة وحدها، بل عبر تنظيم جماهيري مسيس هذا الإدراك المبكر والتشخيص السليم هو الذي سيدفعه، بعد عامين فقط (1921)، إلى أن يصبح من أوائل مؤسسي الحزب الشيوعي الصيني، مؤمناً بأنّ الثورة الصينية يجب أن تستند إلى التحالف بين العمال والفلاحين، لا على التنظيرات الثقافوية لدى بعض النخب ورؤاها الإصلاحية.
هذا التوجه المخالف لمعظم معاصريه من القوميين أو الشيوعيين أو الليبراليين، بل وحتى من المقربين إليه، الذين ركزوا وحصروا تطبيق فكرهم الإصلاحي في ميادين النشاط السياسي والثقافي، مع إعطاء الأولوية لتعليم النخبة ذات الخلفية البرجوازية الصغيرة. فقد اعتبر أغلبهم أن الثورة ينبغي أن تنطلق من المدن، مستندةً إلى القوى العاملة في القطاع الصناعي الناشئ، محدود الحجم والتنظيم، والمتمركز في المراكز الحضرية الكبرى، مثل شنغهاي وغوانغتشو وووهان وتيانجين، وهي المدن التي شهدت في مطلع القرن العشرين بدايات التصنيع والتجارة الحديثة، واحتضنت معظم المؤسسات الأجنبية والمصانع المملوكة للرأسمال الغربي الاحتكاري .
وهذا مرده كان لعدد من المثقفين الصينيين مثل ليانغ كيشياو، سون يات سين، تشين توهسيو، وتشونغ إن لاي، طلبة العلم الذين أقاموا في العاصمة اليابانية طوكيو وشهدوا تحولات بعد إصلاحات مييجي إلى نموذج متقدم للتحديث على النمط الغربي في كل القارة الآسيوية. هناك درس هؤلاء الفلسفات والسياسات الغربية، وتأثروا بالماركسية والنماذج الأوروبية “اليسارية” حتى كارل ماركس وفريدريك إنجلز اعتبرا أن القوة الثورية الأساسية هي البروليتاريا الصناعية وليس الفلاحية، لأن بروليتاريا المصانع محرومة بالكامل من وسائل الإنتاج أما طبقة الفلاحين تعتمد على ملكية الأرض التي مهما صغرت تجعل الفلاح أكثر تعلقاً بما لديه وأقل ميلاً للمخاطرة في سبيل تغييرات جذرية قد تهدد أرضه ومصدر إنتاجه، رغم ذلك فإن الصديقان اللذان كتبا “البيان الشيوعي” لم ينفيا إمكانية أن يضطلع الفلاحون بركاب الثورة الآتية، لكنهم سيكونون قوة داعمة مترددة وذلك لأن تحليلهما استند على واقع عمال المصانع في بريطانيا الفيكتورية وأحوال الاقتصاد الأوروبي منتصف القرن 19 وبعد نهاية الإقطاع الزراعي في بلدان معظم القارة العجوز.
إلا أن ماو تسي تونغ، الذي تشكّل وعيه من قلب الريف الصيني، كان يرى في هذا الطرح انحيازاً طبقياً وفكرياً يعكس تأثراً بالنموذج الأوروبي الصناعي الذي وُلدت فيه الماركسية، أكثر مما يعكس الواقع الاجتماعي الصيني نفسه. فالصين في مطلع القرن العشرين لم تكن دولة صناعية بالمعنى الأوروبي، بل كانت أمة شبه إقطاعية شبه رأسمالية .
لم يكن الفلاحون حينها يشكلون غالبية طبقية في ذروة ذلك العصر الصناعي على الخصوص مدنه المتورمة والهائجة بإضرابات وقلاقل العمالية. لذلك فإن أبوي الشيوعية لم يعطيا للطبقة الفلاحية آنذاك دوراً ثورياً وفي حال حدوثه فهو محدود بالضرورة التي يفرضها واقع الطبقة ونظام إنتاجها المادي، هذا التصور وهو ما كان شائعاً لدى أغلب ماركسيي القرن العشرين حتى عند منظرين ماركسين من طينة لينين وتروتسكي وبليخانوف أثناء ثورة 1905 التي أجبرت آخر قياصرة آل رومانوف على بعض الإصلاحات الدستورية. الماركسية الصينية الناشئة، فهي كمثيلاتها من التيارات اليسارية والاشتراكية الأوروبية في تلك الفترة كان فهمها “نصياً” لمبادئ الماركسية على العموم ولأن دور الفلاحين مسألة إشكالية كإشكالية أبحاث مثل ديكتاتورية البروليتاريا ورأي ماركس أن الثورات القادمة ستكون محصورة بالقارة الأوربية الذي وصلت بها الرأسمالية إلى أعلى مراحلها.
انتقل ماوتسي تونغ بالماركسية اللينينية إلى مرحلة جديدة ومتطورة خلال عشرات السنين التي قاد فيها الثورة والحزب والدولة الصينية، من خلال الكشف العملي عن نظرية ثورية تحدد بوضوح ٍ لا لبس فيه أن طريقة مواصلة الثورة بعد استلام السلطة يكون تحت لواء نظرية ثورية أممية ملتزمة بالمبادئ العامة للمادية التاريخية الماركسية، وذلك بهدف منع قيام الرأسمالية من إعادة بناء ذاتها ومن أجل مواصلة السير نحو المرحلة الشيوعية، فماوية ماو لم تكن مجرد منظومة نظرية جامدة، بل مشروع تغييري للتحوّل الوطني ارتبط بالبنية الاجتماعية الصينية ارتباطاً وثيقاً وهي نظرية “عملية” “علمية”، تم تطبيقها و وضعها موضع التنفيذ خلال فترة حكمه ومازالت حاضرة بتجدد في الحياة العامة للبلاد وقد ظهرت النظرية نفسها خلال العديد من الصراعات والانتصارات التي ولدت من رحم الهزائم والثورات المجهضة ونصف قرن من التبعية شبه المطلقة للقوى الاستعمارية، حيث كانت الثورة الصينية الأولى لسنة 1925-1927 ثورة بروليتارية حقيقية، انطلقت شرارتها في المصانع والموانئ و حمل رايتها الشارع العمالي الصيني ؛ إذ قام كادحو المدن الذين مثّلوا طليعة التحرّكات الثورية بتشكّيل النقابات العمالية بوتيرة مذهلة وبتأسيس ميليشيا أخذت زمام المبادرة، فحكم العمّال شوارع المصانع والمرافئ، وتحوّلت الملايين من سواعد الفلاحين إلى قوّة تغيير حقيقية وأطاحوا بكبار ملاّكي الأراضي والإقطاعيين والمرابين، وانتزعوا من أيديهم السلطة الاقتصادية والاجتماعية التي احتكروها قروناً. كان الحزب الشيوعي يمارس نفوذه على عشرة ملايين فلّاح صيني تقريباً، واشتمل الحراك الثوري أيضاً منع عدد من الممارسات الاجتماعية والاقتصادية الضارّة والتي هي رواسب استعمارية مثل تدخين الأفيون، والدعارة المقوننة، وغير ذلك من الظواهر التي كانت تُعد رمزاً للسيطرة.

نشأة الحروب الأهلية:
لم تمض سوى سنتين من تأسيس الحزب الشيوعي لصيني حتى تدخلت القوى الأممية في المشهد السياسي الصيني، حيث وجهت الأممية الشيوعية (الكومنتنرن) بأن تنسج الأحزاب الصينية خيوط تحالف غير مألوف. جاءت التوصية بجمع شمل الشيوعيين مع القوميين بقيادة سون يات سن، الذي كان يحلم بتفكيك سلطة الإقطاعيين وبناء صرح وطني موحد.
في عام 1924، حمل ماو حقائبه متوجهاً إلى شنغهاي مرة أخرى، لكن هذه المرة في إطار جديد رسمته سياسة التحالف التي فرضها الكومنتنرن. هناك، بين أزقة المدينة الصاخبة، بدأ هذا الكادر الشيوعي الواعد يغوص في أعماق الحياة السياسية الحضرية، متأملاً مصير بلاده بين تيارات التحالف والصراع.
في تلك المرحلة، بدا التحالف مع الحزب الوطني ضرورة تاريخية لمواجهة التحديات المشتركة. لكن هذا التحالف كان يحمل في طياته بذور صراع مستقبلي، خاصة مع بروز تشيانغ كاي تشيك كقائد للحزب الوطني بعد رحيل سون يات سين. سرعان ما تحولت هوة عدم الثقة بين الطرفين إلى مواجهات مسلحة، لتبدأ فصول ما عُرف بالحرب الأهلية الثورية الأولى.
كانت تلك الأحداث بمثابة مفترق طرق مصيري، أجبرت رجال المقاومة على ارتداء أثواب التخفي والانسحاب نحو القرى النائية. في تلك المسالك الوعرة، بين حقول الأرز والمزارع المتواضعة، اكتشفوا كنزاً ثميناً كان مغموراً تحت غبار الإهمال: الفلاحون. هؤلاء الناس البسطاء الذين تشققت أياديهم من العمل، أصبحوا اللبنة الأساسية لحركة ثورية جديدة.
وفي خضم هذه التحولات، برزت رؤية جديدة تتحدى المسلمات التقليدية. لم تعد المعامل والمدن وحدها حاضنة للثورة، بل أصبحت الحقول الخضراء منبتاً لأفكار ثورية مختلفة. كانت هذه الرؤية تمثل انعطافة تاريخية في الفكر الثوري، حيث أدرك قائدها أن قوة التغيير الحقيقية تكمن في أولئك الذين يحرثون الأرض ويقطفون ثمارها.
ومن بين أنقاض التحالف المنهار، ولدت فلسفة ثورية جديدة تختلف جوهرياً عن النماذج السابقة. لم تكن مجرد نسخة مقلدة عن تجارب الآخرين، بل كانت استجابة أصيلة لظروف الواقع الصيني. هذه الفلسفة الجديدة لم تكن مجرد نظرية مجردة، بل كانت تعبيراً عن روح مستقلة تبحث عن طريقها الخاص.
هذا المسار الجديد لم يكن خالياً من التحديات، فقد حمل في طياته بذور خلاف مع النموذج الثوري السائد آنذاك. كانت تلك البذور ستنمو لتصبح شجرة كبيرة تظلل مسيرة الصين الحديثة، وتشكل هوية خاصة للثورة الصينية تختلف عن غيرها من التجارب.
في تلك الأيام المضطربة، انجذب ماو إلى الماركسية كفلسفة تحمل وعوداً بالتحرر والعدالة، لكن عقله المتأمل لم يقبلها كما هي، فهو كان يرى أن لكل أرض سياقها الخاص، فبدأ في صياغة رؤية تزاوج بين المبادئ العالمية للفكر الماركسي والخصوصية العميقة للواقع الصيني. هذه الرؤية المتميزة وضعته على مسار تصادمي مع القادة السوفييت الذين كانوا ينظرون إلى أنفسهم كقادة وحيدين للمعسكر الاشتراكي.
يرى بعض المحللين أن ماو استخدم الماركسية كمنصة للتمرد المستمر والعمل الدؤوب، كأداة لتحريك الجماهير ودفعها نحو التغيير الجذري.
وفي فجر التاسع من سبتمبر عام 1927، تحولت الأفكار إلى فعل ملموس. قاد ماو تشكيل قوة عسكرية من الفلاحين البسطاء والعمال والجنود، معلناً بداية ما عُرف تاريخياً بانتفاضة “حصاد الخريف”. في تلك اللحظة التاريخية، أعلن ماو برؤية ثاقبة: “لا خلاص إلا بالثورة المسلحة، فهي السلاح الوحيد القادر على مواجهة القوى المضادة للثورة، وإزالة الجبال الثلاثة التي تكبل تقدم شعبنا، وبناء صين جديدة تليق بتاريخنا العظيم”.
كانت هذه الانتفاضة بمثابة الشرارة الأولى لمسار طويل من النضال، جمع بين الفكر الثوري والإرادة الشعبية، بين النظرية والممارسة، بين العالمية والهوية الصينية المتميزة.
الثورة الصينية الأولى (1925–1927)، بوصفها أول ثورة بروليتارية حقيقية في تاريخ الصين الحديث، انطلقت شرارتها من المصانع والموانئ والمدن الساحلية، حيث شكّلت الطبقة العاملة الطليعة التاريخية للحراك الثوري. وتحوّل العمّال، في فترة وجيزة، إلى قوةٍ منظّمة وفاعلة أنشأت النقابات، وشكّلت الميليشيات الشعبية التي تولّت السيطرة على الشوارع والمرافئ، وأقامت سلطة فعلية للطبقة العاملة في مناطق واسعة من البلاد. كان ذلك أول تجسيدٍ حقيقي ل البراكسيس الماركسي في الميدان الصيني: أي وحدة الفكر الثوري والعمل الجماعي، أو ما وصفه الزعيم ماو لاحقاً ب”المعرفة المولودة من الممارسة”.
في بدء المشهد كانت الحركة الشيوعية الصينية مضطرة إلى مواجهة هذا الامتحان التاريخي بعد خمس سنوات فقط من نشوئها، وكانت المضامين التي تبنّاها الشيوعيون في تلك الأيام تتسم بطابع قومي وطني مناهض للإمبريالية أكثر من كونها مشروعاً إنقلابياً اجتماعياً و طبقياً خالصاً، أجل كانوا ماركسيين بروح قومية وطنية جامحة المجرّدة الذي حملها الشباب العائد من الدراسة في فرنسا مطلع القرن العشرين
لم يكن الحزب الشيوعي في بدايته امتداداً للبلشفية الروسية، بل اتخذ مساره الصيني الخاص، وكانت علاقته المبكرة أقرب إلى التحالف مع الولايات المتحدة.
كانت جهود الحزب بقيادة “تشن توهسيو” (Chen Tu-hsiu) موجهة ضد الهيمنة الأجنبية وتدخّل القوى الاستعمارية في شؤون الصين، إذ كان ذلك امتحاناً مخيفاً، لذا يمم الحزب وجهه صوب موسكو ومبعوثي الكومنترن طلباً للمساعدة والإرشاد. في تلك الأيام، كان الشعور بالوحدة الشاملة للمصالح والانضباط الأممي قوياً، غير أنها أجهضت بسبب سياسات جوزيف ستالين وميخائيل بوخارين الخاطئة، التي رهنت الطبقة العاملة الصينية بقاطرة ما يسمى “البرجوازية الديمقراطية” تحت قيادة تشانغ كاي تشيك، وتم عملياً تذويب الحزب الشيوعي في حزب الكومينتانغ البرجوازي، حتى أن ستالين دعا تشانغ كاي تشيك ليصبح عضواً في اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية.
كهزيمة 1927، عندما نظم “البرجوازي الديمقراطي” تشانغ كاي تشيك مجزرة ضد الشيوعيين في مدينة شنغهاي، كان السحق الذي تعرضت له الطبقة العاملة الصينية محدداً لطبيعة الثورة الصينية التالية، إذ فر من تبقى من مناضلي الحزب الشيوعي إلى الأرياف و البوادي ليطلقوا حرب عصابات على أساس جيش الفلاحين، وقد غير هذا بشكلٍ جوهري من مسار الثورة، لذلك من الضروري فهم الظروف المادية الملموسة والممارسات الاجتماعية التي اكتشف من خلالها المعلمون الكبار للبروليتاريا – ماركس و إنجلز و لينين و ستالين و ماو – مبادئها الأساسية وصاغوها.
في خضم هذه التحديات، أدرك ماو أهمية الريف كساحة للنضال، فانطلق من هونان ليؤسس أولى القواعد الثورية، محركاً مسيرة تغيير اعتمدت على تحالف الفلاحين كقوة دافعة للثورة، في مشهد كان يكتب فصلاً جديداً من تاريخ الصين المعاصر.
بينما كانت أنواء الحرب الأهلية تعصف بالصين، شق ماو تسي تونغ ورفاقه طريقهم نحو جيانكسي عام 1928، حيث التحقت بهم قوات القائد العسكري شوته، لتبدأ فصلاً جديداً من فصول المقاومة.
مع حلول الربيع، أطلّ ماو بخطوة جريئة جعلت من حقول الأرز ساحات للثورة، حيث وزّع السلاح والأرض على أبناء القرى، محوّلاً اتحادات الفلاحين إلى نواة لحكم جديد. لم يكتفِ بتأسيس قاعدة حمراء واحدة، بل امتدّت رقعته الثورية مع انضمام جيش بنج تو هويه، وكأنّ شعلة من النار تنتشر في حقل قش.
لكن هذا المدّ الثوري لم يمرّ مرور الكرام، فقد استشعر تشيانغ كاي شك الخطر يزحف نحو عرشه، فحولّ جيانكسي إلى ساحة حرب، ضارباً عليها بحصار خمسي متتالٍ كأسنان المنشار. بين عامي 1930 و1934، أحكم تشيانغ طوقه حول القواعد الثورية، مطلقاً عواصف من الرصاص والإعدامات الجماعية، وكادت المقاومة أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.
في عام 1934، شنت قوات تشانغ كاي شيك هجوماً ضارياً على معقل الشيوعيين في جيانغشي، فكان أن بدأت واحدة من أعظم ملاحم الصمود في التاريخ. في تلك اللحظات المصيرية، لم يبقَ للثوار سوى حبل نجاة واحد: مسيرة شاقة عبر عشرة آلاف كيلومتر، حملوا فيها أحلام أمة على أكتاف منهكة، انطلقت المسيرة الكبرى كسرب من الطيور المهاجرة، تحلق من جيانغسي الجنوبية إلى يانان الشمالية في إقليم شانشي، تقطع خلالها ستة آلاف ميل من المعاناة والصمود، ومن بين ثمانين ألفاً انطلقوا في البداية، لم يصل إلى النهاية سوى عُشر ذلك الجيش، لكنهم حملوا معهم إرثاً من التضحية أصبح شعلة أمل للأجيال القادمة.
كانت كل خطوة في تلك المسيرة الطويلة صفحة جديدة في سفر المقاومة، وكل تضحية كانت بذرة لنهضة جديدة، في رحلة لم تكن مجرد تراجع عسكري، بل كانت رحلة بحث عن هوية وأمل في مستقبل أفضل.
تحولت يانان من بلدة نائية إلى معقل للثورة، حيث أعاد الشيوعيون تنظيم صفوفهم بين الكهوف والوديان. هنا، في هذه الأرض القاحلة، نما فكر جديد وتشكلت إرادة صلبة، وعلى مدى عقد كامل، برز ماو تسي تونغ من بين الصفوف، ليس كمجرد قائد عسكري، بل مفكراً وفيلسوفاً، محولاً الهزيمة إلى مدرسة، والتراجع إلى نقطة انطلاق جديدة.
في ظل صخور يانان الحمراء، نضجت الرؤية الثورية، وتشكل مصير أمة بأكملها. من رحم المعاناة، ولدت قيادة لا تنازع، ومن جمر الهزيمة، اشتعلت نيران النصر.

حرب التحرير الوطنية الصين في مواجهة الغزو الياباني:
بين ركام انتصارها الساحق على جارتها العملاقة، وجدت اليابان نفسها على أعتاب فجر جديد. لم تكن اتفاقية شيمونوسيكي مجرد وثيقة سلام عادية، بل كانت البوابة التي انفتحت على عالم من الطموحات المتدفقة. اعتراف الصين باستقلال كوريا الاسمي أخفى وراءه حقيقة ناعمة لكنها قاسية: الحماية اليابانية التي ستتحول قريباً إلى قبضة حديدية.
في قاعات القرار في طوكيو، بدأت تتبلور رؤية أكثر اتساعاً، حلْم إمبراطوري يطمح للسيطرة على مصير الشرق الأقصى بأسره، لكن هذا الحلم اصطدم بجدار الواقع الجيوسياسي، حيث وقفت ثلاث قوى عظمى كحراس للتوازن الإقليمي، روسيا القيصرية وألمانيا وفرنسا شكلوا تحالفاً غير متوقع، أجبر الشمس المشرقة على التراجع عن بعض غنائمها.
كان الثمن باهظاً: التخلي عن ميناء آرثر الاستراتيجي وجزيرة لياتونج في منشوريا، تلك المناطق التي كانت قد انتزعتها من الصين. لم تكن هذه سوى البداية، فالتنازلات امتدت لتشمل جزر فرموزا (تايوان) وميناء دايرن، في مقايضة مريرة استبدلت الأرض بالمال، حيث قبلت طوكيو تعويضاً مالياً بدلاً من الامتداد الجغرافي.
بينما كانت الإمبراطورية اليابانية تلملم أجنحتها بعد انتصاراتها العسكرية المبهرة، اتجهت أنظارها نحو القارة الآسيوية كمسرح طموح لتمددها. لم تكن جزيرة فرمزا (تايوان) سوى البداية، حيث سعت طوكيو بجسارة إلى انتزاع مواقع استراتيجية من جارتها العملاقة الصين. لكن شرارة الطموح هذه أوقدت نار منافسة كامنة مع الدب الروسي، الذي كان بدوره يحدق بشهوة نحو كوريا.
كانت اتفاقية 1896 بين البلدين بمثابة هدنة هشة، رسمت بخطوط فضية حدوداً للتعايش في الساحة الكورية. تبادل الدبلوماسيون الابتسامات وتبادل التجار البضائع، لكن تحت السطح كانت نيران المنافسة تشتعل. فتحت الوثيقة الباب للتدخل المشترك، لكن اليابان رأت فيها تحدياً وجودياً، فقررت مواجهة الوجود الروسي في شبه الجزيرة بنفس القوة والحضور.
جاءت معاهدة 1898 محاولة يائسة لإخماد نار المنافسة، حيث اتفق العملاقان على رسم دائرة حمراء حول استقلال كوريا. لكن الورقة الرسمية لم تكن سوى حبر على ورق، فسرعان ما نكث الدب الروسي بوعوده، معيداً الكرة إلى ملعب المواجهة.
لم تيأس اليابان، فعرضت حلاً وسطاً بتقسيم الكعكة الكورية، لكن رفض روسيا كان الصفعة التي أيقظت طوكيو من حلم التسوية السلمية. عند هذه النقطة، لم يعد أمام الشمس المشرقة إلا خيار واحد: المواجهة المباشرة لتحطيم القيود التي تكبل طموحاتها التوسعية.
هكذا تحولت الدبلوماسية إلى مسرح لصراع إرادات، حيث كانت كل اتفاقية تحمل في طياتها بذور الأزمة التالية، في رقعة شطرنج جيوسياسية مصيرها أن تُحل بالدم لا بالكلمات.
بينما كان ظل الحرب الصينية-اليابانية الأولى (1894-1895) لا يزال مسيطراً على الذاكرة الجمعية، عادت المدافع لتُسمع من جديد في الفترة ما بين 1937 و1945. لم تكن هذه الجولة الثانية من المواجهة مجرد صراع عسكري تقليدي، بل كانت اختباراً لمصير أمة بأكملها.
وفي خضم العواصف الداخلية، جاءت العاصفة الخارجية من الشرق، حيث اجتاحت اليابان منشوريا عام 1931، منصبةً الإمبراطور السابق بويي على عرش دولة “مانشوكو” الوهمية. كانت هذه الضربة قد كشفت هشاشة الوحدة الحديثة وعمق التدخل الأجنبي. لم يكد الجرح يلتئم حتى جاء الامتحان الأكبر، ففي عام 1937 اخترقت القوات اليابانية الحدود فاهتزت أوتار الوطن، عندها تناسى الخصوم أمسهم الأليم وتكاتفت أياديهم من جديد، متحدين تحت راية المقاومة الوطنية. في ظل هذا التحالف التاريخي، نما جيش التحرير الشعبي حتى بلغ قوامه مليون مقاتل، بينما امتدت مناطق النفوذ الثوري لتضم مائة مليون مواطن، محققة حلم ماو تسي تونغ في بناء قواعد ثورية راسخة.
حيث بدأ الوعي الجمعي يستيقظ على معنى الانتماء إلى أمة واحدة، لم تكن تلك مجرد معارك عسكرية، بل كانت مخاضاً لولادة وعي حديث، تجلى في حملات التعبئة الواسعة التي لم تشهدها البلاد من قبل، وأصبحت الدولة حاضرةً بقوة في حياة الأفراد كما لم تكن من قبل.
في ظل صرخة المدافع، اكتسبت مفاهيم الأمة والهوية أبعاداً وجودية، لم تعد مجرد أفكار مجردة، بل أصبحت مسألة حياة أو موت. هذه التحولات العميقة أعادت صياغة العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، ففي المنعطف التاريخي الحاسم، تطلبت الدولة من الشعب أن يقدم أكثر مما قدّم، وبات الشعب ينتظر من دولته ما لم ينتظره من قبل.
في معاقل المقاومة، تبلورت رؤية ثورية متكاملة، لم تكن الإصلاحات التدرجية هي الخيار، بل كانت الثورة الشاملة هي المنهج الذي سار عليه الطريق. من معاقل النضال، انبثقت فلسفة جديدة أعادت تعريف العلاقة بين الوطن وأبنائه، وشكلت الإطار الذي ستسير عليه الصين الجديدة.
كانت الصين تدخل هذه المعمعة وهي تحمل على كاهلها إرثاً ثقيلاً: أسطورة “عدم الجاهزية الحربية” التي ظلت تُردد كشبح يطارد العقل العسكري الصيني. لكن التحديات لم تكن عسكرية فحسب، بل كانت أعمق من ذلك، فالجسد الاجتماعي كان يعاني من شرخٍ عميق، والاقتصاد الوطني كان يئن تحت وطأة الفقر، وكأن الأمة كانت تسير على حبل مشدود فوق هاوية سحيقة.
في خضم هذه العاصفة، كانت خريطة القوى تشبه رقعة الشطرنج المعقدة، فالحكومة التي يقودها شان كاي شيك، رغم تمسكها بالرمزية القومية، لم تكن سيطرتها تمتد إلا كبقعة زيت محدودة في وسط البلاد وجنوب غربها. بينما في الشمال الغربي، كانت قوى أخرى تنسج خيوط مصيرها الخاص – حيث كان الشيوعيون يبنون عالمهم المختلف في معاقلهم المحصنة.
كانت هذه الفسيفساء من القوى المتعددة تطرح سؤالاً مصيرياً: كيف لأمة مقسمة أن تواجه غزواً خارجياً؟ لقد كانت المعركة مع اليابان اختباراً ليس فقط للقوة العسكرية، بل لإرادة الأمة في تجاوز انقساماتها ومواجهة قدرها المشترك.
شكلت الانخراطات العسكرية المبكرة للحزب الشيوعي الصيني خلال فترة الحرب محطة حاسمة في تعزيز شرعيته، فبفضل تكتيكات القتال المباشر التي انتهجها، تمكن من تحقيق ضربات موجعة للقوات اليابانية في مناطق شانشي وأطراف الشمال.
غير أن القيادة الشيوعية، وعلى رأسها ماو تسي تونغ، ظلت متوجسة من تحركات شيانغ كاي شيك وحزب الكومينتانغ، كما كانت الشكوك متبادلة بين الطرفين. ما إن حصل الشيوعيون على اعتراف قانوني ووعود بالشرعية، حتى تحولت استراتيجيتهم من المواجهة المباشرة إلى حرب العصابات، مستغلين التضاريس الجبلية لحفظ قوتهم وبناء ترسانة عسكرية متنامية.
وقد ارتبط هذا التحول بحملة توسعية واسعة لاستقطاب الأعضاء، ما أسفر عن قفزة نوعية في عدد المنتمين للحزب، من نحو ثلاثين ألفاً مع بداية الحرب، إلى ما يقارب ثمانمائة ألف بحلول عام 1940، بالإضافة إلى تشكيل جيش نظامي تجاوز تعداده نصف مليون جندي، لكن هذه الزيادة الهائلة كانت تحمل في طياتها رسالة مصيرية: لم يعد بالإمكان مواصلة السير على الدرب القديم.
كان ماو تسي تونغ، بعينيه الثاقبتين، أول من قرأ هذه الرسالة بعد أن أخفقت انتفاضات العمال في شانغهاي وكانتون. فاستخلص من ركام الهزيمة جوهرين ثمينين:
الأول: كنز كان ينام تحت أقنعة الفقر والجهل – الفلاحون، ذلك المحراث الثوري الذي سيقلب تربة الصين العتيقة.
الثاني: أن الكفاح المسلح لم يعد خياراً، بل أصبح هو اللغة الوحيدة التي تفهمها قوى الاستعمار والظلام.
هذان الاستنتاجان لم يكونا مجرد تغيير تكتيكي، بل كانا زلزالاً هز قيود التفكير التقليدي، محرراً رؤية الحزب من سجن الشعارات الجوفاء والأطر المتجمدة.
مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وارتداد أمواج الاحتلال الياباني، وجد الشيوعيون أنفسهم يمسكون بزمام مناطق تتنفس فيها أكثر من مئة مليون صيني. وبحلول عام 1946، اشتعلت نيران الحرب الأهلية من جديد، لكن هذه المرة كانت المعادلة مختلفة. خلال أربعة أعوام فقط، حسمت المعركة المصيرية لصالح قوى الشعب، لتنتهي في عام 1949 بإعلان ميلاد جمهورية الصين الشعبية، وهكذا أصبح ماو تسي تونغ على قمة الهرم السياسي والعسكري، حاملاً ألقاب: الأمين العام للحزب، رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العسكرية التي تقود جيش التحرير الشعبي، مبتدئاً فصلاً جديداً من فصول بناء الصين الحديثة.
بعد أن هدأت غبار المعارك، شرع ماو في قيادة حملة طموحة لإحياء القطاعين الزراعي والصناعي. نجحت بعض خططه وفشلت أخرى تحت وطأة التحديات الديموغرافية، مما دفعه لاحقاً إلى تبني سياسات سكانية صارمة. ورغم كل التحديات، ظلت الصين تسير على طريق النمو بمعدلات تفوق نظراءها من الدول المشابهة.
وفي خضم هذه التحولات، بدأت الشقوق تظهر في جدار التحالف الصيني-السوفيتي، بينما كانت الصين تخطو بثبات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال العسكري، مستفيدة من التكنولوجيا السوفيتية في تطوير ترسانتها الخاصة، بما فيها الأسلحة النووية.
تمكن ماو من توحيد الصين بسرعة أذهلت المراقبين، ممسكاً بخيوط السلطة في يد من حديد. وفي خطوة استراتيجية، أقام تحالفاً متيناً مع العملاق السوفيتي، الذي أغدق على الصين بالدعم العسكري خاصة خلال سنوات الحرب الكورية (1950-1953)، حيث وقف الجيش الصيني إلى جانب كوريا الشمالية في مواجهة العاصفة.

انبثاق الشرق …. ميلاد ثائر
في 26 ديسمبر 1893 وادي شاوشان، الذي يقع في منطقة هونان في قلب الصين ابناً لعائلة تمتهن الزراعة منذ خمس قرون ولد ماو والده يي شانج مزارع من صغار الملاكيين أبوه العصامي الذي أصبح خلال شبابه تاجر للحبوب على عكس معظم سكان قريته يعرف القراءة والكتابة وكان ماو الثالث بين أخوته ولكنه الأول الذي بقى على قيد الحياة. أما بالنسبة لاسمه فيشير عدة مؤرخين إلى أنه له معنى محددا، حيث حصل ماو الطفل على اسمه من مقطعين صوتيين هو «تسي» و«تونغ» وتعني مفردة تسي “الشروق”، يشير اسم تونغ إلى “الشرق”، وبذلك يكون الاسم الكامل له معناه انبثاق الشرق وألقه. وعندما وُلد له أخوان آخران في أعوام 1896 و1905، سمتهما العائلة أسماء تسي مين وتسي تان. فاسم تسي مين يعني “الشعب” أو “الناس”، بينما قد يشير اسم تسي تان إلى الإقليم الذي كانا يعيشان فيه، وهو مايدلل و يعكس ارتباط العائلة الريفية بأرضها وجذورها وانتمائها الوطني منذ صغره، كانت حياته مليئة بتجارب الريف الصيني بما تتخله من عمل شاق يغلب على حياة الفلاحين، المؤطرة بمظاهر الفقر والمعاناة في ظل إقطاع متخلف واستغلالي تارك فقراء الفلاحين لفتك المجاعات والفيضانات التي كانوا يواجهونها بين الحين والآخر.
طفولته أعطته وعياً مبكراً بواقع التفاوت الاجتماعي وانعدام المساواة و وضعف تأثير السلطات المركزية الفاسدة بإهمالها الريف وقاطنيه، كانت القراءة التي أدمنها حياته كلها هي التي ستدفعه في سن 16 وبعد أن أصبح أرملاً بعد عام واحد من زواج قصير للهجرة إلى المدينة حيث أتم دراسته في عدة ثانويات تابعة لإرساليات أجنبية مثل ثانوية «إيسترن هيل» في عاصمة إقليم هونان مدينة شانجشا وساعده أخواله في تحمل أقساطها.
ماو الذي عرف “بتمرده” على التقاليد وأساليب التعليم الكلاسيكية المحافظة أطلع في تلك المدارس على مبادئ العلوم الحديثة وقواعد اللغات الأجنبية وقرأ أعمال روسو … وسيرة قادة كإبراهام لنكولن وبونبارت لينتقل إلى العاصمة عام 1911 ويترك مهنة الزراعة ليدخل مدرسة عليا، ليتخرج بعد سبعة أعوام من معهد للمعلمين 1918، ليقرر بعدها الذهاب للدراسة في الجامعة لكن لم يكن حينها لديه ما يكفي من المال، مما أجبره على العمل كأمين مكتبة الجامعة، عاد بعدها إلى نشانجشا ليمتهن التعليم. ماو الشاب كان يرى أن واقع الصين وشكل الصراع بين الطبقات هو ريفي وليس بالمدني وأن أي نشاط ثوري يحصر نفسه في مراكز المدن، بعيداً عن الريف المنسي سيحكم على نفسه بالفشل وهذا ما سيحصل لاحقاً خلال الثورة الصينية الأولى، فرؤية ماو للطبقة الفلاحية كعامود فقري نابع من واقعيته هذه الصفة التي ستلازمه في كل مراحل حياته حتى في عز التجديد الثوري أثناء حقبة الثورة الثقافية .
الفلاحون، الذين شكلوا نحو 80٪ من سكان البلاد حينها، لم يكونوا مجرد فئة اجتماعية منهكة تجاهلها كان يعني تجاهل الأغلبية الساحقة للسكان، وبالتالي إقصاء القوة الشعبية الحقيقية التي يمكن أن تحتضن الحراك الثوري، بل كانوا القوة الكامنة والحامل البروليتاري الذي جعل من حاضر الصين الاستثنائي ممكناً الشاب المثقف الذي كان يعمل كأمين مكتبة في جامعة بكين قبل يصبح ثورياً محترفاً، كان صاحب فكر ومثقفاً من العيار الثقيل، مما مكنه من خطف وعي الجماهير وعقولهم وقيادتهم فيما بعد أن كانت فلاحية ماو هي الخلاف الجوهري مع الماركسية السوفياتية ونهجها وبالأخص مع ورثة ستالين وحتى مع بقاياها المحنطة ليومنا هذا الذين يصرون بما فيهم من تنويعات يسارية شيوعية بالترديد السطحي بأن انحرافات الماوية هي التي أنتجت ومهدت الفكاك الأخير للصين كبلد إشتراكي إلى قطب رأسمالي البيروقراطية السوفياتية ككل، فروسيا كانت لاتنظر بارتياح كبير للصين وزعيمها رغم أنها أسهمت في دعم الصين بعد انتصار الثورة الماوية لكنها كانت ترى بالشيوعية الصينية كمنافس أيديولوجي أكثر منه تابع أيديولوجي كواقع جمهوريات حلف وارسو وذلك بحكم أقدميتها الثورية هذا النهج ولكون قيادات السوفييت منذ تفرد جوزيف ستالين بالسلطة كانت تمارس وصاية نظرية شبه بابوية على كل مفاصل اليسار العالمي والحركات (الكومينترن الأممية الثالثة والحركة الشيوعية العالمية) ومع إشتداد الخلاف الدبلوماسي خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين بين النظامين الشيوعيين حول دعم حركات التحرر في العالم الثالث وميل السوفييت لسياسة خفض بؤر التوتر بعد أزمة الصواريخ الكوبية، دفع هذا الخلاف كثيراً من المثقفين اليساريين التابعين للكرملين إلى نشر كتابات مشحونة بتهم “التحريفية” ضد الصين وقيادتها وهي تهمة في الأدبيات السوفيتية مرادفة للهرطقة في الكهنوت المسيحي صفة التحريفية ذاتها التي قتلت قادة الثورة البلشفية كليون تروتسكي وكامنييف وميخائيل بوخارين وغيرهم كثر وكل من رفض الطاعة المطلقة للشيوعية بنسختها السوفياتية وهي مفارقة بينية الطابع إذا يكفي النظر إلى النهاية المؤسفة التي قادت الشيوعية الروسية لفواتها منهية أول دولة عمالية في التاريخ المعاصر سنة 1991 وبين واقع الشيوعية الصينية اليوم .
في تلك المرحلة التاريخية الحاسمة، لم يكن تقارب الصين مع الغرب مجرد مناورة دبلوماسية عابرة، بل كان انعكاساً لشرخ عميق تشقّق في جدار التحالف الشيوعي. فقد بدأت بكين ترى في حليفها السوفييتي السابق ظلاً يتحول شيئاً فشيئاً إلى قوة منحرفة، تهدد مصالحها وتنازعها على حدودها.
كان عام 1969 بمثابة الصدمة التي أيقظت القيادة الصينية على واقع مرير: فالتوترات العسكرية على طول الحدود المشتركة، وامتداد تأثيرها إلى مناطق حيوية مثل شينجيانغ، كشفت عن هشاشة الموقف الاستراتيجي للصين. في ذلك الحين، وجدت البلاد نفسها محاصرة بالعزلة السياسية، ومحاصرة باقتصاد يعاني من الترهل، بينما كانت جاراتها الآسيوية تنطلق في سباق التطور الرأسمالي بخطى ثابتة.
وسط هذه الظروف، أدركت القيادة الصينية أن البقاء في هذا المسار لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور. كان لا بد من كسر الحلقة المفرغة، وكانت “المساومة” التاريخية هي المفتاح الذي فتح الباب أمام مرحلة جديدة، غيرت وجه المنطقة والعالم.

التأسيس والبناء السنوات الأولى لحكم ماو تسي تونغ:
هل كان بمقدور الصين أن تسير على الدرب الذي سلكته الأمم الأخرى، فتستعير نموذج التحديث الغربي الجاهز وتنقشه على واقعها بلا وعي؟ لقد أجابت التجربة الأولى بأبلغ بيان، حين حاولت قوى الاستعمار القديم فرض صيغة الرأسمالية على جسد البلاد المتعب، فما كانت إلا محاولة لزرع شجرة في تربة مالحة. كلما نما الجذر، ازداد التربة انغماساً في مستنقع الهجينة: نصفها يرزح تحت وطأة التبعية، ونصفها الآخر يتشبث ببقايا عصور الإقطاع.
لكن القصة لم تنته عند ذلك المأزق، فمع انبلاج فجر الجمهورية الجديدة عام 1949، انفتح باب تجربة مختلفة. حمل المشروع الاشتراكي بذرة تحديث من نوع خاص، نبتت في تربة الوطن وارتويت بعرق أبنائه. لم تكن الرحلة مفروشة بالورود، بل شقت طريقها عبر تضاريس الصعاب، تتعثر أحياناً وتنهض دائماً حتى إذا اكتملت دورتها، أثمرت شجرة وارفة الظلال، تحمل في ثمارها برهاناً على حيوية مسيرة لا تكرر الآخر، بل تبتكر ذاتها بوجدان خلاق.
في أكتوبر ١٩٤٩، وقف ماو ليعلن قيام جمهورية الصين الشعبية، محققاً حلماً لطالما راود الملايين. وبينما تختلف التقييمات التاريخية لفترة الثورة الثقافية، يبقى إنجازه الأكبر هو تحويل الصينيين من رعايا إمبراطورية إلى مواطنين في دولة واحدة، منقادة بروح وطنية تجاوزت كل الانتماءات الضيقة.
هكذا تبقى شخصية ماو تسي تونغ، برغم كل الجدل، حاضرة في الضمير الجمعي للصينيين – ربان السفينة التي قادت الأمة عبر أعتى العواصف نحو بر الأمان.
تمتد الفترة ما بين عامي 1949 و1978 لتشكل مرحلة محورية في التاريخ الحديث للصين، إذ شهدت البلاد خلالها تحولات جذرية على المستويين الداخلي والخارجي تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني بزعامة ماو تسي تونغ، فبعد انتصار الحزب في الحرب الأهلية وإعلان قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949، انطلقت جهود مكثفة لترسيخ سلطة الدولة الجديدة وإعادة تشكيل المجتمع وفق المبادئ الاشتراكية.
ركزت القيادة الماوية في السنوات الأولى على تثبيت الثورة في الحكم بعدة سياسات تمثلت في إصلاح الأراضي وتوزيعها على الفلاحين، وتأميم الصناعات والمؤسسات الاقتصادية، وقد اتسمت هذه المرحلة بنزعة راديكالية هدفت إلى تحقيق قطيعة تامة مع النظام القديم وبناء دولة اشتراكية مركزية…. يخبرنا المتخصص الاقتصادي في بنك سنغافورة للتنمية البروفيسور كريس ليونغ أنه “عندما تسلم الحزب الشيوعي مقاليد الحكم في الصين كانت البلاد فقيرة جداً، ولم يكن لديها أي شركاء تجاريين ولا علاقات دبلوماسية واسعة، لكن كانت تعتمد كلياً على الاكتفاء الذاتي.“
لطالما شكّلت المسألة الزراعية المعضلة التاريخية الكبرى التي كبّلت المجتمع الصيني منذ نشوء الحضارة الصينية منذ الألف الثانية قبل الميلاد، فقد عبّر المؤرخ البريطاني إريك هوبسباوم عن هذه الإشكالية بدقّة حين تساءل: “كيف يمكن إطعام خُمس سكان العالم بما لا يتجاوز ستة في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة على سطح الكوكب؟” هذه المفارقة البنيوية، إلى جانب الكثافة السكانية الهائلة، جعلت الصين على الدوام في حالة من الخطر الديموغرافي والاقتصادي المزمن، إذ كان أي انخفاض طفيف في الإنتاج الزراعي — حتى بنسبة عُشر — كفيلاً بإدخال البلاد في أزمة غذائية خطيرة، بينما كانت سنوات الجفاف أو القحط تقود إلى موجات مجاعة مدمّرة تودي بحياة الملايين، وهي دورات مأساوية استمرت حتى منتصف القرن العشرين.
غير أن التحول التاريخي الذي دشّنه ماو تسي تونغ واستكمله خلفاؤه لاحقاً تمثّل، وفق تحليل سمير أمين مرة أخرى، في أن الصين أصبحت واحدة من ثلاث دول فقط من بلدان الجنوب العالمي — إلى جانب كوريا الجنوبية وتايوان — تمكنت خلال القرن العشرين من بناء ما أسماه أمين “نظاماً إنتاجياً سيادياً”. ويقصد بهذا النظام منظومة اقتصادية متكاملة تمتلك فيها الدولة قاعدتها الصناعية والتكنولوجية الذاتية بالمطلق، بما يمكّنها من تطوير التكنولوجيا والتقانة التي تحتاجها لمواصلة مشروعها التنموي بشكل مستقلّ كلياٌ، دون الوقوع في “عنق الزجاجة التكنولوجي” الذي يقيّد معظم الدول النامية في هذا المجال التنموي شديد الخصوصية.
وقد جعل هذا الإنجاز الصين استثناءً استراتيجياً في العالم النامي، إذ نجحت في تحقيق الاكتفاء الصناعي والتكنولوجي إلى شوطٍ بعيد، ما منحها القدرة على التحرك بثقة داخل النظام الدولي، بوصفها قوة إنتاجية سيادية لا تابعة، قادرة على صياغة نموذجها التنموي الخاص بمعزل عن إملاءات التبعية لمراكز الرأسمالية الكبرى وهذا ما هو جوهري في فرادة نموذجها.
وعلى الرغم من انشغال الصين الماوية بتثبيت أركانها الداخلية وتمكين سلطة الحزب، فإنها لم تكن بمعزل عن التطورات الدولية التي اندلعت بعد نهاية الحرب الكونية الثانية، فقد جاء انخراط الصين في الحرب الكورية (1950–1953) ليكشف عن استعدادها لتولي دور فاعل في دعم الحركات الثورية العالمية، وتعزيز موقعها كحليف عقائدي رئيسي للاتحاد السوفيتي ((خلال المرحلة الستالينية حتى عام 1953)) في مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة وحلفائها.
في خريف عام 1950، انطلقت موجات بشرية من المتطوعين الصينيين عبر نهر يالو متجهة شطر الأراضي الكورية، في مواجهة تاريخية ضد القوات الأمريكية التي قادها الجنرال ماك آرثر. كانت المعارك سجالاً، لكن المفاجأة كانت حين انكسرت أسطورة الجيش الأمريكي الذي ظلّ حتى تلك اللحظة يحصد الانتصارات، ليجد نفسه مرغماً على الانكفاء نحو جنوب شبه الجزيرة.
مثّل ذلك الحدث أول اختبار حقيقي لقدرة الصين الجديدة على ممارسة نفوذها الجيوسياسي بفاعلية ((العسكري والسياسي خارج حدودها))، وأسّس لمرحلة من التوجه الثوري الحازم والمفرط في سياستها الإقليمية والدولية.
مع أول أنفاس الربيع التالي، توجهت أنظار بكين نحو سقف العالم، حيث انتشرت قواتها في مرتفعات التبت الشاهقة. هناك، حيث يصافح السحاب قمم الجبال، شهدت المنطقة مواجهات دامية مع المقاومين التبتيين، كتبت فصلاً جديداً في سجلات الصراعات الإقليمية.
لم تكن جبال الهيمالايا حاجزاً كافياً لوقف المد الصيني عام 1962، حين اخترقت وحدات عسكرية صينية الحدود الهندية في تحرك مفاجئ، ففي مسرح الاستراتيجيات العسكرية، أبدعت الصين لوحة فريدة أطلق عليها الخبير العسكري شيلفورد بيدويل تسمية “حرب التلقين”. تجسدت هذه الفلسفة بوضوح في ذلك اللقاء العسكري القصير عام 1962 بين العملاقين الآسيويين، الهند والصين.
كانت المعركة أشبه بعملية جراحية دقيقة تهدف إلى نقل رسالة سياسية حادة إلى القيادة الهندية. فقد رأت الصين أن دعم الهند للدلاي لاما والمقاومة التبتية يستحق ردا لا ينسى، فكان أن حيكت الخيوط بعناية، حيث استُخدم النزاع الحدودي المزمن كمدخل لتنفيذ الضربة المحسوبة.
جاءت الضربة كبرق في سماء صافية، فاجأت الزعيم الهندي نهرو ومحيطه. لم تكن معركة عسكرية تقليدية، بل كانت عرضاً للقدرة على حسم المواقف بإرادة حديدية، حيث سقطت القوات الهندية كأوراق الخريف أمام الريح الصينية، لتشهد على هزيمة استثنائية في ذاكرة الأمم.
لكن الحملة لم تطل، فبعد أسابيع قليلة، تراجعت القوات محتفظة بمساحات محدودة على الخطوط الحدودية، حيث قررت الصين الانسحاب طواعية من الأراضي التي سيطرت عليها. لم يكن انسحابا عاديا، بل كان بيانا سياسيا صامتا يعلو فوق ضجيج المدافع. لقد أرادت بكين أن تقول للعالم: إننا أقوياء بما يكفي لتحقيق النصر، وحكماء بما يكفي لاختيار توقيت الرحيل. كانت المسرحية كاملة الأركان، حيث تحول الانسحاب إلى وسيلة لإبراز عجز الخصم أكثر مما كانت الهزيمة نفسها.
في خريف عام 1955، كان العالم منقسماً على ذاته بين قطبين متعارضين، تتصاعد بينهما نذر مواجهة غير معلنة. وفي قلب العاصمة بكين، تجمّع قادة الجيش حول ماو تسي تونغ الذي أطلق كلماته المفعمة بالإصرار: “علينا ان نمتلك القنبلة الذرية حتى لا يعاملنا أحد كدولة ضعيفة”. كانت تلك اللحظة شرارة انطلاق المغامرة النووية الصينية، رغم أن البلاد كانت تتلظى بجروح الحرب الأهلية وتئن تحت وطأة الفقر.
آنذاك، كانت واشنطن تمتلك ترسانة نووية مخيفة، فيما كانت موسكو تلهث في سباق التسلح. ولمواجهة هذا الواقع، اتجهت الصين نحو حليفها الطبيعي، الاتحاد السوفيتي، الذي مدّ لها يد المساعدة بتقنيات المفاعلات النووية ومعدات إنتاج البلوتونيوم. لكن هذا التحالف لم يصمد طويلاً أمام عواصف الخلافات الفكرية، حيث قام خروتشوف عام 1959 بقطع أواصر التعاون النووي فجأة، مخلِّفاً البرنامج الصيني في موقف حرج وسط طريق شاق.
رغم فقدان الدعم التقني السوفيتي، لم تنكسر إرادة الصين العلمية، ففي عام 1964 انفجرت أولى الشحنات النووية الصينية في صحراء شينجيانغ المقفرة، لتتبعها بعد فترة وجيزة قنبلة هيدروجينية، محققةً بذلك تقدماً تكنولوجياً فاق توقعات القوى العظمى في واشنطن وموسكو.
مع مطلع عقد السبعينيات، وبينما كانت أنفاس الحرب الباردة تتجمد في أجواء العالم، شهدت بكين زيارة تاريخية كسرت جليد العزلة الطويل.. زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1972 التي مثلت منعطفاً في المسار السياسي الصيني. في ظل هذا التحول الجيوسياسي، شرعت القيادة الصينية في إعادة تشكيل برنامجها النووي وفق رؤية جديدة، حيث انتقلت بؤرة السيطرة من القيادات العسكرية المباشرة إلى القلب النابض للقرار السياسي الأعلى، ليصبح البرنامج أداة سياسية استراتيجية محكمة.

الصين وروسيا في ظل حكم ماو:
وفي خضم هذه التحركات، كانت الصين تشهد قطيعة مع حليفها التقليدي موسكو، بعد أن فضّل الكرملين سياسة التعايش السلمي مع الغرب. لم يتردد ماو في مهاجمة هذا المنحى، معلناً إيمانه الراسخ بفكر لينين الماركسي الداعي إلى مجابهة النظام الرأسمالي.
في منعطف تاريخي حاسم، تخلى ماو تسي تونغ عام 1959 عن موقعه الرسمي كرأس للدولة، لكن خيوط السلطة ظلت ممسوكة بقبضة حديدية بين يديه. من خلف الكواليس، ظل هذا الرجل يقود دفة الحزب والدولة بعين لا تغفل، بينما كانت العاصفة تهب من الشمال.
كان الخلاف مع العملاق السوفيتي يشتد كعاصفة شتوية، حيث تنازع الطرفان على قيادة العالم الشيوعي. ومع أن معظم الأنظمة الاشتراكية وقفت إلى جانب موسكو، إلا أن ثوار العالم الثالث – أولئك المناضلون في ظلال الاستعمار – وجدوا في بيجينغ شمساً تشرق على آمالهم.
رأى ماو نفسه حامياً للعقيدة الماركسية الأصيلة، سيفاً مصلتاً في وجه التحريفية. بينما كانت موجة مناهضة الستالينية تجتاح الكرملين، أطلق الزعيم الصيني صيحته المدوية: “على دول العالم الفقيرة أن تثور ضد الدول الغنية!” واتهم السوفييت بالتراخي في مواجهة الوحش الرأسمالي المتوحش الذي تمثله أمريكا.
وهكذا، يمكن القول إن هذه الحقبة أرست الأسس الأيديولوجية والسياسية للدولة الصينية الحديثة عموماً، لكنها في الوقت نفسه أظهرت التحديات العميقة والبنيوية التي واجهت البلاد في سعيها لتحقيق التوازن بين الطموح الثوري ومتطلبات التنمية والاستقرار الداخلي, فإن ماوتسي تونغ قد علم بما يشبه اليقين أن الشعب المتسلح بالنظرية الثورية، وليس الأسلحة فقط، هو العامل المحدِّد في الحرب التي تخوضها طبقة ضد طبقة أخرى في أي مجتمع وأن أي تطور نوعي في تاريخ الأمم هو نتاج جمعي للشعب، وبذلك فقد لخص كل التجربة الثورية الصينية في مبدأ أساسي هو أن الجماهير الشعبية هي صانعة التاريخ وقوة التغيير الاجتماعي وأن النقد الذاتي هو عنصر ثوري يجب أن تتحلى به القيادة الثورية ويكون نهجها العلمي لأن الثورة التي لا تركب أمواج التغيير تهلك أبناءها في دوغما ومستنقع الجمود والتصلب العقائدي وتدفن في فصول ميثاقها وتصدأ في مقابر التاريخ، وعليه فإن الماوية كنظرية أطلقت مفاهيم التحرر الطبقي وعلاقته التوأمية بالتحرر من الاستعمار((كوريا الشمالية ..فيتنام ..الجزائر)) ما زالت تفرض إجاباتها على ساحة النضال ضد التبعية والهيمنة بما فيه من راهنية. وهذا من المداخل الأساسية لفهم النموذج الاستثنائي للصين المعاصرة وعليه فإن ورثة الزعيم ماو لبلوغ موقع دولي يؤهل البلاد لتقديم نموذج جديد في إدارة العلاقات الدولية وإدامة مشاريع التحديث والنهوض على المستوى الداخلي، كان لزاماً عليهم تحرير الخطاب العام من مفرداته الماوية المفرطة في ثوريتها مع ضرورة الإقرار الدائم بقدر معقول من التأثير غير المحدود للماوية كحامل تاريخي في إعداد أرضية النهج الجديد لقادة البلاد- تحاول القيادات المتعاقبة على رئاسة الحزب الجديدة منذ التحول الذي أرساه المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي الصيني، تبني برنامج التحديثات الأربعة وطرح نظرية الصعود السلمي عبر مساهمات دينغ هيساو بينغ وجان بيجيان وغيرهم أن تقدم نمطاً يثري النزوع الكونفوشي الإنساني الرزين ويتحرر إلى الأبد من عقلية “سور الصين ” التي حكمت على عقلية أباطرة البلاد قديماً، تُعدّ سنوات إبان نهاية عقد الستّينيات وحتى نهاية السبعينيات في الصين من أهم الفصول الدراماتيكية في تاريخ الحزب الشيوعي الصيني والدولة الصينية المعاصرة. إذ شهدت هذه الفترة تحوّلات داخلية وإستقطاباً حاداً عنفي الطابع لم يكن مجرد صراع شخصي على السلطة والنفوذ بقدر ما كان صراع أنماط التفكير داخل الحزب ورؤيته لشكل الدولة وطريقة عملها، في جوهر الصراع الذي سبق اندلاع الثورة الثقافية، لم يكن الخلاف يدور حول المبادئ الاشتراكية أو توجهات الدولة الاقتصادية ودور الحزب بقدر ما كان يتمحور حول تقاسم السلطة داخل الطبقة الحاكمة القيادية نفسها. فقد كان السؤال الجوهري والملحّ يتمثل في ما إذا كان ماو تسي تونغ سيظل الزعيم الأوحد المطلق لمؤسسات الحزب والدولة، أم سيقتصر دوره على كونه عضواً ضمن القيادة العليا يخضع لمنطق العمل الجماعي كأي رفيق قيادي في حزب شيوعي حاكم. منذ فشل مشروع “القفزة الكبرى إلى الأمام” (1958–1961)، حاول خصوم ماو داخل الحزب تحجيم نفوذه السياسي عبر إبعاده عن إدارة الشؤون اليومية البيروقراطية للدولة وتحويله تدريجياً إلى رمز ثوري فحسب، منزوع السلطة التنفيذية الفعلية. غير أن هذه الاستراتيجية جاءت بنتائج عكسية؛ إذ أسهمت في تعزيز مكانة ماو الرمزية والأخلاقية في أذهان الجماهير، وكرّسته كقائد الثورة المطلق الذي يجسد “النقاء الثوري” في مواجهة ما اعتبره انحرافاً بيروقراطياً داخل الحزب نمط ثوري رديكالي هو نتاج العوامل الكثيفة والغزيرة التي أفرزتها عوامل القفزة الكبرى و الثورة الثقافية في مواجهة التيار التكنوقراطي الحزبي المحافظ المرتكز على مجموعة قيادات وكوادر نضالية كان لها دور فعال في الحرب ضد اليابان والانتصار الثوري وهزيمة القوميين.

الثورة الثقافية: الثورة كفعل واع:
“إن من منطق الفكر الثوري ألا يمارس فعله في حركة الواقع الاجتماعي إلا إذا تجسد في ممارسة سياسية واعية لمسارها الثوري.”
مهدي عامل، مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني.
“الثورة الثقافية (الصينية) الحدث السياسي الأكثر أهمية في النصف الثاني من القرن العشرين، لأنه وانطلاقاً منها خاصة من الأسباب العقلانية لفشلها، نستطيع ويتوجب علينا التفكير بالدخول فيما يمكننا تسميته ب”المرحلة الثورية الثالثة” للفكر الشيوعي. الثالثة بعد مرحلة التأسيس الماركسية الأولى في القرن التاسع عشر والمرحلة اللينينية للتجربة الأولى التي تكسرت على صخرة معادلة الدولة/الحزب.”
آلان باديو , فيلسوف فرنسي ، الثورة ضد التقليد… وضد الحزب!!!
التيار اليساري المرتبط ب «عصابة الأربعة»، الذي سعى إلى استمرار نهج الثورة الدائمة في قيادة الحزب، والتعامل مع الحكم بوصفه صراعاً أيديولوجياً مفتوحاً ضدّ ما أسموه «النزعات البرجوازية» التي تسللت لجسم الدولة والتي تهدد الطابع الإشتراكي ومصير الثورة ككل هذا الجناح هو الإبن الشرعي للثورة المنتصرة نهاية الأربعينيات والفاعل الأبرز في مرحلة الثورة الثقافية أو بما يعرف بالأدبيات الرسمية ب الثورة الثقافية البروليتارية العظمى التي انطلقت تحت ضغط ماو من أجل ثورة داخل الثورة؛ فقد كان في رأي الزعيم المؤسس أن الطبقات الحاكمة القديمة والتقليدية قد أطيح بها بعد فترة قصيرة من تأسيس الجمهورية الشعبية في عام 1949، إلا أن تأثيرها الثقافي لا يزال حياً في المعتقدات والسلوكيات اليومية العامة للشعب ولا يمكن التخلص منها إلا بإعادة أحياء السيرورة الثورية متمثلةً في خلق مجتمع بروليتاري بعد حرب أهليّة مدمّرة والتوجّس من الانحراف نحو عودة لإحياء الرأسمالية وهدر مكتسبات الجمهورية الشعبية حديثة العهد التي حققها الإصلاح الزراعي الموسع والتخطيط الاقتصادي المنظم من نتائج مذهلة، كانت الثورة الثقافية على القيم والمفاهيم الجمعية السائدة لإحداث قطيعة مع مخلفات الماضي والتراثية الرجعية التي تعيق صيرورة التحول الثوري نحو الاشتراكية من خلال المفاهيم والقيم الماركسية اللينينية ومنطلقات العالم ثالثية المعادية للإمبريالية على صعيد العلاقات الخارجية، الثورة الثقافية كانت شاملة، فبرامجها التنفيذية شملت جميع القطاعات عملياً كنوع من إعادة بناء ثوري لكل الهياكل الإنتاجية والاجتماعية هذا التيار الذي تزعمها كان يستمد شرعيته من القيادة والزعامة الرمزية للقائد ماو وكانت بمثابة المرحلة الختامية لإكمال سياسته، بما عرف نهاية الخمسينيات بالقفزة الكبرى إلى الأمام حين ألزم فئات كبيرة من الشعب بترك المزارع والعمل في المصانع لتحقيق طفرة في زيادة معدلات الإنتاج، وأنشأ في الدولة مجتمعات خاصة في الريف تشبه التعاونيات الزراعية، وأسس برنامجاً وطنياً طموحاٌ لإنتاج الصلب باستخدام تقنيات بدائية للغاية. سرعان ما دخلت الصناعات في حالة من الاضطراب حيث كان الفلاحون ينتجون الكثير من الفولاذ دون الزائد عن حاجة المصانع، ما أرهق الصينيين معنوياً لعدم خبرتهم بالعمل الصناعي بحيث أن أغلبهم من الطبقة الفلاحية.
في خريف عام 1966، كانت الصين تعبر واحدة من أكثر محطاتها التاريخية إثارة للجدل. حين وجد الزعيم ماو تسي تونغ أن القوى المعادية للثورة قد تسللت إلى مفاصل الحزب والدولة، فأطلق صيحته المدوية التي اهتزت لها أركان الأمّة: “أنزلوا إلى الشوارع!”، موجِّهاً نداءه إلى جيل الشباب الذي يحمل روح التمرّد. لم يكن مجرد خطاب عابر، بل كان إعلان حرب على هياكل السلطة القائمة، ودعوة صريحة لاقتلاع ما اعتبره “بذور البرجوازية” من جذورها.
لم يكد يُسدل الستار على هذا البيان التاريخي، حتى بدأت تتبلور ملامح قوة جديدة في المشهد السياسي. مع أولى حرارات صيف ذلك العام، انبثقت مجموعات الحرس الأحمر من الجامعات والمدارس، حاملين في عقولهم نصوص الماوية، وفي قلوبهم حماسة التغيير. كان هؤلاء الطلاب بمثابة الجنود الفكريين الذين أُنيط بهم مهمة تجسيد الرؤى الثورية على أرض الواقع، فتحولوا من متلقِّين للأفكار إلى منفِّذين لها، يحملون مشاعل التمرد في دروب الثورة الثقافية.
تحولت ساحات المدارس والجامعات إلى مسارح للصراع الأيديولوجي. ارتدى ملايين الشباب الملابس العسكرية وحملوا الكتاب الأحمر، متحولين إلى “الحرس الأحمر” الذي كان يفترض به أن يكون طليعة التغيير. لكن الحماسة الثورية سرعان ما تجاوزت كل الحدود، فشهد آب/أغسطس 1966 أحداثاً دموية ستظل محفورة في ذاكرة الأمة.
بالتالي لم تكن الثورة الثقافية مجرد حملة سياسية عابرة، بل كانت عاصفة هزت جذور المجتمع الصيني. فقد مثّلت الثورة الثقافية (1966–1976) إحدى أكثر المراحل اضطراباً في تاريخ الصين الحديث، إذ شهدت البلاد خلالها موجات من العنف السياسي الثوري والصراعات الداخلية التي طالت مؤسسات الدولة والحزب والمجتمع على حد سواء، في ظل تصاعد الحماسة الأيديولوجية والتجديد الثوري التي دعا إليها ماو لإحياء روح الثورة الاشتراكية. ورغم أن هذه الحركة لم تُعدّ استراتيجيةً أو ركيزة تقليدية في السياسة الخارجية، فإن تداعياتها امتدت إلى خارج حدود البلاد، في المقابل، كان للثورة الثقافية الصينية، على الرغم من طابعها المعادي ظاهرياً للغرب، وثقافته بالعموم، لكنها أثرت تأثيراً غير متوقّع في الأوساط الثقافية والسياسية الغربية، ولا سيما بين الشباب الجامعيين المتمردين في مدن أوروبا الغربية. فقد ألهمت الحماسة الثورية الماوية قطاعات واسعة من الطلبة والمثقفين، خصوصاً في فرنسا، حيث تزامن صداها مع تصاعد موجات التمرد الطلابي التي بلغت أوج ذروتها في أحداث أيار/مايو 1968. في تلك المرحلة، أصبح “الكتاب الأحمر الصغير” رمزاً ثقافياً متداولاً في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وتحوّل إلى شعار احتجاجي يرفعه الطلبة اليساريون والماويون الأوروبيون، بل حتى بعض أبناء الطبقات البرجوازية التقليدية الذين رأوا في الفكر الماوي تحدياً للنظام الرأسمالي القائم كقدر أبدي لا فكاك منه.
كان المشهد أشبه بعاصفة لا يمكن كبح جماحها. مكتبات أُحرقت، معالم تاريخية دُمّرت، ومثقفون تعرضوا للاضطهاد. العالم الخارجي نظر بذهول إلى ما كان يجري، ورأى في ماو ستالين الشرق، بينما كان هو يؤمن بأنه ينقذ روح الثورة من الانحراف.
بينما كانت سحب التوتر تكتنف الصين، انطلقت تعليمات ماو بنقل الحرس الأحمر إلى أعماق الريف، فقد كانت تلك الخطوة أشبه بصمام أمان أمام طاقة ثورية شارفت على الخروج عن السيطرة، في لحظة تاريخية حرجة كادت أن تدفع بالبلاد إلى هاوية الصراع الداخلي.
هؤلاء الشباب الذين نشأوا على عقيدة الولاء المطلق، والحماسة الثورية، والتضحية بلا حدود، وجدوا أنفسهم في سباق محموم لإثبات جدارتهم. تحولت حياتهم إلى مسرح دائم للعروض الثورية، حيث كان كل منهم يرفع راية الولاء أعلى من الآخر، في منافسة لا تنتهي لإثبات التفوق في الإخلاص للثورة.
لكن شرارات العنف التي أشعلوها لم تترك وراءها سوى رماد الخيبة. بعد كل المعارك التي خاضوها، اكتشفوا أنهم لم يبنوا شيئاً، ومن هذه التجربة المؤلمة، بدأت بذور التحول تنمو. فالجيل الذي انطلق بحماسة عمياء في الثورة الثقافية، ها هو اليوم يضع الأسس الفكرية للإصلاحات المقبلة.
في البداية، وجد هؤلاء الشباب أنفسهم غرباء في عالم الريف البسيط. نظروا إلى حياة الفلاحين بعين الاستعلاء، معتبرين إياها متخلفة، ورافضين فكرة تحولهم إلى مزارعين. لكن الأيام علمتهم دروساً جديدة. فالحياة بين الحقول والمزارع كانت نقيضاً تاماً لكل ما تعلموه في قاعات الدراسة.
كانت الأرياف مرآة كشفت لهم وجه الصين الحقيقي. هناك، حيث الحقول الممتدة والبيوت الطينية، اصطدمت مثالية المدينة بواقع الريف القاسي. تحولت الشعارات الثورية التي رددوها لسنوات إلى أسئلة معلقة في هواء الريف النقي. “لماذا نعيش هكذا؟” سؤالٌ بدأ يتردد في أذهانهم مع كل غروب شمس.
لم تعد العروض الثورية كافية لإثبات الولاء، فالحياة اليومية بين المزارعين أصبحت هي الاختبار الحقيقي. تدريجياً، بدأ الولاء الأعمى يتحول إلى شك، والشك إلى إعادة نظر. اكتشف هؤلاء الشباب أن الصين التي عرفوها من الكتب تختلف عن الصين التي يعيشون فيها.
ببطء، بدأوا يشككون في معنى الثورة ذاتها. من هذه الشكوك، ولدت حركة ثقافية سرية، رفضت عبادة الأصنام السياسية، وبدأت تشكل لغة مقاومة جديدة. كانت هذه الحركة الخفية هي الشرارة التي أضاءت طريق التنوير، التي ستتوج لاحقاً ببروز أصوات التغيير والمطالبة بالحرية.
كانت هذه الصحوة هي الأساس الذي قامت عليه حركات التنوير اللاحقة. فمن حقول الأرياف، حيث قضى الشباب سنوات تكوينهم، انطلقت شرارة التفكير النقدي التي ستشكل فيما بعد ملامح الصين الحديثة. لقد تحولوا من أدوات في آلة الثورة إلى مفكرين يبحثون عن طريق جديد لأمتهم.
هكذا، ومن بين رماد التجربة المريرة، نهض جيل جديد حاملاً معه دروس الماضي ورؤى المستقبل، ليرسم ببطء معالم طريق التنوير الذي سيسلكه الوطن.
لكن رياح التغيير التي هبّت بعنف، سرعان ما تحولت إلى عاصفة جارفة. وبعد خمسة عشر عاماً من تلك الأحداث، وتحديداً في عام 1981، صدر حكم رسمي من أعلى المستويات وصف تلك الحقبة بأنها “زلزال اجتماعي” تسبب في اهتزاز كيان الأمة. في الوثائق الرسمية، نُسبت المسؤولية إلى القائد الذي “أشاع الفوضى في ربوع البلاد، وجلب النكبة للحزب والدولة وجميع أبناء الشعب”.
غير أن الصفحة لم تُقلب كلياً، بل ظلت مفتوحة على أسئلة معلقة. فالسلطات اكتفت بهذا التوصيف الموجز، ورفعت ستار الصمت عن النقاش العميق حول تلك الحقبة الشائكة. وفي عصرنا الحالي، امتد هذا الصمت إلى الفضاء الإلكتروني، حيث تُمرَّر منشورات مواقع التواصل عبر غربال الرقابة الدقيق.
يبقى التناقض قائماً في الوعي الجمعي: فبينما تُصنف تلك الحقبة في المخيلة الشعبية كأكثر المراحل اضطراباً في تاريخ الصين المعاصر، إلا أن بعض المحللين يلاحظون استمرار تيار يرفع لواء القيم اليسارية التي مثلتها تلك الفترة. وهنا يبرز براعة الحزب الشيوعي الصيني في السير على حبل مشدود: الإشادة بإرث ماو من ناحية، والاعتراف ب”الانحرافات” من ناحية أخرى، في لعبة توازن سياسي تعكس تعقيد قراءة التاريخ.
كان هنالك مناخ من الانبهار بالثورة التجديدية في موجة من الرحلات الفكرية إلى الصين قام بها عدد من المثقفين الأوربيون البارزين أمثال الفيلسوفان جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار في الصين نموذجاً لإعادة توزيع السلطة والثروة يمنع نشوء طبقة جديدة مهيمنة، ويمكّن الجماهير من ممارسة سلطة فعلية.
إن عقد الثورة الثقافية بما رافقه من إشكالات وانتقادات سيظل موجة من موجات الرياح الثورية التي اجتاحت الصين في القرن التاسع عشر فكل اضطراب أو ثورة أو انقلاب في تاريخ البلد جعل للتغيير الثقافي شغله الشاغل ومن هنا الثورة الثقافية التي بدأت في ستينيات القرن العشرين لها اتصال وارتباط وامتداد بلا قطيعة بكل موجات التغيير الاجتماعي التي سبقتها ولكنها مازالت الموجة الأعنف والأكثر ترسخاً والأعمق أثراً.
لكن قصة ماو لم تنتهِ بهذه الصفحة المظلمة. فبعد نصف قرن، ما زال الصينيون يتذكرون الرجل الذي وحد بلادهم بعد قرون من التشرذم. ما زال وجهه يزين العملات الورقية، وضريحه في بكين يستقبل الزوار يومياً. لقد نجح في تحويل ولاء الصينيين من العشيرة والقبيلة إلى الوطن الموحد، من تقديس الأجداد إلى الإيمان بأمة واحدة.

مرحلة مابعد وفاة ماو: التحول والانفتاح الصيني:
توفي ماو تسي تونغ في عام 1976، وفي منتصف سبعينيات القرن العاشر، كانت عجلة الاقتصاد الصيني تدور ببطء متثاقل، وكأنها تئن تحت وطأة أزمات متراكمة. بحلول عام 1978، أصبح مسار النمو الاقتصادي أشبه بسفينة تتقاذفها الأمواج في محيط مضطرب، بينما تراجع دخل الفرد إلى هوة سحيقة إذا ما قورن بالدول الرأسمالية المتقدمة.
لكن هذه اللحظة التاريخية لم تكن مجرد منعطف عابر في سجل الأرقام والإحصائيات، بل كانت تجسيداً لرحلة فكرية عميقة تعود بجذورها إلى عام 1949. فمنذ تأسيس الجمهورية، ظل مفهوم “تطوير القوى المنتجة” يشكل حجر الزاوية في الرؤية الاقتصادية الصينية، مستمداً روحه من النظرية الماركسية التي ترى في اندماج الطاقة البشرية مع أدوات الإنتاج أساساً لبناء المجتمعات.
وقد تجلت هذه الرؤية بوضوح في مفهوم “الديمقراطية الجديدة” الذي صاغه ماو تسي تونغ، حيث رسم خريطة لتحالف ثوري واسع يجمع تحت رايته كل القوى المناهضة للإقطاع والاستعمار. في تلك المرحلة التأسيسية، كان “الشعب” يعني تحالفاً طبقياً متعدد الأوجه: العمال والفلاحون، البرجوازية الصغيرة في المدن، والبرجوازية الوطنية. جميعهم يتحدون تحت قيادة الحزب الشيوعي لبناء دولتهم، وليفرضوا سلطتهم على ما وصفهم ماو ب”كلاب الإمبريالية المسعورة“.
وهذه الفلسفة السياسية لم تكن مجرد خطاب نظري، بل تجسدت رمزياً في تصميم العلم الصيني، حيث ترمز النجوم الأربع إلى هذه الطبقات الثورية المتضامنة، تدور حول النجمة الكبرى التي ترمز للحزب القائد، في لوحة بصرية تروي قصة تحالف تاريخي صاغ مصير أمة.
بين عامي 1978 و1989، رسمت أيادي التغيير ملامح صين جديدة. في تلك الحقبة التكوينية، وبفضل مهندس النهضة بدأ الشعب يتخلص من الفقر، حاملاً بذور إصلاح ستبذر خضرة الازدهار في ربوع الأمة.
كانت تلك السنوات الإحدى عشرة بوتقة انصهرت فيها إرادة شعب، لتبني من رماد التخلف نهضة اقتصادية ستجعل من الصين عملاقاً ينبض بأقوى نبضات النمو في العالم. لم تكن مجرد أرقام ترتفع على الجداول، بل كانت تحريراً لملايين البشر من براثن الفقر، وانعتاقاً للفلاحين من ظلام التخلف، وولادة جديدة للريف الصيني.
في ذاك العام الحاسم 1978، اتخذت الصين منعطفاً تاريخياً بعيداً عن النموذج السوفياتي الصارم، نحو آفاق اقتصادية أكثر مرونة. لم تكن تلك الخطوة مجرد تغيير في السياسات، بل كانت نقلة نوعية في الفلسفة الاقتصادية، حيث أُطلقت مبادرات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وأُعيد الاعتبار للحوافز الفردية في عملية الإنتاج.
تعود جذور هذه النقلة إلى الرؤى الاستثنائية لأحد أعمدة الحزب الشيوعي الصيني، شو إن لاي، الذي أعلن في خطابه الأخير عام 1975 عن خريطة طريق المستقبل – سياسة التحديثات الأربعة التي شملت الزراعة والصناعة والبحث العلمي التكنولوجي والدفاع. كانت هذه الرؤية هي البذرة التي ستثمر لاحقاً في عهد دنغ شياو بينج.
لم تكن هذه التحولات مجرد قرارات سياسية، بل كانت ثورة اقتصادية غير مسبوقة. فقد منحت الفلاحين والعمال حق استثمار الفائض من إنتاجهم بعد تسليم حصص الدولة، فتحولت هذه الحوافز إلى محركات للنمو. تضاعف الإنتاج الصيني كما لم يحدث من قبل، وقفز الناتج القومي الإجمالي بين 1978 و1995 بنسبة مذهلة.
وفي مؤشر على سرعة هذا التحول، حققت الصين ما استغرقته الولايات المتحدة 47 عاماً وبريطانيا 58 عاماً واليابان 37 عاماً في مضاعفة دخل الفرد، خلال عقد واحد فقط من الزمان. كانت هذه الأرقام شاهدة على ولادة عملاق اقتصادي جديد، يكتب تاريخه بوتيرة تذهل العالم.
وفي مسيرة النهضة تلك، يبرز عام 1984 كجوهرة متلألئة في تاج الإنجازات. ففيه ارتفع منحنياً إنتاج الحبوب إلى 400 مليون طن، محققاً للصين اكتفاءها الذاتي بعد رحلة طويلة من الشح والمعاناة.
وفي ذات العام، كانت يد الحكمة تُحيك خيوط المصير، فتمكنت من استعادة هونغ كونغ إلى حضن الوطن الأم، ووضعت الأسس لعودة ماكاو. كانت هذه الإنجازات تتويجاً لرؤية “دولة واحدة ونظامان” التي نسجت حلاً فريداً يجمع بين اشتراكية القطر الواحد وخصوصية المنطقتين.
لقد كانت تلك الحقبة نسيجاً من الرؤى والإرادات، حاكتها أيام من العمل الدؤوب، لتخلق من حاضر متعب مستقبلاً زاهراً، وتحول أحلام الأمس إلى واقع يعيشه الصينيون اليوم.

دينغ شياو بينغ وإصلاحات الانفتاح: “الاشتراكية ذات الخصائص الصينية”:
“إنّ الجدال على معايير تحديد الحقيقة هو في الواقع جدالٌ على الخطّ النظري، على السياسة، وعلى مستقبل ومصير الحزب والأمّة”.
دِنغ شياو بينغ
بعد غروب عصر ماو تسي تونغ، وقفت قيادة الحزب الشيوعي الصيني على مفترق طرق تاريخي. كانت الرحلة التي انطلقوا فيها تشبه عبور نهر مجهول، حيث لم تترك لهم الكتب المقدسة النظرية خريطة، ولم تقدم التجارب الاشتراكية السابقة بوصلة. في عام 1987، عبر دنغ شياو بينغ عن هذه المغامرة الكبرى بكلمات تحمل قوة القطع: “هذا طريق لم يسلكه الأسلاف، ولم تخضه أي دولة اشتراكية من قبل”.
كانت التجربة الصينية تشبه نبتة تنبت في تربة لم تزرع من قبل، تتلمس طريقها بين الصخور والعقبات. لم يكن هناك سوى الظلام أمامها، لكن جذورها كانت تتقدم بثبات تحت الأرض. هكذا وصف دنغ شياو بينغ منهجهم: “نتقدم خطوة بخطوة في الممارسة العملية، نتعلم من خلال السير على الطريق”.
كان الحلم يرسم خريطة مستقبلية طموحة: تحويل الصين إلى دولة اشتراكية حديثة، تبلغ اقتصاداتها مستوى الدول متوسطة التقدم. لكن الرحلة لم تكن قصيرة، بل كانت تحتاج إلى صبر الأجيال. حدد دنغ شياو بينغ إطاراً زمنياً يمتد من تأسيس الجمهورية حتى مائة عام، رحلة خمسين أو ستين عاماً أخرى تمتد كسلسلة جبال يتسلقها الجيل تلو الجيل.
وفي خضم هذه الرحلة الطويلة، كان لا بد من حبل يربط الماضي بالحاضر. التمسك بتقاليد الحزب أصبح الجسر الذي يعبر فوق هوة التغيير. كان العمل الجاد هو الوقود، والحكمة كانت البوصلة. هكذا رأى دنغ شياو بينغ أن “العمل الجاد والعقل الحكيم” هما الجناحان اللذان سيحلقان بالصين نحو مستقبل لم يره أحد من قبل.
في خضم العواصف التي واجهت السفينة الصينية، أدرك القائد أن البقاء في قلب المعمعة يتطلب نقلة جوهرية. كانت البوصلة تشير إلى اتجاه واحد: تحرير الاقتصاد من قيوده، وفتح النوافذ الموصدة لتدخل رياح التقدم، وانتشال الملايين من وهدة الفقر. لم يكن الأمر مجرد سياسات اقتصادية، بل فلسفة جديدة للوجود الوطني.
من حقبة الشتاء الفرنسي التي قضاها بين منابر المعرفة، استمد إيمانه بأن التكنولوجيا ليست أدوات باردة، بل لغات حوار مع العصر. دعا إلى ثورة هادئة تزاوج بين أصالة الفكر الاشتراكي وحيوية آليات السوق، حيث تصبح جرأة الإدارة الاقتصادية سلاحاً للبناء، وتتحول محطات التقدم العالمي إلى محطات إلهام، فشرع في حفر قنوات جديدة للتغيير، فلم يكن إصلاحه اندفاعاً عشوائياً، بل كان مسيرة متأنية تحكمها معادلة ذهبية جمعت بين تدريجية الإصلاح ومتانة الاستقرار. انفتحت الأبواب على اقتصادات العالم، وغرس بذور الانتماء إلى العصر، فيما ظل السقف السياسي صامداً يحمي المسيرة من عواصف الفوضى.
كانت خريطة الطريق التي رسمها تشبه سفراً ملحمياً بثلاث محطات كبرى. في المحطة الأولى، لم يكن الهدف مجرد أرقام في تقارير التنمية، بل كان تحويل حلم الخبز والدفء إلى واقع ملموس، وقد تحقق هذا الحلم قبل أن تدق ساعة نهاية العقد الثمانيني ليكتب أول فصول المعجزة.
أما المحطة الثانية كانت تتلخص في مضاعفة ناتج البلاد أربع مرات بحلول نهاية الألفية، لكنّ إصرار الأمة تفوّق على الزمن، فتحقق الحلم قبل أوانه في عام 1995، وكُتبت ملحمة التقدم بأحرف من ذهب.
المحطة الثالثة، فهي رحلة إنسانية أعمق، تسعى لأن يبلغ دخل الفرد الصيني بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين مستوى الدول المتوسطة النمو. حينها، سيعيش المواطن في بحبوحة من العيش، وتكتمل ملامح دولة حديثة تنعم بالازدهار.
ولكي توضع اللبنات الأولى لهذا الصرح، انطلق القائد في رحلة تفقدية إلى ثلاث مقاطعات في الشمال الشرقي، هي جيلين ولياونينغ وهيلونغجيانغ. جال بين أروقتها والتقى مسؤوليها وأبناء شعبها، حاملاً شعلة الأمل داعياً إلى نهضة شاملة. كان يؤكد أن طريق التحديث في مجالات الاقتصاد والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والدفاع الوطني، هو طريق ممكن إذا ما اقترن بالإصلاح والتطوير، والانفتاح على كل نافع ومفيد من تجارب العالم. كانت الرؤية واضحة: “أن نصنع مستقبلنا بأيدينا، على أسس متينة من الجهد والعلم والانفتاح الواعي”.
في تلك الحقبة التي شهدت تحولات عميقة، كانت بوصلتُه الدبلوماسية ترسم مساراً استثنائياً للصين على الخريطة الدولية. ففي عام 1978، وقّع بحكمة معاهدة السلام والصداقة مع اليابان، ليكون هذا التوقيع بمثابة حجر أساس في بناء جسور التواصل مع العالم.
كانت زيارة الرئيس نيكسون للصين عام 1972 محطة فارقة، أعقبها حوار متواصل مع الدبلوماسي المخضرم هنري كيسنجر، حتى اكتملت اللوحة باعتراف رسمي أمريكي بالصين.
ومع إطلالة عام 1979، حمل في جعبته رؤية جديدة إلى الولايات المتحدة، حيث نجح في تحويل مسار التاريخ بإعادة رسم العلاقات بين البلدين. لقد كانت ثمرة جهود متواصلة بدأت بحركة “دبلوماسية كرة الطاولة” في مطلع السبعينات، تلك الرقعة الصغيرة التي دارت فوقها كرة من الأمل، لتدفع بعجلة التاريخ إلى الأمام.
لم يتوقف البناء الدبلوماسي عند هذا الحد، فالجسور التي كانت قد تقطعت مع الاتحاد السوفيتي بسبب خلافات فكرية بدأت تتصل من جديد.
لكن الحلم الأكبر كان ينتظر تحقيقه، حلم عاشه الصينيون في قلوبهم طويلاً. جاءت لحظة التاريخ في عام 1997، عندما توجّت مسيرة التفاوض الطويلة بإعادة هونغ كونغ إلى حضن الوطن الأم، ليكتمل بهذا الإنجاز لوحة دبلوماسية رائعة رسمها برؤيته الثاقبة وإرادته الصلبة.
وبينما كانت الصين تنسج خيوط علاقاتها الجديدة مع العالم، كانت تستعد أيضاً لإعلان نضوج قدراتها الردعية. ففي عام 1984، انطلقت من منصة الاختبارات الصينية أولى صواريخ “دي إف-5” الباليستية العابرة للقارات، حاملةً رسالة صامتة إلى العالم: أن الصين قد أصبحت قادرة على إيصال رادعها النووي إلى أبعد نقاط الكرة الأرضية، بما في ذلك العمق الأمريكي.
أما عن التحديات التي تواجه العملاق الصيني اليوم، فهي ثلاثية الأبعاد: يطفو على السطح تحدي الاقتصاد بعد أن خفتت وتيرة النمو القياسي الذي اعتادته البلاد، فيما يتربص في العمق شبح التفاوت الاجتماعي، ذلك الوحش الذي أنجبته سنوات الانفتاح، ففتح هوة بين قمم الثروة وقيعان الفقر. ولا يغيب عن المشهد تحدي البيئة بمشكلاتها المتفاقمة، والتي تهدد بتقويض مكاسب التنمية، لكن ببصيرة القائد دينغ شياو بينغ، اختارت الصين مساراً مختلفاً عن تجربة الغرب، محققةً معادلة نادرة جمعت بين الانفتاح الاقتصادي والثبات السياسي، ففي مواجهة هذه التحديات، تظل الآلية واحدة: البوصلة الذهبية التي رسمها دينغ، والتي تواصل توجيه السفينة بين أمواج التقدم المتلاطمة مع الحفاظ على ثباتها. هنا يبرز الحزب الحاكم كحارس أمين لهذه المعادلة، بقوته البشرية التي تفوق تعداد أمة بأكملها كألمانيا، مؤكداً أن مسألة الاستقرار ليست مجالاً للمساومة أو التهاون.
لقد شكلت إصلاحات دينغ درعاً واقياً حمى البلاد من مصير مظلم، كان يمكن أن يتحول إلى واقع مرير يشبه تجارب أمم أخرى انهارت من الداخل. فالبحار البشرية الصينية الهائلة، لو تركت لقوى التمزق والصراعات الداخلية، لأصبحت طوفاناً إنسانياً يغرق المنطقة والعالم بأكمله في دوامة من اللجوء والاضطراب، إلا أن الصين اختارت مساراً فريداً للإصلاح، لم يكن انقلاباً صاخباً ولا جموداً متحجراً، بل كان تحولاً مدروساً بخطى واثقة فقد كان دينغ شياو بينغ يحدق بأفق العالم، متجاوزاً الحدود الضيقة، مستلهماً من نماذج النجاح في أمريكا وأوروبا واليابان، حيث تتحدث الأرقام بلغة أصدق من كل الشعارات والخطابات الأيديولوجية الجوفاء، إذ أدرك أن نهضة الأمم لا تُبنى على أساطير تمجيد القادة، بل على حقائق الاقتصاد وإنجازات التنمية.
وفي الجهة المقابلة، كان شبح الجمود والتزمت يتربص بالصين، مهدداً بإرجاعها إلى عصور الإنغلاق، حيث تتحول إلى قوة عسكرية مترهلة تقف فوق أرضية من الفقر والعوز. لكن حكمة القيادة الصينية استطاعت أن تنتشل البلاد من هذا المصير، فجمعت بين الأصالة والمعاصرة، وبين التقاليد والحداثة، في صيغة فريدة أذهلت العالم.
هكذا تشكلت مسيرة متراكمة، مهدت للقائد الصيني اليوم ليقف في منتدى دافوس رمزاً للعولمة الواعية، حاملاً معه سجلاً استثنائياً: إنقاذ سبعمائة مليون إنسان من براثن الفقر، وتحويل الصين إلى عملاق اقتصادي يحتل المرتبة الثانية عالمياً، في رحلة نادرة جمعت بين حكمة الأصالة وحيوية العصر.
لقد كتب دينغ وشعبه ملحمة الصعود الصيني، محولين البلاد من دولة منهكة إلى عملاق اقتصادي، دون أن تدفع الصين ثمناً سياسياً أو اجتماعياً كما حدث لغيرها. كانت رحلة متوازنة، سارت فيها عجلة التحديث بثبات، بينما حافظت البلاد على هويتها واستقرارها، في إنجاز تاريخي قلّ نظيره.
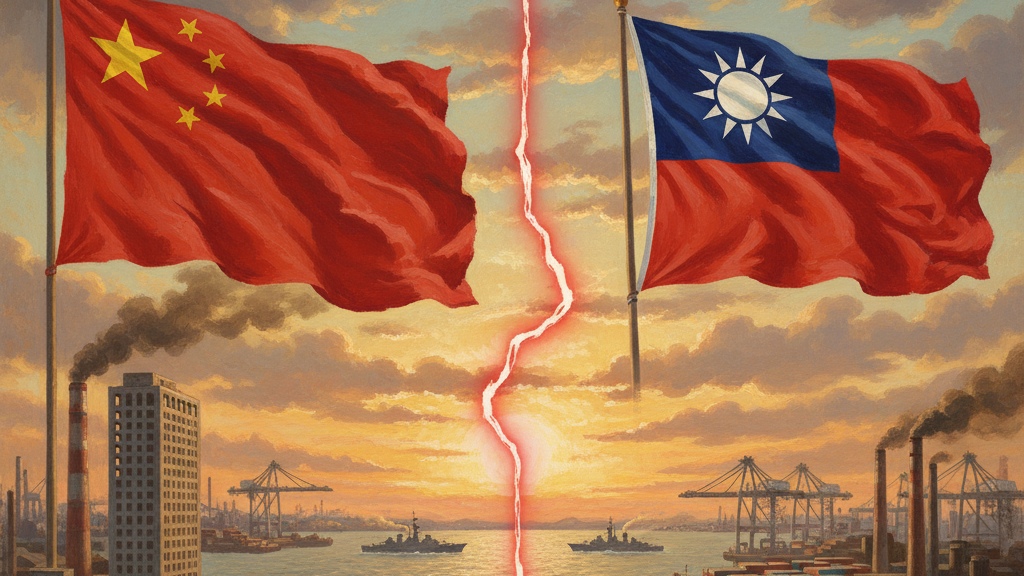
تايوان: سياسة “الصين الواحدة”، التبادلات الاقتصادية والتوترات العسكرية المستمرة:
بينما كانت الصين القارية تعاني من عزلة دولية في خضم الخلافات الأيديولوجية مع المعسكر الشيوعي والنزاعات الحدودية مع الجار الشمالي، شهدت تايوان تحولاً دراماتيكياً بدعم غربي. في مشهد يعكس تناقضات الحرب الباردة، تمكنت تايوان من الاحتفاظ بالمقعد الدائم في مجلس الأمن الدولي الذي كان مخصصاً للصين، بينما ظلت الحكومة الأم خارج دائرة الضوء الدولية.
لم يقف جيش التحرير الشعبي الصيني مكتوف الأيدي أمام هذا الواقع، ففي منعطف عام 1957، شن الجيش الذي تفوق عددياً بثلاثة أضعاف على قوات الكومينتانغ محاولة لغزو الجزيرة. لكن الأحلام التوسعية تحطمت على صخرة الواقع الجيوسياسي، حيث تدخلت الولايات المتحدة مباشرة بينما مارست موسكو ضغوطاً خفية على بكين، مجبرة إياها على التراجع.
من ركام المعارك الفاشلة، ولدت سلسلة من المحادثات السرية في وارسو عام 1970، حيث جلس ممثلو الصين والولايات المتحدة على طاولة واحدة محاولين تخفيف حدة التوتر. سنوات من المفاوضات المتقطعة لم تثمر عن نتائج ملموسة، لكنها رسمت ملامح مرحلة جديدة من الدبلوماسية الواقعية.
مع مطلع السبعينيات، بدأت معادلة القوى في التحول. تطور الصين المتسارع دفع واشنطن إلى إعادة حساباتها، متبنية رؤية هنري كيسنجر التي تجسدت في مقولته الشهيرة: “لا وجود لعدو دائم أو صديق دائم، بل هناك مصالح دائمة”. وأصبح الملف التايواني اختباراً عملياً لهذه الفلسفة.
في لحظة تاريخية مفصلية، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أكتوبر 1971 القرار رقم 2758، الذي مثل نقطة تحول في المسار الدولي للصين. القرار أعاد الحقوق المشروعة للصين في الأمم المتحدة، معترفاً بأن مندوبي جمهورية الصين الشعبية هم الممثلون الشرعيون الوحيدون للصين، وطرد ممثلي تايوان من المقعد الدائم في مجلس الأمن.
هكذا انقلبت الموازين، لتدخل تايوان في نفق العزلة الدولية بينما عادت الصين إلى مكانتها الطبيعية على الساحة العالمية. حتى المجلس النيابي الذي فر إلى تايبيه بدأ يذوي تدريجياً، مع رحيل أعضائه واحداً تلو الآخر، في مشهد يختزل تحولات حقبة كاملة من التنافس الدولي.
ففي ملف تايوان الشائك، يُمثل التعبير الأوضح عن أولوية الجغرافيا السياسية وأسبقيته في آليات صنع القرار الصيني على أي معطى آخر، فالقضية ليست سياسية أو اقتصادية فقط، بل تتعلق بهوية الدولة ومصيرها، وبالتالي عمقها الأمني وموقعها ضمن توازنات القوة المعقدة في المحيط الهادئ. لذلك لا تتردّد بكين في إرسال إشارات قوية بأنّ أي إخلال بالوضع القائم سيمسّ جوهر سيادتها ويفجر صراعاً كونياً من غير الممكن ضبط والتحكم في تبعاته فمن منظور التاريخ الصيني، تُعد تايوان جزءاً لا يتجزأ من الجغرافيا السيادية الصينية منذ قرون، وقد كانت عودتها إلى الوطن الأم حلماً مؤجلاً منذ منتصف القرن العشرين أي منذ انتصار الثورة الماوية، بالنسبة لبكين لا يمكن تصور اكتمال النهضة الصينية أو تحقيق ما يُعرف ب“النهضة العظيمة للأمة الصينية” دون توحيد الأرض والشعب تحت راية واحدة. ولهذا، فإن قضية تايوان ليست قضية سياسية قابلة للمساومة أو لبازار السياسة الدولية، بل هي مسألة سيادة ووحدة وطنية لا تحتمل التجزئة أو استمرارية الوضع الراهن والقائم حالياً بالشكل الإنفصالي الذي تتبعه تايبه.
أما من الناحية الجيوسياسية، فتايوان تمثل الموقع الأكثر حساسية في معادلة الأمن الإقليمي. فهي تقع في قلب ما يُعرف ب“سلسلة الجزر الأولى” التي تمتد من أرخبيل اليابان شمالاً إلى الفلبين جنوباً، وتشكل خطّاً دفاعياً طبيعياً لطوقٍ استراتيجي يحاول الحدّ من تمدد النفوذ الصيني نحو سيادة مطلقة على المحيط الهادئ.فعودة تايوان لوطنها الأم، يمكن بكين من كسر هذا الطوق الجغرافي، والانفتاح بحرّية على أعماق المحيط، بما يعزز قدرتها على حماية طرق التجارة البحرية ومصالحها الاقتصادية في الأسواق العالمية.
كما أن الأهمية الاقتصادية لتايوان تضيف بُعداً آخر للمسألة؛ فالجزيرة تُعد مركزاً عالمياً لصناعة أشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة، وهي صناعة ترتبط مباشرة بالأمن التكنولوجي والاقتصادي للدول الكبرى على رأسها واشنطن، ومن هذا المنظور، فإن سعي بكين المشروع لاستعادة تايوان لا يهدف إلى التوسع بقدر ما يسعى إلى تأمين مستقبلها الصناعي والتقني وضمان استقلال قرارها في عالم يتجه نحو صراعات التكنولوجيا والبيانات والاستثمار في التقانة العالية.
على الجانب الآخر من العالم، تُظهر التجربة الأوروبية مدى استعداد الدول المعاصرة للتضحية بالمصالح والمنافع الاقتصادية حين تتعارض مع اعتبارات الأمن القومي، فقد اختارت أوروبا كلفة الطاقة المرتفعة وفقدان السوق الروسية الواسعة مقابل تثبيت تصوراتها الاستراتيجية تجاه موسكو بعد الحرب الأوكرانية، بينما واجهت روسيا خسائر كبيرة في صادرات الطاقة والاستثمارات الأجنبية على الأقل في السنوات الأولى التي تلت الحرب.
توضح هذه الأمثلة المتباعدة مكاناً والمتقاربة في رمزيتها ودلالاتها سياسياً أن منطق القوة لم يفقد سلطانه على الوعي السياسي للقيادة الصينية، أجل الاقتصاد عامل مهم، لكنه يظل قابلاً للتعديل حين تشتد قبضة الجغرافيا، فالخرائط تُرسم وفق خطوط النفوذ لا وفق منحنيات الأرباح وتبدلاتها أي تأثير الموقع والجغرافيا السياسية هو مايتحكم وينسج سياسة الدولة لا الأرباح والمكاسب التجارية وحدها – لا يزال الواقع الجيوسياسي يلقي بظلاله المتنوعة على نمط الإنتاج السياسي والمادي للبشرية جمعاء، أجل الاقتصاد هو المحرّك الجبري الأوحد والدافع لحركة التاريخ وعصب الحياة ضمن الفهم الماركسي الذي يشكل منبعاً أساسياً في النهضة الصينية ((لكنه لايمكن سوى أن يكون جزء من كل)) داخل هذا «البراغدايم الجيوبوليتيكي» الذي يشكّل عبارة اصطلاحية شاملة قد تخفي خلفها غابة من المعاني والكثير من التأويلات والإسقاطات، لكنها على قدر سعتها تستطيع أن تعبّر عن معانٍ مختلفة، بوصفها حاوية معرفية مفاهيمية. فهي بمثابة عنصر الروح في فلسفة هيغل، فيما يغدو الجيوبوليتيك مع الصين منهجاً وأداةً لإدارة الصراع على المكان والقوة والنفوذ والموارد. الفكرة هنا تشبه نظّارة كونية يرتديها صانعو القرار الصيني ليروا الخارطة العالمية لا كمساحة جامدة، بل كرقعة شطرنج كونية ما تزال اللعبة فيها مستمرة.
هذا البراغدايم المفاهيمي يجعل الصين تستحضر من تاريخها عبرة تحذيرية. فعندما تربّعت في مراحل تاريخية سابقة، وعلى مدى أكثر من عشرين قرناً، على عرش القوة في العالم القديم وكانت الإمبراطورية الصناعية الكبرى في عصرها، فإنها رغم ذلك لم تطوّر سياسات عالمية فاعلة خلال الفترات التي امتلكت فيها اليد الطولى في ميزان القوى الدولية، وربما يعود هذا إلى الطابع اللامركزي للنظام الدولي آنذاك أي قبل بداية التطور الرأسمالي في القرن السادس عشر، الذي قيّد انتشار نفوذها خارج فضائها الحضاري المباشر، إذ غلب على آباطرة الصين نمط محافظ النزعة لم يَرى حينها في التوسّع البحري الأوروبي الذي تزامن مع عصور النهضة، واكتشاف القارة الأمريكية وتوسيع خطوط الملاحة والتجارة الدولية سوى بهرجةٍ واستعراض قوى لحضارات بربرية، وانبهاراً بعجائب بعيدة لا تَدرُّ نفعاً حقيقياً على الإمبراطورية بالتفوق الثقافي، ومن منطق تاريخي استُنِد إلى فلسفات مختلفة، من الطاوية (فلسفة صينية تدعو للانسجام مع الطبيعة)، والخُماسية أو ووشينج (نظرية العناصر الخمسة في الكون)، والبوذية (ديانة وفلسفة تدعو للتأمل ونبذ التعلّق)، والكونفوشيوسية (تعاليم أخلاقية صينية تركز على الانضباط والأسرة)، وحتى الكونفوشيوسية العقلانية الجديدة، ورغم اختلاف هذه المدارس وتناقضها أحياناً، إلا أنها اشتركت في فكرة أن التاريخ يستوجب بين الحين والآخر الرجوع إلى الأصل أو استعادة التوازن القديم.

الصين في عهد الرئيس شي جين بينغ: سياسات وتوجهات:
في ظل الظلال الطويلة التي ألقاها تراث الزعيم دنغ شياو بينغ، واستمرار خلفائه على دربه، شقت الصين طريقها نحو الحداثة بثبات مذهل. بين طيات هذا التحول العظيم، كانت المفارقة تكمن في قدرة التنين الصيني على الحفاظ على استقراره الداخلي رغم العواصف التي أحدثتها التحولات الاقتصادية الهائلة، ورغم موجات الهجرة الداخلية التي أعادت تشكيل الخريطة الديموغرافية، وتلك الهوة المتسعة بين قمم الثروة وقيعان الفقر.
وفي مفارقة تاريخية أخرى، وجد العالم نفسه فجأة أمام ظاهرة نادرة: بروز إمبراطورية في زمن كان يعتقد الجميع أنه ودع عصر الإمبراطوريات إلى غير رجعة، منذ أن غرقت شمس بريطانيا عن شرق السويس، وآلت أحلام فرنسا في الهند الصينية إلى ذاكرة التاريخ.
لكن اللافت في هذه التجربة الفريدة، كما تلفت انتباهنا الباحثة الجليلة الدكتورة نهى المكاوي، هو أنها تمثل انقلاباً على النموذج الإمبراطوري التقليدي، فبينما كانت الإمبراطوريات القديمة تنطلق من مراكز صغيرة المساحة، قليلة السكان، كما كانت حال هولندا والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا وبلجيكا، لتسيطر على رقاع شاسعة وشعوب كبيرة لقرون طويلة، فإن هذه الإمبراطورية الوليدة تنطلق من مركز مكتظ بالسكان، مقدر لها أن تمد نفوذها نحو هوامش أقل كثافة سكانية.
من بين حقول الثورة وزعازع التاريخ، نبتت مسيرة قائد لم تكن دروب طفولته تشير إلى أنه سيبلغ ذروة الهرم في الحزب الشيوعي الصيني. حمل اسم والده “شي تشونغ شون” الذي سطر ملحمة بطولة ثورية انتهت به نائباً لرئيس الوزراء، لكن رياح الثورة الثقافية جاءت تحمل في ثناياها خلافاً بين الأب ومؤسس الحزب “ماو تسي تونغ”، مما جعل أبواب الانضمام للحزب تُغلَق مراراً أمام الابن.
لم يكن الصعود ممهداً بالورود، ففي عام 1974 بدأت الرحلة من قيادة الحزب في قريته، ثم ارتقى درجة درجة على سلم المسؤولية، حتى استقر به المقام في 1999 حاكماً لمقاطعة فوجيان، وكأن الأقدار كانت تُشكل مساراً استثنائياً بصبغة الصبر والمثابرة.
على الصعيد الشخصي، ارتبط الرئيس شي جين بينغ بعلاقة زواج مع الفنانة المعروفة بينغ لي يوان، المنحدرة من عائلة عسكرية مرموقة ذات تاريخ في جيش التحرير الشعبي. ورغم الرواية الرسمية التي تروي قصة صعوده الاعتماداً على ذاته وتواضعه، تشير قراءة مساره الوظيفي إلى اعتماده على منهج براغماتي حاذق، تمثل في بناء شبكة دعم داخل أجنحة الحزب، لاسيما بين شخصيات بارزة مرتبطة بتيار جيانغ زيمين، الذي عمل تحت مظلته أثناء فترة حكم الأخير لشنغهاي.
من جهة أخرى، يثير الموقف من الولايات المتحدة والغرب تساؤلات حول التناقض الظاهر؛ فبينما يوجه انتقادات لاذعة للحضارة الغربية، تبقى دوائر الأعمال الدولية هي الأكثر تفاؤلاً بصعوده، مستندة في ذلك إلى خبرته الطويلة في إدارة المناطق الاقتصادية الحيوية على الساحل الشرقي. هذه المناطق مثلت النموذج الأمثل للتجربة الصينية في توظيف آليات السوق لخدمة استراتيجيات الدولة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحويل هياكل الحزب إلى كيانات اقتصادية فاعلة.
وفي هذا الإطار، لا يمكن إغفال الإرث العائلي؛ فقد كان والده، شي تشونغ شون، من الأدمغة الخفية التي ساهمت في التخطيط لأول منطقة اقتصادية خاصة في شنتشن مطلع ثمانينيات القرن الماضي، مما يضفي بُعداً تاريخياً على هذه الرؤية الاقتصادية.
في خطابه المئوي، رسم بريشة الواقعية أحلام المستقبل، مركزاً على “بناء الصين لتصبح دولة اشتراكية عظمى شاملة الحداثة” بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية. الرؤية التي تحتاج إلى قوة سياسية حكيمة لتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكمة الحقيقية تكمن في توظيف هذه القوة لخدمة الصالح العام، حيث تعلو القيمة المجتمعية على المصالح الضيقة، تاركاً للشعب مساحات من الحرية ينطلق فيها بمهاراته وإبداعاته.
هكذا تتحول المسيرة الفردية إلى جزء من سيرة وطن، والرؤية الشخصية إلى مشروع أمة، في معادلة تصهر الطموح بالحكمة، والسلطة بالمسؤولية.
في ظلّ عالمٍ تتصارع فيه الرؤى، يقف الإنسان حائراً بين نمطين متباينين لخلق الثروة. فبينما تنحسر في أحدهما لتصبح غايةً في ذاتها، تعلو في الآخر لتكون جسراً يعبر بالإنسان نحو كرامته. هنا، في هذا الموضع، تُختزل الفلسفة في سؤال جوهري: هل ننتج لنعيش، أم نعيش لننتج؟
كانت البداية في فكر ماركس حين حلّل برنامج غوتا، فكشف أن الإنتاج ليس طاحونةً تدور لطحن الأرباح، بل هو ينبوعٌ يروي ظمأ الإنسان إلى الحياة الكريمة. فحين يُصاغ العالم على مقاس الحاجات لا على قياس الأرباح، تتحول الثروة من سجانٍ إلى محرّر.
لكنّ الطريق إلى تلك الغاية شائك، ففي النظام الرأسمالي، ينقلب المعيار رأساً على عقب. يصير الإنتاج معبداً لرأس المال، وتتحول السلع إلى أوثانٍ تُعبد. يصف ماركس في “رأس المال” هذه الآلية التي تسحق الإنسان، فكلما ازداد العامل عطاءً، ازداد افتقاراً. وكأنه يسير في حلقة مفرغة، حيث تذوب إنسانيته في بوتقة الإنتاج، وتتحول علاقاته مع الآخرين إلى سوقٍ للمقايضة. هنا، يولد الاغتراب – هذا الغول الحديث الذي يفصل الإنسان عن جوهره.
وتزداد الخطورة حين تتحول الدعاية والإعلان إلى أدواتٍ تخلق حاجاتاً وهمية، كأنها سرابٌ في صحراء، يلهث خلفه الإنسان حتى يعود إلى نقطة الصفر. في هذه الدائرة، يضيع التوازن بين ما يحتاجه الإنسان حقاً وبين ما ينتجه فعلاً.
لكن الأفق يضيء مع المبدأ الشيوعي الأعلى: “لكلّ حسب حاجته”. إنها ليست مجرد شعارات، بل رؤية لمستقبل تذوب فيه الفواصل بين الجهد والعطاء. يصف إنجلز في “أصل العائلة” هذا التحول النوعي، حين يتحرر العمل من قيود الأجر، وتتحرر الثروة من قيود الملكية. عندها يصبح العمل تعبيراً عن الذات، لا وسيلة للبقاء، ويصبح الإنتاج نشاطاً جماعياً تتكامل فيه الأيدي لبناء عالمٍ أكثر إنسانية.
هكذا تتحول المسيرة من سعيٍ وراء الربح إلى رحلة بحثٍ عن المعنى، من اغترابٍ في عالم الأشياء إلى اتحادٍ مع جوهر الإنسانية. في هذه الرحلة، لا يكون العمل عبئاً، ولا الإنتاج واجباً، بل يصبحان أغنيةً جماعية يرددها البشر وهم يبنون عالمهم المشترك.
والحال أن الصين أدركت منذ نهاية السبعينيات أنّه ليس لنظامها مصلحة في محاربة المجتمع الاستهلاكي، بل على العكس، مسابقة العالم إليه، سواءً بإنتاج السلع الاستهلاكية على أوسع نطاق، أو بتوسعة دائرة استهلاكها من قبل الصينيين، أو بالترويج للثقافة الاستهلاكية نفسها طالما بالمستطاع فصلها عن تنمية الوعي الفردي الإعتراضي، أو المطالب بالمشاركة السياسية. في نفس الوقت، استمرّ النظام يجد «سرّه» في طرفة منسوبة لدينغ شياو بينغ بأنه لا ضير، في دولة يحكمها حزب شيوعي، من المساكنة مع السوق وظهور كبار أغنياء، طالما بالمستطاع مصادرة ما لهم في أي وقت.
من أقدم الحضارات الإنسانية، تنهض الصين المعاصرة كعملاق يخطو بثبات على مسرح الجغرافيا السياسية العالمية. تشهد أرقام التنمية – من الناتج المحلي الإجمالي إلى مؤشرات التنمية البشرية – على تحول جذري في موازين القوى، فيما تنسج بكين شبكة شراكات دولية تعيد تشكيل خريطة النفوذ العالمي. هذا الصعود المهيب لا يخلو من إثارة قلق المراكز التقليدية للقوة في الغرب.
رغم هذا الحضور الطاغي، تواجه التنمية الصينية رياحاً معاكسة، حيث بدأت مؤشرات النمو تشهد تباطؤاً ملحوظاً. يعزو المحللون هذا التراجع إلى عوامل متشابكة، أبرزها ضعف الطلب المحلي وتصاعد النزاعات التجارية، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مما يضع الصين أمام اختبار حقيقي يتطلب استجابة استراتيجية ذكية.
وفي قلب المعجزة الاقتصادية، تتناثر أسئلة مصيرية تنتظر إجاباتها. فبينما تحلق التنين الصيني في فضاءات النمو المتسارع، تبرز تحديات داخلية تمسّك بخيوط نجاحه وتشدّه نحو الأرض.
كيف للقيادة أن تحافظ على وتيرة النمو المرتفع، وهي تشبه راقصاً على حبل مشدود فوق هاوية؟ إنها معادلة صعبة، حيث كل خطوة يجب أن تكون محسوبة بدقة، وكل حركة تقاس بموازين دقيقة.
وفي ظل التحول الكبير الذي عاشته مئات الملايين من الصينيين، الذين انتقلوا من براثن الفقر إلى فضاءات العيش الكريم، تبرز رغبات جديدة وتطلعات متجددة. فمن ذاق طعم التحسن في ظروف حياته، بات يتطلع بطبيعة الحال إلى دور أوسع في رسم ملامح مستقبله ومستقبل بلاده.
وفي عصر الثورات التكنولوجية المتلاحقة، تواجه الصين تحديثاً مفتوحاً لا هوادة فيه. إنها سباق مع الزمن، حيث تتوالى الموجات التقنية الواحدة تلو الأخرى، والبقاء في المقدمة يتطلب جهداً استثنائياً ووعياً مختلفاً.
وأمام ثورة الاتصالات والمعلومات، يتحول كل مواطن إلى صحافي يكتب، وناشر يوزّع، وشاهد يروي. إنها لوحة جديدة كلياً للحياة الاجتماعية، تتطلب أدوات جديدة للتعامل، ورؤى متطورة للتفاعل.
في هذا السياق، يبرز مشروع طريق الحرير الجديد كاستجابة عميقة الرؤية. إنه ليس مجرد ممر تجاري، بل بوابة لإعادة اكتشاف “الحلم الصيني” في عصر الرئيس شي جين بينغ. عبر هذه المبادرة، تخلق الصين مسارات متعددة لتعزيز نفوذها الجيوسياسي والجيوستراتيجي، مقتنصة فرصة تاريخية لإعادة تشكيل النظام العالمي، فهذا المشروع يمثل مبادرة عملاقة تهدف إلى ربط آسيا بالعالم عبر شرايين جديدة: موانئ تفتح أبواب المحيطات، وجسور تعبر القارات، وشبكات سكك حديد تمتد كخيوط فضية تصل بين الشعوب، إلى جانب طاقة نظيفة تلمع كمصابيح أمل في مستقبل أكثر إشراقاً. هذه المشاريع ليست مجرد خطوط على الخرائط، هي وعود بملء الفجوات التنموية التي تركتها حقب الاستغلال الطويلة.
هذه الشبكة الدولية الواسعة تمنح بكين أدوات متعددة الأبعاد لتعزيز حضورها الدولي، في مواجهة غرب يترقب بقلق صحوة التنين الصيني من سباته التاريخي. إنها معادلة جديدة لصراع شرق-غرب تتشكل أمام أعيننا، حيث تتحول طرق القوافل القديمة إلى شرايين حيوية للقوة الناعمة والنفوذ الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين.
وفي صميم هذه الرؤية، تكمن إستراتيجية عميقة لتحرير الاقتصادات الضعيفة من قيود التبعية للعملة الأمريكية، فكلما نما اقتصاد دولة واشتد عودها، واتصلت بجيرانها وبالصين كشريك تجاري رئيسي، كلما تضاءلت قدرة القوى التقليدية على فرض إرادتها عبر أدوات الإكراه الاقتصادي. وهكذا تفقد العقوبات الاقتصادية، تلك الأداة المفضلة للإمبريالية، حدة تأثيرها شيئاً فشيئاً.
تتعدد أوجه هذه الخطة، لكن جوهرها يرتكز على بناء البنى التحتية وتمويل المشاريع الاستثمارية في أراضي الآخرين، وإقامة مؤسسات دولية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية. والمفارقة التاريخية الكبرى أن السياسات العدوانية للقوى التقليدية، والإرث المثقل للمؤسسات التي تهيمن عليها مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد دفعا العديد من الدول إلى الانضواء تحت مظلة المشاريع الصينية، حتى تلك التي لم تكن لتجرؤ على هذه الخطوة في ظل ظروف أخرى. لقد ولّدت الهيمنة القديمة رغبة جامحة في البحث عن بدائل، فكانت هذه المبادرة هي الإجابة.
في سياق التحولات الكبرى التي تشهدها الساحة السياسية، يبرز تشبيه لافت يقارن الرئيس شي جين بينغ بفلاديمير إليتش لينين، من حيث منهجية المواجهة التي تبدأ بالمجال الفكري قبل الانتقال إلى الجانب التنظيمي. هذا المنهج يتجلى في ما وصفه المراقبون ب”الإطاحة بزعيم تيار المحسوبية المؤيد للولايات المتحدة”، في حركة تعكس دقة في التعامل مع الخصوم.
في مسرح العالم الواسع، حيث تتقاطع مصائر الأمم، تشهد اللوحة الجيوسياسية تحولاً صامتاً،إذ لم يعد الأمر مجرد منافسة تقليدية، بل هو انزياح تدريجي في مركز الثقل، حيث يبرز كيان ضخم كان حتى الأمس القريب يراقب من الأطراف.
ها هو التنين الشرقي يتحرك في مسار مختلف، محققاً انطلاقة قوية في مرحلته الثالثة، محمولاً برؤية جديدة تزينه بثوب الحداثة والحيوية. لم يعد يتقدم بحذر، بل يخطو بثبات واضح على رقعة الشطرنج العالمية، حاملاً معه نهجاً فريداً يجمع بين دهاء الدبلوماسيا وقوة الاقتصاد.
إنه لا يتجنب المعضلات الدولية المعقدة، بل يقدم عليها بجرأة، معالجاً القضايا الشائكة التي ظلت لعقود تستعصي على الحل. لقد نجح في انتزاع زمام المبادرة من يد القطب التقليدي، محولاً نفسه إلى فاعل دولي يحمل مصداقية واضحة.
ها هو اليوم يلعب دور الوسيط النزيه، وصانع السلام الذي يعجز الآخر عن مجاراته. لقد أصبح مقبولاً على الساحة العالمية ليس كمنافس فحسب، بل كبديل حقيقي، كقطب جديد يقدم نموذجاً مختلفاً للقيادة العالمية. المشهد يتغير، والملعب لم يعد كما كان.
في خطاب تاريخي أُلقِيَ أثناء خريف عام 2014، استحضر الرئيس الصيني تصوراً فلسفياً ضارباً في القدم، ظل يتردد صداه عبر كتابات الحكماء منذ فجر الحضارات الإمبراطورية الأولى. إنه مفهوم “تيانجيا”، ذلك المُركّب الثقافي الذي شُحذت معانيه على مدى عصور، بدءاً من حكمة لاوتزي مروراً بفلسفة كونفوشيوس، ليصير تعبيراً عن العالم المادي بكل ما يحويه من أرجاء مترامية.
تكمن عبقرية هذا المفهوم في كونه لا ينظر إلى العالم ككيان مادي فحسب، بل كمشهد إنساني معمور بالإنجازات والعلاقات. إنه الكون تحت القبة الزرقاء، حيث لا وجود لتقابل بين عالم فانٍ وآخر مطلق، بل ثمة نسق كوني واحد تتداخل فيه السماء والأرض.
يحمل التصور بُعدين متلازمين: أحدهما يرصد امتداد الجغرافيا بما تحويه من مجتمعات وصناعات، والآخر يضع هذا الامتداد ضمن تسلسل قيمي تحت السماء. هنا تبرز الفضيلة كقوة محركة لهذا النسق، كخيط ناظم يربط بين مراكز التأثير وأطرافها. وفي قمة هذا الهرم الكوني يقف “ابن السماء”، ذلك الحاكم الذي يجسد حلقة الواصلة بين السماء والأرض، فيحمل مسؤولية تدبير شؤون العالم بأسره، ويصير كل ما تحت القبة السماوية جزءاً من مسؤوليته، وخاتماً في سلسلة حكمته.
في امتدادٍ لفكرة “تيانجيا” نحو آفاق العلاقات الدولية، يبرز البُعد الخارجي والعسكري لنموذج الحكم المثالي. هذا الامتداد يحمل في طياته إمكانية فرض هيمنة شاملة لقانونٍ صارم، لكن أي مفهوم هذا الذي تتشكل منه رؤيته؟
هكذا يتشعب النهر الفكري إلى مجريين: واحد يركز على البنية القانونية كأداة للتنظيم والتقدم، وآخر يرى في القانون جسراً نحو حرية الفرد ورقابته للسلطة.
الرؤية التي تتبناها القيادة الصينية المعاصرة تتركز في جوهر واحد: رقابة الشعب على السلطة من خلال سن التشريعات ومراقبة تطبيقها. هذا هو التجسيد العملي لمبدأ سيادة القانون الذي يؤمن به الرئيس شي جين بينغ وفريقه القيادي، حيث تتجلى دولة القانون بالمعنى التشريعي الحديث – كما يؤكده الرئيس شي جين بينغ وفريقه الحاكم – في جعل الشعب رقيباً على السلطة عبر سن التشريعات ومراقبة تطبيقها. وقد صاغ المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة عام 2007، السفير دويان جييلونغ، رؤيته لهذا المفهوم واصفاً إياه بأنه “غاية تسعى إليها جميع الأمم، وأداة فاعلة لإقامة النظام وتحقيق العدالة ودفع عجلة التقدم الاجتماعي”، ففي أروقة الأمم المتحدة قدم المندوب الصيني الدائم تصوراً مكثفاً لهذا المفهوم، فعرفه بأنه “غاية إنسانية سامية، وهدف مشترك تتحرى عنه الأمم، وأداة فاعلة لإرساء دعائم النظام، وإقامة العدالة، وتمكين المجتمع من تحقيق التقدم”.
جاء هذا التعريف رداً على رؤية سابقة للأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان، الذي أضاف أبعاداً لم يذكرها الدبلوماسي الصيني: ضمان حقوق الإنسان، والمساواة بين المواطنين، ورقابة المحكومين على الحكام، واستقلالية مؤسسات المحاسبة – من برلمانات وقضاء ومنظمات مجتمع مدني وإعلام – عن هيمنة السلطة.
في امتدادٍ كوني لفلسفة “تيانجيا”، تتحول العلاقات بين الأمم إلى مسرحٍ لتطبيق المثال الأعلى في الحكم، حيث تتحول سلطة القانون إلى نفوذٍ مطلق لا يقبل المعارضة. هذه الهيمنة التشريعية تلبس ثوب “الحق الدولي” الذي لا يجوز نقاش شرعيته.
هنا يتبدى الفارق الجوهري بين رؤيتين: واحدة ترى في القانون أداة للحوكمة والنظام، وأخرى تنظر إليه كضمانة للحريات وحقوق الأفراد ورقابة على من بيدهم الأمر.
هكذا تنسج خيوط الرؤية الصينية للعالم، حيث تتحول السيادة إلى قدرٍ تاريخي، والقانون إلى سلطة لا تحتاج إلى تبرير، والإمبراطورية إلى فكرة تُقاس بأبعاد انتقائية تخدم رواية الهيمنة الجديدة.
إننا نعيش لحظة تاريخية استثنائية، نشهد فيها ميلاد أول إمبراطورية في العصر الحديث، عصر الثورات المدنية والحقوق السياسية والاحتجاجات الاجتماعية، عصر الرفض المتجدد للهيمنة والظلم وعدم المساواة.
وفي هذا المشهد التاريخي الفريد، نحن شهود على تحول جيوسياسي غير مسبوق، حيث يستعد شعب المليار وثلاثمائة مليون نسمة لصياغة علاقة إمبراطورية جديدة مع شعوب المليون والخمسة ملايين والمئة مليون. ونحن أمام عتبة سنوات ستشهد توقيع حزم من الاتفاقيات التي سترسم ملامح هذا التحول الكبير، في مشهد قد لا يتكرر في التاريخ المعاصر.

الجيوبوليتيك سيّد الموقف: حين تُمسك بكين بخيوط الجغرافيا:
من ظل قرن الذل، إلى وهج الصحوة، تشق الصين طريقها عبر متاهة العلاقات الدولية بحذر الحكيم ودهاء الاستراتيجي. لطالما ظلت تتبع وصية دينغ شياو بينغ التي تشبه الهمس الحكيم: “لا تبرز أكثر من اللازم، لا تستعرض قواك”، وكأنها تختبر حكمة الشرق القديم في ظل عالم متقلب. لكن مع تنامي القوة الاقتصادية، تلك الركيزة التي تُعتبر عماد السياسة الصينية، بدأت ملامح الثقة تظهر على وجه العملاق النائم.
مع بزوغ عهد شي جين بينغ، أخذ الحلم الصيني يأخذ أبعاداً أكثر وضوحاً. انطلقت ورش إصلاح شاملة، ومشاريع عملاقة، وكأنما الأمة تستعد لاستحقاقات مصيرها. كل ذلك يجري تحت سقف هموم واحدة: كيف تحافظ على كيانها الموحد، وكيف تصون استقرارها الداخلي من عواصف العالم.
ففي مواجهة العاصفة ذات الحدين، يقف التنين الشرقي أمام امتحان وجودي. فمن جهة، تلوح في الأفق سحابة التحدي العسكري والاقتصادي، ومن جهة أخرى، تنسج خيوطٌ خفيةٌ تهدف إلى اختراق النسيج الداخلي للنظام. هذه المعادلة المعقدة تدفع بالأمة إلى تبني رؤية استراتيجية تتجاوز حدود الزمن الآني.
إذ يتراءى الحلم الصيني كسفينة عملاقة تشق عباب المحيط الهائج على متنها تحمل ثلاثة أشرعة رئيسية: الحفاظ على كيان الأرض المقدس، وحراسة بحار شرق آسيا والمحيط الهادئ من رياح التدخل الخارجي، وبناء ملاذ آمن للتنمية الاقتصادية في محيط دولي مضطرب. هذه السفينة لا تقتصر على حماية نفسها فحسب، بل تتجه للمشاركة في رسم خريطة الملاحة العالمية.
كما إن جراح الماضي لا تزال تنزف في الذاكرة الجمعية. فصراعات الحرب الباردة، وهيمنة القطب الواحد، وتداعي الأنظمة الشقيقة، كلها شواهد على مخاوف تتحول إلى كوابيس. في هذا المسرح، برزت الولايات المتحدة كخصم استراتيجي، ليس فقط لقوتها العسكرية، بل لقدرتها على اختراق الجدران الداخلية، وهذا هو الكابوس الذي تسعى الصين لتفاديه بكل ما أوتيت من قوة.
إن استراتيجية الصين الكبرى تشبه رقعة شطرنج كونية، كل حركة فيها تحسب بدقة. من سياسة الاحتواء إلى مشاريع إعادة التشكيل، من الحذر إلى الجراءة المدروسة، تسير الصين في طريقها بخطى واثقة، حاملة معها إرث ماضيها، وتطلعات مستقبلها، في عالم لا يعترف إلا بمن يمتلك إرادة البقاء.
تُجسد مبادرة الحزام والطريق، باستثماراتها التي تقارب تريليوني دولار، إحدى الركائز الأساسية في الاستراتيجية الصينية لتعزيز مكانتها العالمية. تمثل هذه المبادرة رؤيةً اقتصادية طموحة تهدف إلى استثمار نمو التبادل التجاري العالمي لتعزيز صادرات الصين، واختصار مسارات التجارة العالمية، وترسيخ مكانة الشركات الصينية التقنية والعملة الوطنية (اليوان) على الخارطة المالية الدولية، ففي هذا المشهد، تبرز مبادرة “الحزام والطريق” كخريطة ملاحية عابرة للقارات. إنها ليست مجرد طرق تجارية، بل هي شرايين حيوية تعيد نبض الحياة إلى جسد أوراسيا من خلال نسج شبكة من المصالح الاقتصادية المتبادلة، تخلق بكين نسيجاً من العلاقات يستطيع أن يوازن ثقل النفوذ البحري التقليدي. هذه الشبكة تشبه نولاً حياً يحيك خيوط المصير المشترك، حيث يجد كل شريك نفسه مرتبطاً بمصالحه الحيوية في هذا الامتداد الاقتصادي العملاق.
وفي بعدها الجيوسياسي، تتجه المبادرة إلى رسم معادلة نفوذ جديدة، عبر احتواء التمدد الأمريكي في آسيا الوسطى والشرقية، وتمديد دائرة التأثير الصيني إقليمياً وعالمياً. كما تقدم الصين من خلال هذا المشروع نموذجاً تنموياً مغايراً للنمط الغربي، معززةً بذلك موقعها كقوة دولية صاعدة وقادرة على منافسة الولايات المتحدة في رسم ملامح النظام العالمي الجديد.
(استناداً إلى: Paulo Afonso 2018، و Leonard 2016)
بينما تتجه أنظار الغرب بحذرٍ نحو السياسة الخارجية للصين، خاصة في استخدامها للقوة الناعمة، تبرز في المقابل قصص نجاح مختلفة من العالم النامي. فالنموذج الصيني – بحسب ما تظهره كتابات الباحثين – يشكل مغناطيساً جاذباً للدول الطامحة لتحقيق قفزات تنموية سريعة، فقد استطاعت الصين والدول الآسيوية المرافقة لها أن تنسج من خيوط النظام العالمي الجديد نسيجاً اقتصادياً متميزاً، محولةً نفسها إلى مراكز إشعاع اقتصادي جديدة. هذه التحولات تجعل من التجربة الصينية مصدر إلهام للكثيرين، رغم تلك النظرات المتشككة التي ترصد كل حركة من حركات هذه القوة الصاعدة.
استناداً إلى حكمات 2018

البراكسيس الصيني:
بين ضفاف الفلسفة وهدوء الحكمة، تنبض قلوب مئة وأربعمائة مليون إنسان في الصين. ليسوا بحاجة إلى معابد تعلو نحو السحاب، ولا إلى طقوس تُرى بالعين، فإيمانهم منبثق من أعماق الأرض التي تربّوا عليها. إنه إيمان من نوع آخر، نسيجه من قيم الانضباط والواجب، وخيطه اللامرءوس من تضحية صامتة وولاء للجماعة.
هنا، حيث يلتقي الكونفوشيوسي بالطاوي في رقصة وجودية، لا يوجد ابن وحيد، بل يوجد جندي في معركة بناء الأمة. كل فرد هو لبنة في صرح “العائلة الكبرى”، وكل قلب ينبض بإيقاع الوطن. إنهم كالنهر العظيم، يبدو هادئاً على السطح، لكن تياراته العميقة تجري بقوة نحو هدف واحد.
في هذه الأرض، ليست الروابط دماً ونسباً فحسب، بل هي مسؤولية مشتركة، ووحدة مصير. إنهم شعب تحوّل إلى كتلة واحدة متماسكة، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
هذه ليست مجرد مجتمع، بل هي روح جماعية تتنفس قيماً تجعل من الفرد خلية في جسد الأمة الواحدة. إنها قوة الإيمان بطريقة أخرى، إيمان بالواجب، بالتضحية، بالانتماء. إيمان يجعل من الإنسان العادي بطلاً صامتاً في ملحمة الوطن.
في صميم المقاربة الصينية، يقف الجيوبوليتيك كمرجع يحدد مسارات النفوذ، فمبادرة «الحزام والطريق» مثلاً ليست مجرد مشروع بنى تحتية عابر للقارات، بل محاولة مدروسة لإعادة تشكيل طرق التجارة العالمية بما يعيد مركز الثقل إلى أوراسيا وليس إعادة لطريق الحرير القديم كما يكرر الغرب، فالمشروع الهائل يمنح الصين منفذاً ثابتاً نحو البحار الدافئة وموارد الطاقة والأسواق الجديدة، في عالم يحكمه منطق رأسمالي دينه وهاجسه التوسع، كما يشكّل بحر الصين الجنوبي نموذجاً آخر لإصرار بكين على تكريس وتعزيز حضورها، فتحديث قواها البحرية وبناء جزر اصطناعية والإستثمار الموسع في موانئ دولية خارج حدود سيادتها تتيح لها عملياً توسيع نطاق وخطوط حياتها الاقتصادية.
الفهم جيوسياسي النزعة الذي تمارسه بكين، تصبح العلاقات الاقتصادية فيه مرنة: يُتخلّى عنها أو يُعاد تشكيلها كلما اصطدمت بمحددات الموقع أو الأمن.
هذه الرؤية الاستراتيجية لا تنفصل عن حلم النهضة. ففي كل محطة على طول طرق الحرير الجديدة، تزرع الصين بذور نموها، وتصنع بيئة دولية تكون فيها شريكاً لا يمكن تجاوزه. إنها لعبة شطرنج كبرى، تتحرك فيها القطع بحكمة بالغة، حيث يصبح كل طريق مفتوح، وميناء مشيد، وجسر ممتد، خطوة نحو تحقيق الحلم الأكبر.
في المشهد الجيوسياسي المعاصر، لم تعد ساحات النزاع تقتصر على التضاريس التقليدية التي شهدتها حروب الأمس، ولا على كنوز الأرض من نفط ومعادن، ولا حتى على سباق التسلّح النووي الذي هيمن على القرن الماضي. لقد انتقل بؤرة الصراع إلى عالم أكثر دهاءً وأعمق تأثيراً: عالم الشرائح الإلكترونية التي لا تُرى بالعين المجردة.
هذه القطع الصغيرة التي تتوارى خلف شاشات الأجهزة، أصبحت تشكل العصب الحيوي للحضارة المعاصرة. إنها القوة الخفية التي تدفع عجلة الحياة الحديثة – من هواتفنا الذكية إلى مركباتنا، من مصانعنا الذكية إلى أنظمتنا الدفاعية. لقد تحولت من مجرد مكونات إلكترونية إلى أركان استراتيجية تتحكم في مصير الأمم، تلك القطع البلورية الصغيرة التي أصبحت العقل المدبّر للحضارة الحديثة.
أما ساحة المعركة الجديدة فهي ليست أرضاً يحدها خطوط طول وعرض، ولا بحاراً تُرسم حدودها على الخرائط. لقد أصبحت ساحة عالمية ممتدة، تشمل مختبرات التصميم في الغرب، ومراكز التصنيع في الشرق، ومناجم الثروات المعدنية في أفريقيا، وخطوط التجميع الممتدة عبر القارات. كل محطة في هذه الرحلة الإنتاجية تشكل حلقة في سلسلة مصيرية، يحمل كل حرف منها سراً من أسرار القوة، ويخفي كل وصلة منها إمكانية تغيير موازين القوى العالمية.
إنها معركة العصر التي تخاض في صمت، حيث تتحول الغرف النظيفة إلى ساحات قتال، والرقاقات الإلكترونية إلى أسلحة استراتيجية، والسلاسل الإنتاجية إلى جبهات جديدة في صراع القوى العظمى.
لا دويّ للانفجارات في هذه الحرب، ولا دخان يعلو ساحاتها، لكن آثارها تمتد عبر القارات. تشنّ الحملات بإغلاق خطوط الإنتاج، وتقييد تدفق التكنولوجيا، وتجميد طموحات الشركات والمخترعين. تتحرك الأذرع الخفية لتعيد تشكيل اقتصاد العالم من جذوره.
وفي الجانب الآخر من الكوكب، تُرى هذه المعركة كمحاولة لإيقاف مسيرة صعود تقني طموح. فتُوجّه الاستثمارات الضخمة لبناء إمبراطورية رقمية مستقلة، يسعى فيها الصنّاع إلى نحت طريقهم الخاص بعيداً عن الهيمنة التقليدية. إنها معركة إرادات، يتقابل فيها الطموح التكنولوجي مع محاولات كبح جماحه، في صراع سيحدد ملامح القرن الحادي والعشرين.
في سباق العصر الرقمي، تشق الصين طريقها نحو الصدارة في مجال الذكاء الاصطناعي بخطى واثقة، مستندة إلى رؤية استراتيجية ودعم مؤسسي يضعان الكفاءة الحاسوبية في صلب الأولويات. وتتجه التوقعات إلى أن يشكل نسيج هذه الصناعة وروافدها سوقاً هائلة تلامس حاجز 1.4 تريليون دولار مع حلول عام 2030.
وترتكز هذه المكانة المتقدمة على دعامات أربع تتكامل في بناء الصورة:
ففي عصر البيانات، تتحول الكثافة السكانية التي تزيد على 1.4 مليار نسمة، يعيش أكثر من مليار منهم في فضاءات رقمية عبر منصات التواصل والتجارة الإلكترونية، إلى نهر متدفق من المعلومات يغذي خوارزميات التعلم الآلي ويُسرّع نضج النماذج الذكية.
أما على جبهة الطاقة، فإن مسيرة البناء المتسارع لمحطات الطاقة النووية، التي تتجاوز ما ينشأ في سائر دول العالم مجتمعة، تُعد رهاناً استباقياً لتأمين الشريان الحيوي لمراكز البيانات العملاقة التي تستهلك كميات هائلة من الكهرباء.
وفي ميدان الحوسبة، تواجه صناعة الرقائق محطات تحدي، فرغم أن العقبات التجارية قد أبطأت الوصول إلى درجات عالية من الاكتفاء الذاتي في الرقائق المتقدمة، إلا أن المشهد المحلي يشهد إبداعاً صناعياً ومرونة ملحوظة تبعثان على التفاؤل بالمستقبل.
هكذا تنسج الصين خيوط قوتها التكنولوجية من خلال مقومات متعددة، تترابط فيها البيانات مع الطاقة، والتقدم التقني مع الإرادة الصناعية، في مشهد متكامل يسرد قصة صعود مختلف في عالم الذكاء الاصطناعي.
في مختبرات الابتكار الصينية، ترسم العقولُ ملامحَ المستقبل، حيث تحتضن البلادُ قرابةَ نصف نُخبة الباحثين العالميين في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تُضيء أكثر من نصف براءات الاختراع العالمية في هذا المجال بصمةَ إبداعهم.
وتعمل الدولة على تسريع هذه المسيرة عبر برامج تعليمية طموحة، تدفع بأجيالٍ جديدة نحو امتلاك ناصية هذه التقنية، فتصبح شهاداتُ الذكاء الاصطناعي ومهاراتُه الأساسية مطلباً استراتيجياً في مسيرة الطلاب.
ولا يتوقف أثر هذه التحولات عند حدود المختبرات والجامعات، بل يمتد ليشكل محركاً اقتصادياً واعداً. ففي المدى القريب، يُتوقع أن يعزز الذكاء الاصطناعي الاستثمارَ وينعش مؤشرات النمو، بينما على المدى البعيد، سيكون رافعةً مستدامةً لتحفيز الإنتاجية ودفع عجلة الناتج المحلي الإجمالي إلى آفاقٍ جديدة.
هكذا تتحول الاستثمارات في العقول إلى استثمارات في الاقتصاد، والبحوث الأكاديمية إلى وقودٍ للتنمية، في دائرة متكاملة تضع الصين في فرصتها التاريخية لقيادة ثورة الذكاء الاصطناعي.
جغرافيا الصين:

تشغل الصين موقعاً جيوسياسياً استثنائياً على الخريطة العالمية. فهي تقف في الطرف الشرقي الأكثر نشاطاً من منطقة الحافة، وتشرف على المحيط الباسيفيكي ((الهادئ)) الذي يشكل اليوم مركز التفاعلات الدولية، بينما تمتد بعمقها الجغرافي إلى تخوم قلب العالم القديم عند حدود منغوليا الداخلية وكازاخستان. هذا التموضع يمنحها دوراً محورياً يصعب تجاوزه في إدراك التوازنات الإقليمية والدولية.
تطل الصين من على شاطئ هذا النزاع مدعية أحقيتها في تسعة أعشار تلك الجزر المتناثرة، التي تخبئ بين أحضانها ثروات تكاد لا تحصى. فتحت أعماق تلك المياه ترقد كنوز طبيعية يقدر زيتها السائل بما لا يقل عن سبعة مليارات برميل، بينما تختزن مساحاتها أكثر من ثمانمائة تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
تشكل هذه الجزر معاً أرخبيلاً يستحوذ على مفاتيح الملاحة البحرية، حيث تتربع مجموعة جزر “سبراتلي” على عرش الأهمية الاستراتيجية، لتكون جوهرة بحر الصين الجنوبي المتلألئة وأكثر مواضعه قيمةً وأهمية.
تتعزز مكانة بفضل طبيعة القوة المزدوجة، البرية والبحرية معاً، ما يتيح لها التحرك بكفاءة مرنة عبر اليابسة الأوراسية، وفي الوقت نفسه بناء نفوذ بحري متصاعد ملاحي تجاري و أسطول بحري. تختلف بكين هنا عن الولايات المتحدة التي تُعد إمبراطورية قوة بحرية تقع خارج الكتلة الأوراسية وتعتمد على الانتشار البحري المكثف والقواعد العسكرية لمدّ نفوذها وتثبيت دعائم هيمنتها، كما تتمايز عن روسيا، القوة البرية التقليدية الضخمة ذات الضعف البحري الواضح والتراجع الديموغرافي والسكاني، بينما تمتلك الصين إمكانات نمو عسكري تقاني هائل وعامل بشري متنوع عدداً وكماً وطبقة عاملة مدربة كلها عوامل حاسمة يغنيها الموقع المميز بجغرافيا وطبيعة غاية في التعقيد والسعة، ورغم أن الهند تشارك الصين وزناً سكانياً واتصالاً غير مباشر بقلب العالم عبر أفغانستان، إضافة إلى موقع مؤثّر على الحافة من خلال المحيط الهندي وبحر العرب، تظل الصين أكثر تقدّماً بفضل وجودها في قلب ديناميكيات شرق آسيا وإشرافها المباشر والفعال على الباسيفيكي، فضلاً عن وضوح ثنائية قوتها مقارنة بنيودلهي. تمنح هذه المعادلة الجيوسياسية الصين القدرة على مجابهة المنافسين في البر والبحر في آن واحد. غير أنّ تطوير قوتها البحرية وتعزيز السيطرة على بحر الصين الجنوبي، بما يشكله من تهديد محتمل للمصالح الأمريكية واليابانية وتوازنات شرق آسيا ككل، يحتاج إلى بعض الوقت نظراً للحضور الطاغي والعسكري النزعة لواشنطن منذ استسلام اليابان وتقسيم شبه الجزيرة الكورية وحرب فيتنام والدعم العسكري لتايوان، لذلك تتجه الاستراتيجية الصينية حالياً نحو تعزيز حضورها في آسيا الوسطى، والانطلاق عبرها نحو الخليج العربي والبحر المتوسط وبالتالي شرق أوروبا، إذ يأتي إحياء طريق الحرير التاريخي من خلال مبادرة “الحزام” في هذا السياق كحاجة جيوبوليتيكية متشعبة البنى وليست كحاجة اقتصادية فقط أو كعرض عضلات دعائي للقدرات الصينية كما يصوره الإعلام الغربي، فهذه الحاجة يفرضها الواقع الجغرافي إذ تمتلك الصين حدوداً مع عدد كبير من المناطق المضطربة، وهو ما يفرض عليها قيوداً جغرافية تحد من قدرتها على التمدد وبسط نفوذها، فالجغرافيا، في هذه الحالة، تبدو كأنها عائقٌ طبيعي أمام الطموحات الصينية، إذ إن الصين محاطة تقريباً من جميع الجهات.
ومع ذلك، فإن الصورة لا تبدو بهذه السوداوية تماماً. فالتوسع الاقتصادي والديموغرافي الهائل الذي حققته الصين خلال العقود الأخيرة، إلى جانب توقعات استمرار نموها في المستقبل القريب — حتى لو بوتيرة أبطأ أو مع بعض التعثرات الممكن حصولها نتيجة كوارث طبيعية أو تفشي وبائي — يمنحها فرصة لتحويل هذا التحدي الجغرافي إلى مصدر قوة هائلة، فبدل أن تكون الحدود عبئاً عليها ومقيداً، قد تتحول إلى بواباتٍ لنفوذها، خاصة أن معظم جيرانها أقل ديناميكية وأضعف من حيث الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي.والحضري.
وهكذا، فإن الجغرافيا التي كانت تُعَدُّ يوماً ما حاجزاً أمام الصعود الصيني، قد تصبح اليوم إحدى أدواته في توسيع مجاله الحيوي وتعزيز مكانته في محيطه الإقليمي.انطلاقاً للعالمية.
إذ تكشف الأزمات الدولية المتلاحقة أن الجغرافيا تظل اللاعب الأكثر رسوخاً على رقعة السياسة العالمية، فحين ترتفع حرارة الصراعات، تتراجع لغة الأسواق أمام سعة الخرائط وحدودها، فتتقدّم مفاهيم الأمن والهيبة والسيادة. هذه الحقيقة تستوعبها بكين جيداً، وتحوّلها إلى بوصلة استراتيجية تقود تحركاتها الكبرى.

الدور الجيوسياسي للصين المعاصرة في نظام دوليّ متغيّر:
في رحلة الأمم نحو البناء والتقدم، تبرز الصين كنسيج مطرز بخيوط من الابتكار والحكمة. ففي مسيرتها الصناعية، لم تكن مجرد مقلدة للنماذج الجاهزة، بل صاغت بصمتها الخاصة التي تتناغم مع روح عصرها. وعندما انطلقت شركاتها عبر قارات العالم تحت مظلة “مبادرة الحزام والطريق”، كانت تحمل معها فلسفة تنموية أصبحت مصدر إلهام للعديد من الحضارات.
لقد أتقنت فن تحويل التحديات إلى فرص، حيث تشكل سياساتها محطة تزاوج بين الرؤية الداخلية والمتغيرات الإقليمية. هذا الانسجام بين الثبات والمرونة ليس إلا انعكاساً لإرادة وطنية صلبة، تشبه الشجرة الضاربة في الأعماق مع فروعها الممتدة نحو الآفاق.
وفي صميم هذه الرؤية، تتعمق مقومات السيادة لتتحول من شعارات إلى واقع ملموس. فالقدرة على حماية الحدود ليست سوى وجه واحد لعملة السيادة، أما الوجه الآخر فيتمثل في صناعة مستقبل يليق بالشعب، حيث الأمن ليس مجرد غياب للتهديدات، بل هو حضورٌ دائمٌ للكرامة والفرص.
هذه هي عبقرية المسيرة الصينية: بناء الذات مع انفتاح على العالم، والحفاظ على الخصوصية مع المشاركة في صياغة المصير المشترك. إنها رؤية تثبت أن القوة الحقيقية ليست في الانعزال، بل في القدرة على التأثير الإيجابي في المشهد العالمي.
⸨إنّ التصادمات الخطيرة في المستقبل من المرجّح أن تنشأ من تفاعل الغطرسة الغربية، وعدم التسامح الإسلامي، و”التمكّن الصيني”⸩.
صموئيل هنتغنغتون
لم يعد الحضور الصيني الطاغي اليوم مقتصراً على المؤشرات الاقتصادية والتنموية فحسب، بل بات يتجسد في إعادة تشكيل البُنى الجيوسياسية والإستراتيجية للنظام الدولي الذي ترسّخ بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتفكك حلف وارسو، وما تلاه من هيمنة أمريكية أحادية القطب امتدت لقرابة ثلاثة عقود
منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، شرعت بكين في انتهاج سياسة خارجية براغماتية تستند إلى مبدأ «الصعود السلمي» كنهجٍ دبلوماسي، بما يسمح لها بتوسيع نطاق نفوذها الدولي وتثبيت حضورها كقوة عظمى صاعدة دون الانجرار إلى صدامات مباشرة مع القوى المعادية والمنافسة، خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية.
هذه المقاربة البراغماتية هي مقاربة علمية وواقعية دفاعية تستند إلى قراءة دقيقة لموازين القوى العالمية والنظام الدولي الهش والمتحكم به من واشنطن وحلفائها، وتُظهر وعياً صينياً حذراً وغير مجازف بأن التحولات العميقة لا تُنجز بالقوة الصلبة وحدها فقط دون غيرها، فهذه المقاربة تستوعب ضرورة الدمج بين أدوات القوة الصلبة والقوة الناعمة، عبر توظيف الاقتصاد، التكنولوجيا والدبلوماسية الثقافية كوسائل متقدمة لإعادة إنتاج النفوذ العالمي وتعديل ميزان الصراع الدولي والتخفيف من أحاديته، فالصين تدرك أن موقعها الجديد لا يمكن انتزاعه عبر الصدام المباشر مع القوى التقليدية ممثلة بالغرب((حلف الناتو)) واليابان وكوريا الجنوبية، بل عبر بناء شبكات مصالح بنيوية تشد الأطراف نحو مركز ثقلها المتنامي بشكل مطرد، فهذا المناخ الدولي المضطرب قد يكون ولادة للعديد من التحولات الكبرى: لكون هذا النظام العالمي الذي ساد بعد نهاية الحرب الباردة وسقوط الإتحاد السوفييتي يفقد قدرته على احتكار مصادر القوة والمعنى بالشكل والسلوك الأمبريالي المتوحش الذي تقوده واشنطن، فالعالم يتجه ببطءٍ ملحوظٍ نحو تعددية الأقطاب، حيث تتراجع مكانة المركز الغربي التاريخي لصالح قوى صاعدة، تتقدم في طليعتها الصين. يتقاطع هذا الفهم مع ما طرحه عالم السياسة الأميريكي البارز صموئيل هنتنغتون في كتابه المعروف صدام الحضارات، حيث ذهب إلى أنّ الصراعات المستقبلية لن تُختزل في الأيديولوجيات أو التنافسات الاقتصادية التقليدية، بل ستندلع أساساً بين كتل حضارية متمايزة تحمل رؤى مختلفة حول الإنسان والهوية والدولة والسلطة، فالحضارات –وفقاً لهنتنغتون– باتت تشكل الفاعل الأعمق في الجغرافيا السياسية للعالم المعاصر، لما تمتلكه من قدرة على تعبئة الشعوب وإعادة صياغة التحالفات والخصومات الدولية”.
في هذا الإطار، يرى هنتنغتون أنّ الحضارة الكونفوشيوسية التي تمثل الصين قلبها وحاضنها التاريخي والفلسفي، تقف على أعتاب لعب دورٍ مركزي مؤسس في إعادة تشكيل نظام دولي جديد يبتعد عن المركزية الغربية، ويقترب من نموذج تعددية حضارية تتوزع فيها القوة العالمية على خمس حضاراتٍ كبرى مرشّحة لأن تكون القوى المحركة للقرن الحادي والعشرين، فالصين تمتلك –بحسب هذا المنظور– مقومات تؤهلها لقيادة كتلة حضارية صاعدة بفضل مواردها الاقتصادية الهائلة، وترسانتها البشرية الضخمة، وتراكمها المعرفي والتكنولوجي المتسارع، إلى جانب قدرتها على توظيف تراثها الفلسفي العريق، وعلى رأسه الكونفوشيوسية، كأداةٍ لإنتاج سردية بديلة للنموذج الغربي الليبرالي.

نظرية تصادم الحضارات:
وُلدت أطروحة صموئيل هنتنغتون في لحظة تحوّلٍ حادٍ و«فراغٍ إستراتيجي» أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية الموالية له مطلع التسعينيات، حين وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام عالمٍ بلا قطب أو خصمٍ منافس، إلا أنها تفتقر إلى نموذجٍ تفسيري واضح لإدارة وقيادة النظام الدولي الجديد، إذ قدّم هنتنغتون أطروحة تؤكد أنّ انتهاء التناقضات الإيديولوجية لا يعني بالضرورة أفول وفوات مفهوم الصراع، بل يؤدي إلى كشف خطوط التماس والإشتباك الحضاري التي كانت مغطاة لعقودٍ باستقطابات الحرب الباردة الإيديولوجية بين اليمين واليسار رأسمالية أم إشتراكية.
بهذا المعنى، لم تكن نظرية «صدام الحضارات» مجرّد قراءة ثقافية لطبيعة الصراع الدولي، بل محاولة واعية لتقديم نموذج إرشادي جديد يوجّه الإدراك السياسي الأميريكي ورؤيته للعالم بعد إنهيار جدار برلين، عبر تحديد «الآخر» البديل الذي يجب الاستعداد لمواجهته مع إنهيار الإمبراطورية البلشفية.
اعتبر هنتنغتون أنّ الانقسام العالمي القادم لن يُبنى على الاقتصاد أو السياسة فقط، بل على اختلافات حضارية عميقة تتجذّر في أعماق التاريخ والدين والهوية والثقافة، مما يضفي عليها طابعاً أكثر شمولية واستمرارية، وعموماً إن القراءات التي تستند إلى نموذج صدام الحضارات من عند ((إشبنغلر حتى فوكوياما وهنتنغتون)) كلها نظريات تعيد إنتاج النسق الإيديولوجي المعرفي ذاته، بحمولاته الهرمية التي تُقصي عن عمد مساهمات الحضارات غير الغربية، وتفترض ضمنياً ومن دون تصريح بتفوق الغرب باعتباره نقطة الانطلاق وغاية ومنتهى التطور البشري، فبذلك يتحول التمايز الحضاري في هذه النظريات من مصدر للتنوع والإثراء الثقافي والفلسفي، إلى أداة معرفية تنظر لإدامة منطق الصراع، نظرية صدام الحضارات تدفع حضارات كالصين إلى لعب دور «الخصم الطبيعي والعدو الجديد» بدل الاعتراف بها شريكاً في صياغة مستقبل أكثر تعددية وتوازناً لذلك فإن العودة لمفهوم صراع الحضارات يُعيد إنتاج بنية فرز ثقافي خطيرة، تلبّس الصراعات والخصومات الجيوسياسية لبوساً حضارياً.
هذه النظرية التي يحيكها صامويل هنتغتون، تُحوّل البشر إلى قطع شطرنج ثقافيّة، تُصنّفهم في صناديق مغلقة بحسب انتماءاتهم الحضاريّة المزعومة. وكأنّ الإنسان لا يحمل في داخله عوالم متعددة، بل هو مجرد رقم في معادلة صراع أبدي.
هذا التقسيم المصطنع لا يكتفي برسم حدود بين “نحن” و”هم”، بل يخلق عداوةً متخيّلةً تتحوّل مع الوقت إلى واقعٍ ملموس. وكما يحدث عندما نضع كائنات حيّة في أقفاص منفصلة، تبدأ العداوة بالظهور، وتتحوّل الاختلافات إلى أسباب للصراع بدلاً من أن تكون مصادر للإثراء.
الأخطر من ذلك هو كيف تُصادر هذه النظريّة حقّ الإنسان في اختيار مصيره. إنها تتعامل مع الشعوب كقاصرين لا يدركون مصلحتهم، فيحتاجون إلى أوصياء يتحدّثون باسمهم – سواء كانوا سياسيين أو رجال دين أو خبراء – أولئك الذين يضعون أنفسهم حرّاساً على أبواب الفكر والاختيار.
هؤلاء الأوصياء، بتعبير كانط، يصبحون سدنةً لصناديقنا الحضاريّة، يقدّمون لنا الوصفات الجاهزة، ويحجبون عنّا أفق الاحتمالات الأخرى. هم يضمنون بهذا استمرار هيمنتهم، ويحافظون على فجوة المعرفة والامتياز التي تبقيهم في الأعلى، ونحن في الأسفل.

رأي أنطونيو نيغري عن الإمبراطورية:
إنه نظام خفيّ يبدو كأنه وصفة للتفاهم، بينما هو في الحقيقة تأبيد للتبعيّة وإلغاءٌ صامتٌ لإرادة الإنسان في أن يكون سيد اختياراته، لا رهينةً لانتماءٍ فرض عليه.
“لقد أصبحت الحرب الآن نظاماً للعالم، وليست حدثاً استثنائياً؛ إنها وظيفة من وظائف السلام الإمبراطوري نفسه”.
مايكل هارت وأنطونيو نيغري، الإمبراطورية، ترجمة فاضل جتكر، ص 23
يرى نيغري وهارت أن الحروب في العصر الإمبراطوري وهو اصطلاح أحدث لوصف الإمبريالية بصيغتها المعولمة لم تعد حروباً على شاكلة القرن العشرين بين دول قومية متنافسة، بل أصبحت جزءاً وتحوّلت إلى آلياتٍ دائمةٍ لحفظ نظام عالمي غير مستقر أساساً، بتبسيط مكثف : نظامٍ حوكمة يشارك فيه الجميع بدرجات متفاوتة، بحكم التطور الرأسمالي المعولم الذي جعل كل الأطراف مراكز و هوامش جزءاً من المنظومة”الإمبراطورية ” ذاتها. في هذه المنظومة، الحرب لم تعد استثناءً ناتج عن عجز السياسة، بل صارت قاعدة دائمة — لكنها تغيّرت وأبدلت في شكلها وأدواتها.وانتقلت فيه من ميادين الوغى وساحات الاقتتال وخنادق المعارك إلى كل مجالات عالمنا وتفاصيل حياتنا حتى اليومي منها عبر منظومة معقدة من الاقتصاد والإعلام والتكنولوجيا والسياسات القانونية التي تنظم تدفق البشر، ورأس المال، والمعلومات، والرغبات وحتى الإرهاب، انتقلت الحرب من الخنادق إلى الأسواق، ومن الميادين إلى الشاشات، ومن الجبهات إلى الخوارزميات.
في هذا الأفق العولمي الجديد، لم تعد السيطرة أو الهيمنة تُمارس من برج عسكري أو عاصمة كولنيالية أو غرف إستخباراتية مظلمة، بل من خلال شبكات أفقية عامودية شديدة الترابط كخيوط عقدية وشبكات رقمية ومؤسسات وهياكل اقتصادية ومفاهيم قانونية أخلاقية تصوغ حدود الممكن والممنوع في العالم، إذاً حين يقول هارت ونيغري إن الإمبراطورية «تحكم باسم السلام والإنسانية«، فهما من المؤكد لا يمدحانها بل بكل نقدية يهزئان من هذا القناع الأخلاقي الذي يغطي حقيقتها ولايسترها بالضرورة.
فهي تستخدم لغةالشرائع والأخلاق لتفرض قبل أن تشرعن هيمنتها، وتقدّم نفسها ك«قوة خير» مطلقة بينما تُعيد إنتاج التبعية الاقتصادية والثقافية والسياسية. ولكن إنّها سلطة لا تعتمد على الغزو، بل معادلات الدمج والامتصاص وما يتطلبانه من تدرج، وقضمٍ بطيئ؛ لا تحتاج إمبراطورية العولمة الجديدة هذه إلى فيالق عسكرية دائمة على الأرض أو أساطيل في البحار، لأن حيوية رأس المال وسلطة الإعلام ونفاذ القانون وإلزامية التقنية صارت أدواتها الفعلية النافذة في الحكم.
وهي، بخلاف الإمبراطوريات القديمة كروما أو بريطانيا هنالك تقطعات زمانية تفصل بين الحرب والسلم لا إمبراطورية اليوم لامركزية سائلة تعيش في زمنٍ واحد متواصل لا فاصل فيه بين الحرب والسلم إنما تداوم تبادلي عيش في زمنٍ واحدٍ متواصلٍ لا انفصال فيه بين العنف والنظام، حيث يتحوّل السلام ذاته إلى شكل من أشكال الحرب.
في المشهد العالمي الذي يتشكّل أمام ناظرينا، تُطلّ علينا ظاهرةٌ لم تعد خافيةً عن أعين المراقبين، يسمّيها البعض “إمبراطورية العولمة الجديدة”. فبينما كانت أشكال الهيمنة القديمة تتهاوى واحدةً تلو الأخرى، وكانت الجدران التي أقامها النظام السوفياتي تتداعى أمام زحف السوق العالمي، بدأت تتبلور معالم نظامٍ كونيٍّ مختلف.
لم تكن تلك التحوّلات مجرد تغييرات عابرة، بل كانت ولادةً لواقعٍ جديدٍ تتدفق فيه التبادلات الاقتصادية والثقافية بوتيرةٍ لا تُقاوم، حاملةً معها منطقاً جديداً للحكم، وآلياتٍ غير مسبوقةٍ لإدارة العالم. وفي قلب هذه التحوّلات، برزت سلطةٌ سياديةٌ عابرةٌ للقارات، كيانٌ إمبراطوريٌّ يضطلع بمهمة تنظيم هذا التدفق العالمي الهائل.
لم يكن تراجع نجومية الدولة الوطنية، ولا عجزها المتزايد عن ضبط إيقاع التبادلات العالمية، سوى ندوبٍ على جسد نظامٍ قديمٍ يلفظ أنفاسه الأخيرة. وكما يموت النجم حين يستنفد وقوده، فإن شمس السيادة التقليدية قد أخذت في الغروب، لتُعلن عن ميلاد فجر الإمبراطورية الجديدة.
رغم حضور مفهوم الأمة بوضوح في المخيال السياسي الصيني، إلا أن فكرة “العالم” ككيان متجاوز للحدود، وما يرتبط بها من مفاهيم كالعالمية والنظام الدولي، تظل غائمة المعالم. وعندما يتناول المثقف زهاو تينغ يونغ، وهو من المنظّرين المقربين من النظام، تحليلاً للكاتبين الماركسيين نيغري وهاردت لمفهوم “الإمبراطورية”، نلاحظ تركيزه على الجانب الاقتصادي الرأسمالي في بنيتها، متجاوزاً بذلك الأبعاد الثقافية والأيديولوجية التي أشارا إليها، مثل فكرة العمومية الكونية المستمدة من الثقافة المسيحية الغربية.
في هذا السياق، يرى بعض المحللين أن نموذج “الإمبراطورية الأطلسية” الذي قدّمه نيغري وهاردت، رغم اختلافه الثقافي عن المرجعية الصينية، يتقاطع من حيث المبدأ مع التصور الذي يطرحه زهاو تينغ يونغ لنموذج الحوكمة العالمية. فالصين، في رؤيتها للعلاقات الدولية، تتبنى مفهوم السيادة الوطنية كمبدأ مركزي، وتعتبر أي انتقاد لسياستها الداخلية محاولة خارجية تهدف إلى تقويض وحدة البلاد.

ارتداد على العولمة:
يُمثّل المنعطف الراهن هجوماً صريحاً على نموذج العولمة النيوليبرالي، الذي قام على مبدأ حرية السوق وفتح الأسواق، والذي أصبح العقيدة المسيطرة على الاقتصاد العالمي منذ عقدي الثمانينيات والتسعينيات. لقد تزامن صعود هذا النموذج – الذي دشنه رونالد ريغان ومدرسة شيكاغو – مع انهيار المنافس الاشتراكي وتراجع نموذج دولة الرفاه، مكرساً لسياسات التحرير المالي وخصخصة القطاع العام.
غير أن هذا النموذج بات اليوم أمام اختبار وجودي، تتجلى مظاهره في الحرب التجارية المفتوحة التي تشنها الولايات المتحدة ضد الصين، حيث فُرِضَ خلالها تعريفاتٍ جمركيةٍ باهظةٍ واسعةٍ على السلع الصينية متجاهلةً ما يمكن تسميته بمشيمية العلاقة اقتصادياً مع الصين بالنسبة لاقتصادات أوروبية كبرى أو حتى لصناعات أمريكية بما فيها من سلاسل إنتاج و توريد وتبادل مصرفي وسلعي، إن هذا النكوص لما يصفونه بالسياسات الحمائية هو عملية دفاعية ولو أخذ شكلاً هجومياً تتناقض مع مبادئ التجارة الحرة والليبرالية الاقتصادية التي لطالما روّجت لها الولايات المتحدة نفسها. هكذا يصبح الغرب، في هذا التصور الجديد مرة أخرى، حصناً حضارياً منقسماً على ذاته أكثر منه مشروعاً عالمياً مفتوحاً هذا الارتداد الأمريكي عن مبادئ السوق الحرة هو أحد العوامل الرئيسية التي تدفع بدورها الصين إلى مراجعة علاقتها بالعولمة القائمة والبحث عن نماذج بديلة.”
مع ذلك تظل نظرية صدام الحضارات إلى عولمة نغري نقطتان مهمتان ومحطة تأسيسية لفهم تشكل النظام الدولي الراهن ولاستيعاب خطابه السياسي المبني على تأويل حضاري لما يشرع السياسة وأفعالها، إذ تشكل نظام عمل عقل أيديلوجي مقفل في ((حالة هنتنغتون)) يفسر الكثير من حال عصرنا وظواهره المقلقة حتى لسلوك دول خارج المعسكر الغربي، فروسيا مثلاً أعلنت ضمّ شبه جزيرة القرم عام 2014 انطلاقاً من مبدأ «العالم الروسي» حيث أصبح الانتماء الحضاري في حالة أوكرانيا أكثر أهمية وأسبق من شرائع القانون الدولي، هذا التبرير كشف انتقال موسكو من منطق الجغرافيا السياسية التقليدية إلى خطاب الهوية التاريخية والحضارية العميقة، المستعاد من إرثيها القيصري والسوفياتي معاً وانتهى بحربٍ ماتزال رحاها دائرة، وهذا تأكيد بشكلٍ أو بآخر على هيمنة عقلية الصراع على شكل النزاعات البشرية، وفي السياق ذاته، يشكل صعود ناريندرا مودي في الهند عاملاً حاسماً في إعادة صياغة الهوية الوطنية الهندية على أسس حضارية–ثقافية هندوسية، بدلاً من النموذج التعددي الذي ساد مرحلة ما بعد الاستقلال عن الإنجليز، إذ باتت الهند تقدم نفسها كقوة حضارية تمتلك مشروعاً قيمياً خاصاً ومتعالي حضارياً أعاد حتى تسمية البلاد باسمها الهندوسي القديم.
على هذا الأساس يصبح مفهوماً بشكل أكبر توجّه الصين نحو تبني تصور أكثر وضوحاً عن «الدولة الحضارية»، وهو تصور يحمل طابعاً و نزوعاً تاريخياً ممتداً إلى إرث وروحية الكونفوشيوسية وحكمها العقلانية الجماعية و حاضر الثورة الماوية بما تمثله قيمياً من انضباطٍ والتزامٍ وتقديساً للعمل يضفي شرعية ومقبولية على دور الصين كفاعل مركزي حيوي في تشكيل نظام عالمي بديل وجامع عن الأحادية القطبية قيد الإختمار والتشكل، فهذا المسار لا يمثل مجرد رد فعل خطابي وأيديلوجي على مقولات الصدام والتفوق الحضاري ذات المنشأ الغربي سواء أكانت من أوزفالد أشبنغلر المتشائم والمبشر ببداية التدهور الغربي الملهم والمرجع الفكري أو منظري ومأسطري ومديري صراعات أمثال، برنارد لويس وهنتنجتون وحتى كيسينجر لكون نهضة الصين الحضارية في بدايات القرن الحالي تُكرِّس اكتمالَ يقارب التمام لحلقةٍ تاريخيةٍ انتقلت فيها إمبراطوريةُ الأرض الوسطى ((اسم الصين قديماً)) من احتكاكٍ طفيف حذر غيرِ مبالٍ بقوىً غربيةٍ متناحرة على التجارة الدولية وبسطِ الهيمنة إلى تبنِّي منطقِ المنافسة النزيهة وبسط النفوذ على حساب قِوى الأمس التي أصبحت تُصارع هاجسَ أفولِ نجمها هي الأخرى هذا النهوض الحضاري هو نتاج تراكم تاريخي بما يشتمل عليه من سعة يؤهل الصين بقدراتها وبخصوصيتها، من السعي المشروع لطرح نموذج عالمي موازٍ حالياً وبديل مستقبلاً، لا تابعاً أو مندمجاً ومنخرطاً بالكامل في نظام الأحادية القطبية الذي يحكم واقعنا اليوم .. صعود الصين بهذا الهدوء والاتزان، دون ادعاءٍ أو استعراضٍ قيمي، يُعدّ نقضاً عملياً لكل الهمرجة الاستشراقية التي رأت وقزمت الشرق ومسخته إلى مجرد كيانً منجمد متقادم، فالعالم لم يعد حكراً على سردية حضارة واحدة، بل بات ساحة لتفاعل تعددي تبادلي يكتب فصلاً جديداً في تاريخ الإنسانية.

الاستشراق الصيني , صراع سرديات:
“دعوا الصين نائمة، فعندما تستيقظ ستهزّ العالم”
نابليون بونبارت إمبراطور فرنسا السابق في منفاه
في منفاه البعيد في أقاصي جنوب الأطلسي في جزيرة هيلانة، أطلق الإمبراطور المخلوع نابليون بونابرت، إمبراطور فرنسا السابق، عبارته الشهيرة ورغم أنّ هذه المقولة لا تستند إلى توثيق نصّي أو اقتباس موثق مباشر في سجلات نابليون الرسمية، فإنها تعبّر بعمق عن رؤية استشرافية واستشراقية في آن ولكن استشرافها إن “صحت” فهو مبكر ويحمل نوع من النبوءة وهي ليست بمستغربة عن بونبارت كسياسي وجنرال محنك مهووس بالمطالعة التاريخية ومن واضعي أبجديات الجيوسياسية بشكلها الحداثي أن الصين بوصفها قوة كبرى كامنة في سبات نوم مؤقت، لكن المقولة على ما فيها من تبصر تحمل أيضاً نظرة استشراقية “وهذا ليس بغريب عن قائد الحملة الفرنسية على مصر” فنبرة الإمبراطور المعزول متوجّسة وتحذيرية، وهي مفتاحية جداً في ما نحاول أن نناقشه في أن الشرق المختزل دوماُ في المخيلة والعقلية الغربية هو ما بين خصوبة الخيال و هلع الكوابيس في حيز لا واقعي بالتعبير الفرويدي من اللاوعي الجمعي الغربي في نظرته لأي آخر، فهو يحيلنا إلى تمثيل رمزي عميق يعكس البنية الذهنية للاستشراق في بواكيره وفي حاضره حتى وهذا ماسيكون موضوع هذا الفصل، من حيث يُعاد دوماٌ إنتاج الشرق و ال«آخر» الغامض، الذي لايمكن التنبؤ به وهو بالضرورة في مرحلة ثبات أو نيام حضاري، إذ يحتاج الرجل الأبيض إلى مراقبته وتقييد حركته وشله خشية أن يخرج عن “إطاره الطبيعي المتخلف” في منظومة مصابة بداء التفوق ورهاب السيطرة وجشع التوسع تُجسّد التجربة الصينية اليوم أزمة فصامية الطابع في الخطاب الغربي ذات نفسه، هذا الغرب الذي لطالما صاغ الشرق في شتى الصورِ النمطية بمبتذلها وغثها فمن عناوين ك“الاستبداد الشرقي والخطر الأصفر إلى الفيروس الصيني “ كلها أسماء سرديات رغم ضحالتها وهزالتها فما بالكم بموضعيتها اليوم، ميكانيزماتها وسياقاتها الدفاعية التي تحاول التخفيف من وطأة التحول التاريخي الحاصل شرقاً بقيادة الصين المستيقظة، إذ لابد من تفكيك هذه السرديات وتحليل نظم عملها، لذلك كان لابد أن نضع اقتباساً لانثق بمصداقيته لأنه في الحقيقة يوضح بشدة كيفية عمل الصور النمطية.
يُعَدّ الخطاب الاستشراقي، منذ تبلوره الكلاسيكي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، أحد أبرز الأدوات المعرفية السلطوية التي استخدمها الغرب في إنتاج تمثّلاتٍ رمزية وثقافية عن “الآخر”، وتحديد موقعه في نسقٍ عالمي غير متكافئ مازالت مفاعيله قائمة لحد اليوم. ومع تحولات النظام الدولي المعاصر وقيام الصين، لم يتراجع هذا الخطاب بقدر ما أعاد إنتاج ذاته في صيغٍ جديدة تتّسم بمرونة أيديولوجية وتكيّفٍ مع منطق العولمة والإعلام الرقمي بكل مافيهما من غزارة وتعقيد وتشوش. لقد انتقل “الاستشراق” من كونه منظومة فكرية كلاسيكية تُعنى بوصف الشرق ثقافياً إلى كونه أداةٍ ناعمة من أدوات الحرب بخشنها وناعمها بما فيها من صراع سردياتٍ والتنافس اللاهب وتناحرٍ جيوسياسي حتى، يُمكن الحديث عن الاستشراق المعاصر والمحدث بوصفه شكلاً من أشكال الصراع الرمزي بين المركز الغربي المهيمن والقوى الصاعدة، حيث يتم عبره وبواسطته إنتاج القيم و الصور النمطية وإعادة تدويرها لتكريس اختلال ميزان الخطاب والمعرفة وبما يتحتم منه إلى حيثيات تمس وتتلاعب بقضايا حساسة ((المشروعية والسيادة )).

الاستشراق المعاصر ضد الصين: امتدادٌ لإرثٍ فكري غربي متجذّر:
يبدو واضحاً أن الاستشراق المعاصر في مقاربته للصين ليس انقطاعاً عن الماضي بقدر ما هو استمراريةٌ وتحولٌ في الشكل والوسائل. فالمخاوف التي عبّر عنها نابليون في مقولته الشهيرة خلال منفاه في سانت هيلانة ليست سوى التعبير الأولي عن وعيٍ غربيٍّ جمعي يرى في الشرق — وفي الصين خصوصاً — قوةً كامنةً تهدد “نظام العالم الأوروبي”. وقد تطور هذا الوعي لاحقاً في كتابات الفلاسفة والمفكرين الغربيين ليأخذ طابعاً فلسفياً وسياسياً مؤسساً.
ففريدريش هيغل (1770–1831)، في محاضراته حول فلسفة التاريخ، يذهب إلى أن:
«التاريخ العالمي يسير من الشرق إلى الغرب، لأن أوروبا هي نهاية التاريخ الحقيقي، والشرق لم يعرف الحرية إلا للحاكم وحده».
هذا القول الذي يجعل من الشرق — والصين في مقدمته — فضاءً خارج التاريخ الفعلي، رسّخ في الوعي الغربي فكرة “الجمود الآسيوي” و“الاستبداد الشرقي”، وهي أفكار أعاد إنتاجها لاحقاً مفكرون آخرون أمثال مونتسكيو في روح القوانين عندما وصف الصين بأنها:
«دولة تُدار بالخوف والطاعة، لا بالعقل والحرية».
هذه التصورات — رغم مرور قرونٍ عليها — تُستعاد اليوم، بشكلٍ مموّه، في الخطاب الإعلامي والسياسي الغربي عن الصين المعاصرة. فالسرديات الغربية الحديثة، التي تتحدث عن “الخطر الصيني” و“التنين القادم من الشرق”، ليست سوى تحديثٍ بلاغيٍّ لمقولاتٍ قديمة تضع الشرق دائماً في موقع النقيض للحضارة الغربية، وتجعل من نهضته مصدر قلقٍ وجودي للمركز الإمبريالي.
وفي هذا السياق، يلاحظ الباحث الأمريكي إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق (1978) أن:
«الاستشراق لم يكن يوماً خطاباً بريئاً أو علمياً خالصاً، بل ممارسة سلطوية تهدف إلى معرفة الشرق من أجل السيطرة عليه».
هذا التعريف الكلاسيكي للاستشراق يجد امتداده المعاصر في الطريقة التي يُقدَّم بها الصعود الصيني في وسائل الإعلام الغربية: فبدل النظر إليه كتحول طبيعي في النظام الدولي، يُعاد تصويره ك«تهديد للنظام الليبرالي العالمي» و«نموذج سلطوي مضاد للديمقراطية».
وتشير الأكاديمية الصينية-الأمريكية شومي شيه (Shu-mei Shih) إلى هذه الظاهرة بدقة في دراستها حول “الاستشراق الآسيوي”، قائلةً:
«إن الخطاب الغربي الحديث يعيد إنتاج مركزية أوروبا عبر نزع الشرعية الحضارية عن أي مسارٍ تنموي مستقل تسلكه الصين أو غيرها من القوى الآسيوية».
بذلك يغدو الاستشراق المعاصر ضد الصين أداة ناعمة من أدوات الصراع الرمزي يندرج صمن صراع السرديات والحرب الناعمة، تندمج فيها القوة المعرفية والإعلامية لتشكيل الرأي العام العالمي ضمن رؤيةٍ أحادية للحداثة تُقصي كل من يحاول إعادة تعريفها من خارج المنظومة الغربية. فالخطر، في جوهر هذا الخطاب، ليس صعود الصين الاقتصادي فحسب، بل إمكانية أن تقدّم نموذجاً حضارياً مغايراً يهدد احتكار الغرب لشرعية “الحداثة” ذاتها.
فالاستشراق لكونه نظاماً من الصور والتمثلات، وبما يمثله من آليات إنتاج خطابٍ وفعلٍ تواصلي صادر من مراكز قوى معادية ومنافسة للصين بصورٍ نمطية لا واقعية يغلب عليها الطابع الإنشائي الرديء، وعناوين عريضة ك ((الصين مصنع العالم … والتنين القادم من الشرق)) وغيرها من الكليشيهات التي تفرغ مفردة ((معجزة)) من معناها والتي أصبحت تشكل فهماً جمعياً مغلوطاً، فحتى معجزة الصين المعاصرة لها سياقها التاريخي وهي نتاج لكفاحٍ طويل ومرير، وهذا جوهر المشكلة، فالقصور في هذا الخطاب المهيمن للأسف والدارج والقائم على مغالطات منطقية مازال له مريديه ومستهلكي دعايته التي تروج لكليشيهات على شاكلة ((الصين مجرد معمل عملاق غزير الإنتاج الكمي دون نوعية وأنه نهضة وفورة وفقاعة اقتصادية ستزول بالسرعة التي نهضت بها)) مؤقتة مجردة ومنفصلة عن نتاج ثقافي وحضاري، هذا الاختزال الدعائي مرده يرجع للإفتقار للحس التاريخي والنقدي في تحليل التجربة الصينية والاكتفاء الاستهلاكي بما تصدره الصناعة الثقافية الغربية بكل مؤسساتها العملاقة ونظمها الفوقية، حسب مفهوم الفيلسوف الإيطالي “أنطونيو غرامشي ” فإن هذه النظم تحول الثقافة إلى أداة للهيمنة والسيطرة إذ يتم تصنيعها وتوزيعها بدقة مثل أي منتجٍ مصنع مسبقاً، فهذه السرديات الغربية عن الصين وأي منافس محتمل آخر تُقدَّم كمعرفة بديهية ومنطقية، لكي تصوغ المخيال الجمعي لعدد غير محدود من الجماعات والأفراد، إذ يرى غرامشي أن البنية الفوقية (الإعلام، التعليم، الثقافة) تمتلك دوراً أساسياً في استمرار خطاب الهيمنة للنظام الذي ينتجها؛ إذ تصوغ رؤية للعالم تبدو “طبيعية” ومحايدة وعقلانية حتى أن الجمهور يتبناها و يعيد إنتاجها وهو يعتقد أنه مستقل ومتفرد في حكمه.
تخوض وسائل الهيمنة الغربية منذ أكثر من عقد حرباً ثقافية ناعمة ومكثّفة ضد الصين، تستدعي خلالها صوراً نمطية قديمة متجذّرة في الذاكرة الاستعمارية والمخيلة الغربية الخصبة عنصرياٌ حتى عند أعتى الفلاسفة الأوربيين مثل فرديريتش هيغل (1770 – 1831)، فيلسوف العقل والمثالية، والذي يرى أن الحكم الاستبدادي هو “نظام الحكم الطبيعي” للشرق بكل تعقيداته الذي يقوم على أساسٍ أبويٍّ بطريركي، حيث يقوم النظام الشرقي ” المفترض”، في تصوره على تعميم قطعي، على خضوع الفرد الشرقي المطلق للسلطة العليا، التي في معظم الأوقات تتجسّد في شخص الحاكم أو “الأب الأكبر” للأمة، فلا وجود لمفهوم الحرية بمعناه التنويري ولا وجود لمفهوم الفردية الإبداعية كما في الغرب المتحضر، بل تُختزل الحرية وتحصرها في شخص الحاكم وحده. إن النظرة البطرياريكية المشرقية هي نظرة إقصائية للذات وفاعليتها وخصوصيتها، إذ تجعل من الأب محور كل شيء ومن الأبناء لا شيء، كما تجعل العلاقة بينهم واجباً أخلاقياٌ يستند إلى معايير الطاعة والولاء, يمكن ربط هذه السردية في التكرار المستمر لوسائل الإعلام الغربية عن محاولة ممنهجة لتشويه صورة الرئيس الصيني الحالي السيد شي جين بينغ وصعوده لموقع القيادة في الحزب والمجتمع كتثبيت نمطي لدور الأب الشرقي وإصباغ الألقاب عليه لتميطه بقالب الحاكم الأشبه بالإمبراطور المعاصر هو المركز الذي يدور حوله كل شيء، ويعود إليه كل شيء، في تعامي واضح على أبسط قيم العقلانية و الموضوعية التي تُظهر أنّ هذه السرديات في استخداماتها المعاصرة ضد بكين تصبح أقرب إلى سردية ورؤية سياسية -دعائية ممنهجة الإعلام يعمل هنا بوصفه «آلة أيديولوجية» (بتعبير لويس ألتوسير فيلسوف فرنسي)، تسهم في تفكيك وصناعة وتركيب الهويات الجماعية، وتوجيه الرأي العام العالمي وفق مصالح رأس المال المعولم. على العموم تتّسق هذه الرؤية المزيفة مع السردية العنصرية الكلاسيكية للرجل الأبيض عن أقوام أخرى كالأفارقة أو العرب أو السلاف، فالصين التي صُوّرت في الفكر الأوروبي منذ عصر النهضة وحتى القرن التاسع عشر بوصفها مثالاً ل “الاستبداد الشرقي” المفترض . فقد اعتبرها فلاسفة غربيون، من مونتسكيو وكانط إلى هيغل نفسه، مجتمعاً متخلفاٌ راكداً ثابتاً، منغلقاً على ذاته، يخضع لنظام بيروقراطي صارم يقتل روح الإبداع الفردية على حساب قدسية الجماعة. كانت الصين، في هذه السردية “حضارة بلا تاريخ”- “حضارة متكلسة”، أي إنها بلغت ذروة العظمة والاستقرار سابقاً، ثم توقفت وتقهقرت عن ركب التطور الحضاري لأنها تفتقر إلى “الروح الحرّة” التي – في نظر هيغل هي الميزة العليا –التي ميّزت أوروبا الحديثة المتنورة، هذا الخطاب التأسيسي شكّل، تاريخياً، نسقاً معرفياً قوياً ونافذاً، استطاع أن يفرض نفسه بوصفه الإطار المرجعي غير المحايد للفكر الإنساني الحديث اتجاه الآخر الشرقي … فالصين حتى أيامنا هذه مع الدعاية الناعمة ضدها في قلب حرب دعائية غارقة وبل متشبعة بالنظريات التي تميّز بين «الشرقي/الآسيوي» “العبد” أو«الغربي» “السيد” وتُحوّل هذه الفوارق إلى مقولاتٍ جوهرية ثابتة تحمل في طياتها عناصر عنصرية وتمويهات معرفية ضلالية مع حتمية مطلقة غير قابلة وخاضعة لشروط التغيير والتبدل.
“الخطر الأصفر”:
هذا المصطلح العنصري الذي اشتهر وانتشر في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، والذي قدّم شعوب شرق آسيا، ولا سيما اليابان الإمبراطورية ثم الصين، كتهديد حضاري وعنصري للغرب الأبيض، ورغم أنّ النبرة الاستشراقية المباشرة تراجعت في الخطاب المعاصر، إلا أنه لا يقل دعائية وإن خفت فجاجة وعنصرية طرحه، كالعادة فإن الهيمنة الغربية تحول التنافس الجيوسياسي مع الصين إلى صراع سرديات أخلاقي، يُرسم فيه الغرب بصورة البطل الحامي للقيم الكونية بينما تُصوَّر الصين كقوة خبيثة واستبدادية تعمل في الظل وتتربص بالنظام الدولي ((كما حدث خلال أزمة فيروس كورونا))، إذ يحمل هذا التمثيل بعداً دعائياً واضحاً يقوم على ثنائية أخلاقية مبسّطة وهزيلة: غربٌ فاضل يسعى إلى الخير المشترك وصينٌ مُريبة تسعى إلى الهيمنة، صراع السرديات هذا يبرهن على تُحوِّل الثقافة إلى سلاح و أداةٍ للهيمنة الرمزية، وتُخضِع الوعي الجمعي لمجتمعات بأكملها لفكرة السردية الكبرى عن “مركزية غربية” لا تُناقش، فإن السرديات، في جوهرها، استمرار إرث استشراقي قديم يتخفّى خلف لغة “حماية القيم” و”الدفاع عن النظام الدولي”، بينما يعمل عملياً على إدامة الامتياز و التفوق الغربي حسب قول الأكاديمية شومي شيه الأمريكية الصينية المختصة بتاريخ ونقد الإستشراق الآسيوي “إن هذه الاستراتيجية الخطابية تُعيد إنتاج مركزية الغرب عبر نزع الشرعية الحضارية عن أي مسار تنموي مستقل تسلكه الصين”.
لا تقتصر هذه التعميمات المختزَلة الموجهة. وإنما تكتسب مرونتها “الروائية كسردية” مما تضمّنته من قابليّة الاستعادة وإعادة التوظيف مع تبدل المنافس، كلما تطلبت الظروف السياسية هذا الضرب من التلاعب الدعائي أو كما يسميه بدقة الفيلسوف الأمريكي نوام تشومسكي ((نموذج الدعاية))، أكثر النماذج تأثيراً في تحليل بنية الإعلام داخل المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. يخالف هذا النموذج التصور الليبرالي السائد الذي يرى في وسائل الإعلام كسلطةً رابعة.
إن الإعلام الغربي في واقع الحال ليس سلطةً خارج النظام، بل هو جزءٌ بنيوي يؤدي وظيفة أساسية تتمثل في تبرير السياسات الرسمية، فالإعلام في نظر تشومسكي والإعلام كبنية سلطوية لا يعمل في الفراغ، بل ضمن منظومة سوقية مؤسسية تُنتج هرمياً ما يمكن تسميته ب«التوافق المصنَّع» بين الجماهير والنخب الحاكمة لتثبيت الإيديولوجيا السائدة التي تعمل كإطار عام لتصنيف وتلفيق الأخبار والأحداث (مثل معاداة الشيوعية سابقاً أو الحرب على الإرهاب لاحقاً)) نموذج الدعاية يزداد ويتّسع تأثيره، وأحياناً يوظف لنزع “شرعية”، أو فرضها، أو بناء “مشروعية” أو حجبها، من خلال قلب الحقائق وخلط السرديات وتحويل نقاط القوّة إلى نقاط ضعف، أدرك القادة السياسيون والفلاسفة منذ زمن بعيد أن للأفكار قوة تتجاوز حدود القوة الصلبة كالسلاح والاقتصاد، وأن التحكم في الخطاب العام وتأطير النقاش السياسي يمكن أن يعيد تشكيل وعي الجماهير وبالتالي توجيه اختياراتها. وفي هذا الإطار يغدو مفهوم القوة الناعمة ك نموذج دعائي صرف، لا تقل أهميته عن القوة الصلبة في تحقيق النفوذ والتأثير. فحين تنجح دعاية دولة ما في جعل سلطتها تبدو شرعية ومقبولة في نظر الآخرين، تقلّ المقاومة لتوجهاتها، وحين تصبح ثقافتها وأيديولوجيتها جذابتين، يتبعها الآخرون طوعاً دون حاجة إلى الإكراه في فرض هذه التابعية فسرديات ك ((الخطر الصيني والهيمنة الصينية والإمبريالية الماوية …)) حملة دعائية فاعلة في الصراع الجيوسياسي الراهن، تُستخدم لتبرير التحالفات العسكرية، وفرض القيود التجارية، واحتواء النفوذ الصيني المتصاعد، كل ذلك تحت غطاء من الخطاب القيمي والأخلاقي الذي يوظف القوة الناعمة لتغطية أهداف القوة الصلبة هذا التصعيد الدعائي الخطابي لا يعكس قراءة واقعية للسياسات الخارجية لتلك الدول، بقدر ما يجسّد استمرار الذهنية الإمبريالية الغربية التي تنظر إلى العالم من منظور ثنائي حاد: “من معنا” و”من ضدنا”. حالة من التوتر الأيديولوجي والتهويل السياسي ب”حماسة صليبية” جديدة، تستعيد الروح التبشيرية القديمة في ثوب حديث معاصر

استراتيجية السيطرة: رؤية بريجنسكي للهيمنة الأمريكية:
من بين مخططي السياسة الأمريكية، برز زبيغنيو بريجنسكي كأحد أكثر العقول جرأة ووضوحاً في رسم ملامح الهيمنة العالمية. لم يكن مجرد مستشار عابر، بل كان غارقاً في عمق أجهزة التخطيط الإمبراطوري، متمرساً في خباياها أكثر من معظم معاصريه.
تجلت رؤيته العمليّة مبكراً في دعمه الحاسم لما يُعرف ب “المجاهدين” خلال “عملية الإعصار”، التي شكّلت الدرع المضاد للاتحاد السوفييتي. لم تكن تلك العملية مجرد مناورة تكتيكية عابرة، بل كانت لحظة تأسيسية نسجت فيها المخابرات الأمريكية علاقتها المعقدة والمستدامة مع حركات التطرف الإسلامي. هذا التدخل لم يكشف فقط عن عمق اهتمام بريجنسكي بقلب آسيا الوسطى وجنوبها، بل أكّد على الموقع الجيوسياسي الاستثنائي لهذا الإقليم في حسابات الإمبراطورية.
وفي كتابه الاستشرافي “رقعة الشطرنج الكبرى”، خلّف بريجنسكي وثيقته الأكثر صراحة. لقد حدّد المهمة الجوهرية للولايات المتحدة دون مواربة: أن تظل الحاكم السياسي الأوحد للمساحة الأوراسية الشاسعة. الهدف كان واضحاً: منع أي قوة منافسة من البروز يمكن أن تهدد الهيمنة الأمريكية بمختلف أشكالها. ففي نظره، هذه الأرض – موطن الكثافات السكانية الهائلة والثروات الطبيعية والحراك الاقتصادي – هي “رقعة الشطرنج” المصيرية التي سيتقرر عليها بقاء التفوق الأمريكي أو زواله في العقود القادمة. كانت هذه هي اللعبة الكبرى، وكان بريجنسكي أحد أبرز لاعبيها.
في المقابل كانت الصين تدرك أن فرض الهيمنة على شعوبٍ أخرى مغامرةٌ مُكلفة، قد تجرّ الصين إلى صراعات لا نهاية لها، إذ يسارع الزعماء المحليّون إلى استدعاء «التنين العظيم» في نزاعاتهم الداخلية، فيضيع الجيش الإمبراطوري بين طموحاتٍ ليست طموحه، ومعارك لا تُشبه رسالته التاريخية. وهكذا رأت القيادة الصينية أن القوة ينبغي أن تُكرَّس لحفظ الانسجام الداخلي، لا لتغذية فوضى العالم الخارجي، أمّا اليوم فالأمر مختلف تماماً …تلخصها الحكمة الصينية القائلة :
«إن على المرء إدراك ثلاث مسائل: ماذا يملك، وماذا يريد، وعن ماذا سيتخلّى؟»
وكلياً لذلك نرى أن بكين تمتلك علاقات تجارية مع جميع دول العالم بلا أي استثناء، وتحافظ على حضور عسكري واقتصادي وبشري في القارة الأفريقية، ونفوذ اقتصادي واسع في أميركا الجنوبية، إلى جانب علاقاتها الراسخة مع دول القارة الآسيوية، وتأثيرها التجاري الحاسم حتى في الأسواق الأوروبية وصولاً لتقديمها القروض لواشنطن التي كانت تعدّ لعقود مركز الاقتصاد العالمي ومموله الأساسي.
المشهد الدولي الراهن أن الجيوبوليتيك لا يزال القاعدة الصلبة التي تستند إليها الدول في حماية وصون مصالحها، فمهما اتسعت العولمة أو أنجسرت وتعمّقت الروابط التجارية أو تقلصت، تظل الجغرافيا هي الحكم الأخير و المرجح عندما تُختبر خيارات الدول بين توسيع السوق أو الحفاظ على السيادة هنا المعادلة مهما بدت مرنة وسائلة فأنها بجوهرها تبتغي البقاء الذي يُمثّل الهدف والشرط الأسمى لكل الدول، فهو ليس الغاية الوحيدة بالطبع، لكنه يتقدّم على جميع الغايات في سلّم الأولويات الصينية وحتى الأمريكية، وبشكلٍ مبسط الدولة التي لا تحافظ على وجودها وسيادتها لن تمتلك حتى ترف السعي لتحقيق الرفاه أو نشر النفوذ أو ترسيخ القيم أو حتى التوسع، لذلك يتربّع البقاء كشرطٍ إلزامي متلازم ومكمل للحيز السيادي على عرش الأهداف لأي دولة بالمعنى العصري والحداثي، ويتحوّل إلى نقطة الانطلاق في فهم سلوك الدولة ذات نفسها.
يرتبط هذا التصوّر الصيني من منطلق ثابت بفرضية الدولة كفاعل عقلاني يخطّط لاستمرار وجوده عبر قرارات غائية محسوبة، فعملية صنع القرار لا تأتي اعتباطاً، أو ضرباً من ضروب الارتجال، بل تمر بمراحل تقدير للمخاطر والفرص وقياس الاحتمالات، واختيار الاستراتيجيات التي تعظّم من حظوظ الدولة في البقاء وسط بيئة دولية فتاكة لا ترحم، وهنا يصبح كل تحركٍ وعمل هو بمنزلة فعلٍ جيوسياسي، مهما بدا صغيراً أو ضخماً لكونه جزءاً من معادلة حماية الوجود الكياني للدولة ومن ثم مقتضيات استدامته، لذلك فالسياسة الصينية يتسم سلوكها الخارجي بتجنّب الصدام المباشر، ويفضّل التدرّج الهادئ والبناء من داخل المؤسسات العالمية القائمة مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومن خلال مؤسسات موازية أيضاً كالبنك الآسيوي للاستثمار ومنظمة دول البريكس.
في خضم تحولات النظام الدولي، تعمل القيادة الروسية على استعادة دورها كفاعل محوري في القضايا العالمية، مما دفع الدول الغربية بزعامة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة هذا التوجه القائم على تعزيز الهوية الوطنية الروسية. في هذا الإطار، أولى الرئيس فلاديمير بوتين أولوية استراتيجية للمجال الحيوي الروسي، تجسدت في التدخل العسكري المباشر في الأزمة الأوكرانية التي تمثل في نظره تهديداً مباشراً للأمن القومي الروسي.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل ضم شبه جزيرة القرم ومنطقتي دونباس (لوهانسك ودونيتسك) إلى الأراضي الروسية، وهو ما قوبل برفض غربي شديد اعتبر هذه الخطوات انتهاكاً للسلام الأوروبي وتهديداً للأمن الدولي.
في خضم التوتر المتصاعد بين موسكو والغرب، وإثر الأزمة الأوكرانية التي وسّعت هوة الخلاف، وجدت روسيا نفسها تتجه بقوة شرقاً، متبعة مساراً استراتيجياً جديداً يعزز وجودها في المحيط الهادئ ومنطقة الشرق الأقصى. هذا الانزياح الإقليمي دفعها إلى التقارب من الصين، مما أثار حفيظة واشنطن وحلفائها، لاسيما في ظل التحالف الأمريكي الياباني الذي يشكل حاجزاً أمام هذا التمدد.
لم تمر هذه التحركات مرور الكرام، فقد عبرت الإدارة الأمريكية عن انزعاجها بوضوح من تعميق بكين لعلاقاتها مع موسكو في خضم الصراع. وفي تصريح يحمل تهديداً ضمنياً، حذرت نائبة الرئيس كامالا هاريس من أن أي دعم صيني فتاك للجيش الروسي سيعني مكافأة العدوان واستمرار إراقة الدماء، كما سيهدد النظام الدولي القائم على سيادة القانون والأعراف الدولية. هذا التحذير جاء خلال محادثات وصفت بالصراحة والوضوح بين الدبلوماسيين الأمريكيين ونظرائهم الصينيين، في لحظة تجمدت فيها القنوات بين القوتين العظميين.
وفي سياق متصل، تظهر وثيقة الأمن القومي التي أطلقها الرئيس جو بايدن تحولاً جوهرياً في النظرة الأمريكية، حيث باتت ترى في الصين تحدياً للنظام العالمي يفوق ما تمثله موسكو. ولم تعد واشنطن تتعامل مع احتمال تدخل الصين في تايوان كسيناريو افتراضي، بل كخطر استراتيجي ملموس يهدد استقرار حلفائها في المنطقة، وعلى رأسهم اليابان وكوريا الجنوبية.
على الصعيد الدولي الموازي، تبرز منظمة شنغهاي للتعاون ككيان دولي فاعل في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي والاستقرار السياسي العالمي. هذه المنظمة التي تضم تحت مظلتها أربع قوى نووية ونحو نصف سكان العالم، تشكل حالياً أكبر تجمع إقليمي في العالم، مما يعزز من قدرتها على لعب دور محوري في هندسة النظام الدولي الجديد.
لا تسير منظمة شانغهاي للتعاون على خطى النموذج التقليدي للحلف العسكري، فهي أبعد ما تكون عن أن تكون نسخة مشرقية من حلف الناتو، حتى مع وجود قوى كبرى مثل الصين وروسيا في قلبها. تشبه في روحها تلك المنظمة الأوروبية الشاملة للأمن والتعاون، التي تضم تحت مظلتها دولاً من ثلاث قارات. لكن اللحظة التي انفتحت فيها الأبواب لاستقبال إيران كعضو كامل، حملت في طياتها رسائل أعمق من مجرد توسع عضوية.
كان التوقيت محكياً، كردة فعل متقنة على تشكيل حلف أوكوس الذي يمثل حلقة جديدة في سلسلة السياسات الأمريكية الموجهة ضد الصين. لم تكن هذه الخطوة منعزلة، بل هي حلقة في سلسلة متصلة بدأت قبل ستة أشهر بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وطهران، وكأنما هي خطوات متتابعة على رقعة الشطرنج العالمي، تترابط كقطع متجانسة في مواجهة تحركات إدارة بايدن.
هكذا تتحقق النبوءة التي حذر منها بريجنسكي قبل ربع قرن، حيث تبدأ معادلات القوى العالمية في إعادة ترتيب نفسها، وتتشكل تحالفات جديدة تعيد رسم خريطة التوازنات الدولية، في مشهد يشبه تباشير فجر جديد على العلاقات الدولية.
أما مجموعة بريكس فتمثل محوراً آخر من محاور التحول في هيكل القوة العالمي، حيث تسهم بشكل متزايد في نقل مراكز الثقل الاقتصادي نحو قوى صاعدة، مما يفتح المجال أمام تشكيل نظام اقتصادي دولي متعدد الأقطاب.

منظمة البريكس من مجموعة إلى قوة:
بين طيّات التحوّلات العالمية الكبرى، حيث تتبلور ملامح نظام دولي جديد، تبرز مجموعة “بريكس” كظاهرة استثنائية في مشهد القرن الحادي والعشرين. إنها ليست مجرد تحالف اقتصادي تقليدي، بل تجسيد لإرادة أمم من قارات متباعدة اجتمعت على رغبة واحدة: إعادة رسم خريطة التوازنات العالمية.
في هذا المشهد المتجدّد، تعيد الدول ترتيب أولوياتها ومراجعة تحالفاتها، في خطوة استباقية لرسم مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالها القادمة، وبناء عالم أكثر استقراراً وعدلاً، سعياً لوضع أسس متينة تظلّ صامدة لعقود مقبلة. ومن قلب هذه التحوّلات، تبرز دول البريكس ومنظمة شنغهاي كفاعلين رئيسيين، يخطّون – بتأنٍ وحكمة حدود نظام عالمي مختلف، يختبر متانة البنى القديمة ويتجاوز حدود الجغرافيا التقليدية.
لقد جاءت هذه المجموعة الفريدة ردة فعل على هيمنة القطب الواحد، واستجابة لنداء التغيير الذي أطلقته الأزمة المالية العالمية في 2008. فالدول المنضوية تحت مظلتها، رغم تباين مستويات تطورها، تشترك في رؤية واحدة لضرورة إقامة نظام دولي أكثر توازناً، يحترم قواعد القانون الدولي ويصون كرامة الأمم.
في هذا المشهد المتجدد، تتحول دول “بريكس” من مجرد مراقب للتحولات الدولية إلى فاعل رئيسي في إعادة ترتيب أوضاع النظام العالمي. إنها تقدم نفسها كبديل للنموذج الليبرالي المهيمن، وتسعى لبناء نظام تنافسي عادل، تتساوى فيه فرص الدول النامية مع نظيراتها المتقدمة، وتصان فيه مصالح الجميع دون تفريط أو إفراط.
هكذا تخطو هذه المجموعة، بحكمة وتأنٍ، نحو تشييد صرح عالمي جديد، يكون درعاً واقياً يحمي البشرية من عواصف الأزمات الاقتصادية والمالية، ويضمن مستقبلاً أكثر استقراراً للأجيال القادمة.
وفي خضم التحالفات الدولية التقليدية، تطلّ مجموعة “بريكس” كنسيج فريد لا يشبه أي نسيج سبقه. فهي ليست نبتة من تربة إقليمية واحدة، ولا ثمرة لخلفية سياسية أو ثقافية موحدة، بل هي باقة انتقائية تجمع زهوراً من أربع قارات مختلفة، لكل منها عطرها الخاص وألوانها المتفردة.
تتقاطع هذه الدول على خريطة العالم كما تلتقي أنهار من منابع متباعدة في محيط واحد. فمن بينها العملاق الصناعي والقوى الناشئة، الاقتصادات المتطورة وتلك التي لا تزال تخطو خطواتها الأولى، أنظمة سياسية متنوعة تتراوح بين الديمقراطيات العريقة والنماذج الأخرى. ورغم هذا التباين الواضح في مساراتها ومراحلها التنموية، إلا أنها تجد نفسها تجذف في قارب واحد.
هذه التركيبة الاستثنائية تمنح “بريكس” موقعاً فريداً في المعادلة الدولية – فهي ليست محوراً يدور في فلك قطب معين، ولا تحمل لواء أيديولوجية محددة. إنما تشكل منصة محايدة تجمع أطرافاً متعددة في حوار بناء، تثري من خلاله المشهد العالمي بتنوعها وتعدديتها، مقدمة نموذجاً جديداً للتعاون الدولي يتجاوز الحدود التقليدية والاصطفافات المألوفة.
في مشهد الرقعة الجيوسياسية العالمية تُسهم مجموعة “بريكس” بإيقاع متسارع في دفع نقلة نوعية تتحول فيها مراكز الثقل الاقتصادي من المعاقل التقليدية للدول المتقدمة، نحو أقطاب صاعدة تخطو بثبات على مسرح العلاقات الدولية.
هذا التحول ليس مجرد تبادل للأدوار، بل هو إيذان بمرحلة جديدة تتعاظم فيها الحاجة إلى هندسة نظام اقتصادي عالمي متجدد، يراعي تعددية الأقطاب ويوازن بين القوى الفاعلة. فكما تتنوع ألوان الطيف لتكون ضوءاً واحداً، تبرز “بريكس” كنموذج حي لقدرة الدول الناشئة على تشكيل قطب مؤثر، يعيد رسم ملامح هيكل القوة العالمي الذي ظل لسنوات حكراً على القوى الصناعية العتيقة.
وبهذا، لم تعد هذه المجموعة مجرد تحالف اقتصادي عابر، بل أصبحت رقماً صعباً في معادلة القوى الدولية، تاركة بصمتها كفاعل استراتيجي يتحدى مفهوم الهيمنة الأحادية، ويرسم بإزميل التاريخ صورة عالم أكثر توازناً وتعددية.

القوة الناعمة الصينية: كيف تسوق الصين نفسها للعالم؟:
في مشهد القوة العالمية، تبدو الصين كعملاق اقتصادي ضخم، يحمل في يده اليسرى هدية من الحرير، بينما تبرز عضلاته الصلبة في الساحة الدولية، تحاول أن تقدم للعالم وجهاً آخر أكثر رقة، يحمل عبق التاريخ وترانيم الحكمة القديمة. إنها “القوة الناعمة” التي تعمل بها بكين كفنان يرسم لوحة تزين بها صورتها أمام العالم.
يرى المراقبون أن هذه القوة الناعمة ما تزال الحلقة الأضعف في سلسلة القوة الصينية الشاملة. فهي أشبه بدرع واقٍ، يحاول حماية صورة الصين في رحلتها الصاعدة، بينما يبني جداراً منيعاً في الداخل ضد ما يسمى “الغزو الثقافي” القادم من الغرب. إنها استراتيجية تختلف عن المفهوم التقليدي للقوة الناعمة، حيث تستخدمها الصين كسلاح هادئ لمواجهة ما تسميه “حملة التشويه” الموجهة ضدها.
بدلاً من ذلك، تقدم الصين نفسها كحاملة لشعلة حضارة عريقة، تمد جسور التواصل مع العالم عبر اقتصادها وثقافتها، في حوار هادئ يشبه رقصة التناغم بين الحضارات. إنها تحاول أن تنسج من خيوط ماضيها المجيد صورة لحاضر أكثر جاذبية.
ويبدو أن القادة في بكين يدركون جيداً قوة هذه الاستراتيجية، فالصورة الجميلة قد تفتح الأبواب المغلقة، وتلين المقاومة، وتجعل الآخرين يتبعون الطوعي باختيارهم. وعندما تتمكن ثقافة ما من صياغة المعايير الدولية، فإنها تصنع عالماً يتناغم مع رؤيتها، دون الحاجة إلى تغيير مسارها أو التنازل عن هويتها.
في المسرح العالمي للقوة الناعمة، تتحرك الصين كراقصة بين أنوار المسرح وظلاله. فبينما تتصدر الولايات المتحدة المشهد ببراعة، تخطو الصين خطوات واثقة نحو الأمام، تاركةً أثراً يتزايد وضوحاً عاماً بعد عام.
تشير البوصلات العالمية إلى تقدم ملحوظ في مسيرة القوة الناعمة الصينية، حيث قفزت في سلم التصنيف العالمي لتحتل المرتبة التاسعة والعشرين بين ثلاثين دولة. ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلاً أمامها، إذ تتراءى الفجوة بينها وبين العملاق الأمريكي كوادٍ عميق يحتاج إلى جسور من الوقت والجهد.
لكن اللافت في هذه الخريطة العالمية هو تباين النظرات الموجهة نحو الصين. ففي القارة الأفريقية، تتلقى الصين نظرات إعجاب وترحيب، حيث يرى كثيرون فيها نجمةً تهدي إلى طريق النمو الاقتصادي. هذه النظرة الإيجابية لم تأت من فراغ، فالصين لم تكتف بأن تكون الشريك التجاري الثاني لأفريقيا، بل مدت جسور التعاون عبر مشاريع البنية التحتية التي غيرت وجه الحياة في عدة مجتمعات.
بينما في الجانب الآخر من العالم، في أوروبا والولايات المتحدة، تختلف النظرة تماماً. هناك، تُرى الصين من خلال عدسة المنافسة والريبة، حيث لا تتعدى نسبة النظرة الإيجابية الثلث. إنها نظرة تخلط بين الإعجاب بالنمو الاقتصادي الصيني والقلق من تحول موازين القوى العالمية.
هكذا تظهر الصين في مرآة العالم بوجهين: وجه الصديق والداعم في الجنوب العالمي، ووجه المنافس والتحدي في الشمال العالمي. إنها ثنائية تعكس تعقيد العلاقات الدولية وتنوع أولويات الشعوب، وتكشف أن طريق القوة الناعمة طريق متعرج، تتقاطع فيه المصالح والرؤى كما تتقاطع الخطوط على خريطة العالم.

الصين والقارة السمراء: شراكة تنموية وعلاقات اقتصادية:
في مشهد العالم الذي يتشكل بأقطاب متعددة، تعيد القوى العريقة والصاعدة رسم خريطة نفوذها على المسرح الأفريقي، حاملةً معها رؤاها ووسائل تأثيرها المتنوعة. لم تعد أفريقيا مجرد متلقٍ أو متفرج، بل شريكاً فاعلاً يبحث عن شركاء حقيقيين لتحقيق طموحات تنموته.
على خشبة هذا المسرح، تتراجع تدريجياً الأضواء التي ظلت مسيطرة لعقود، لتحل محلها أضواء جديدة قادمة من الشرق. إنها ليست مجرد تغيير في الإضاءة، بل تحول في الرؤية والنهج. فبينما تقدم القوى الصاعدة وعوداً جديدة، تفتح أفريقيا ذراعيها لشراكات تحترم تطلعاتها وتدعم مسيرتها التنموية.
في هذا المشهد المتغير، تبرز الصين كلاعب رئيسي، تتحرك بحكمة وترويض. بدأ الأمر بخطوات متأنية، ثم تسارعت وتيرتها حتى بلغت ذروتها في مبادرة الحزام والطريق، التي لم تكن مجرد مشروع اقتصادي، بل إعلاناً عن رؤية جديدة للنظام العالمي.
يمكن قراءة هذه الاستراتيجية كسيمفونية ذات ثلاث حركات متكاملة: تبدأ بالداخل لتعزيز مقومات القوة في كل المجالات، ثم تتجه إلى المحيط الإقليمي لبناء تحالفات تواكب التغيرات الجيوسياسية، وأخيراً تنتقل إلى العالم الأوسع حيث تتعانق مع تطلعات الجنوب العالمي.
وفي قلب هذه السيمفونية، تحتل أفريقيا موقعاً مميزاً. فهي ليست مجرد مساحة للتنافس، بل شاهد على تحول تاريخي، وشريك في بناء نظام عالمي أكثر توازناً. إنها علاقة تبادلية تبحث عن صيغة جديدة للتعاون، حيث تلتقي الحاجة بالفرصة، والطموح بالإرادة.
في مسرح القارة الأفريقية، حيث طالما سيطرت الأضواء الأوروبية والفرنسية على خشبة الأحداث، تبدأ الآن أضواء جديدة في السطوع. تتراجع تدريجياً ظلال النفوذ التقليدي لتحل محلها قوى صاعدة من الشرق، تحمل معها رؤى مختلفة ووعوداً جديدة. في هذا التحول الجيوسياسي البطيء والثابت، تبرز روسيا والصين كلاعبتين رئيسيتين تعيدان رسم خريطة التأثير في العمق الأفريقي.
وإذا تأملنا مسيرة التنين الصيني تحديداً، فسنراه يتحول من قوة صامتة في خلفية المشهد العالمي إلى لاعب فاعل ومؤثر، خاصة مع مطلع العقد الأول من الألفية. ثم جاءت “مبادرة الحزام والطريق” لتكون بمثابة الإعلان الرسمي عن طموح لا يخفي نفسه: الصعود إلى قمة هرم القوى العالمية، والمساهمة في تشكيل نظام دولي جديد بملامح مختلفة.
ووفقاً لرؤية الباحثة أليس إكمان من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، يمكننا تتبع ملامح الاستراتيجية الصينية الكبرى عبر ثلاث دوائر متداخلة. تبدأ من الدائرة الداخلية، حيث يعمل النظام على تعزيز مقومات القوة الوطنية في كل المجالات، من الاقتصاد إلى الجيش، مروراً بالتكنولوجيا والابتكار. ثم تنتقل إلى الدائرة الإقليمية والمقاومة، حيث تسعى إلى تحييد الضغوط الأمريكية وإضعاف النفوذ الأوروبي التاريخي والالتفاف حوله. وأخيراً، الدائرة العالمية، حيث تهدف إلى ترسيخ مكانتها كقوة عظمى من خلال بناء تحالفات مع ما يسمى ب “الجنوب العالمي”.
وفي قلب هذه الصورة الاستراتيجية الواسعة، تحتل أفريقيا موقعاً استثنائياً. فهذه القارة بمكوناتها المتنوعة لم تعد مجرد ساحة للتنافس، بل أصبحت شريكاً في رؤية جديدة. من خلال هذه المجموعة غير المتجانسة، تبني الصين دعامة مشتركة تقف في وجه الهيمنة الغربية، بينما تفتح في الوقت نفسه أبواباً واسعة لمصالحها التجارية والتكنولوجية والدبلوماسية، في علاقة تبادلية تحاول أن تنحت مستقبلاً مختلفاً.

الصين وكوريا: كيف تتعامل الصين مع التوتر في شبه الجزيرة الكورية؟:
في مشهد العلاقات بين الصين وكوريا في شرق آسيا، حيث تتداخل خطوط التوتر والتعاون، تُحاك العلاقات بين الصين وكوريا بخيوط من الضبابية والترقب، لكن رغم هذا الجو المشحون، تبقى نيران المواجهة المباشرة خامدة، إذ يتفق الجميع على عدم تجاوز خط اللاعودة.
يصف بعض المراقبين هذا المشهد بأنه “حرب باردة آسيوية”، لكن الواقع ينطق بلغة أخرى؛ إنه “سلام بارد” تسوده حكمة متبادلة. فشبكة المصالح الاقتصادية المتشابكة قد نسجت خيوطاً من الاعتماد المتبادل، تفرض على جميع الأطراف الحفاظ على حد أدنى من التعاون، حتى عندما تتباعد المسافات السياسية بينهم. إنه توازن دقيق، يشبه مشياً على حبل مشدود فوق هاوية الخلافات الاستراتيجية.
فمن منظور سيول، يبدو الصعود الصيني نافذة أمل لا تهديداً مخيفاً، بينما وجدت بكين في جنوب شبه الجزيرة الكورية شريكاً تجارياً يستحق الرهان. لكن هذه اللوحة لا تكتمل إلا بظلال الأطراف الأخرى التي تترك بصماتها على تفاصيل المشهد.
على الحدود الشمالية، تقف كوريا الشمالية كظل طويل يمتد منذ أيام الحرب الكورية، محتفظة بعلاقة الرعاية التقليدية مع الصين رغم كل التحولات. فبكين لم تترك بيونغ يانغ وحيدة في مواجهة العالم، محافظة على هذا التوازن الدقيق بين صداقتها التاريخية للشمال وانفتاحها الاقتصادي على الجنوب.
في مسرح الجغرافيا السياسية حيث تتصاعد الأمواج، لم يعد التحالف بين التنين العملاق والقلعة المحصّصة مجرد تنسيق تكتيكي عابر، بل تحول إلى حجر زاوية في معمار التوازنات العالمي الجديد. هناك، حيث تسعى الصين إلى كسر القيود التي فرضتها أحادية القطب، تجد في جارتها الشمالية صخرة صلبة لا تتزعزع، لا تنحني لرياح الضغوط الدولية. وفي المقابل، ترتمي بيونغ يانغ في أحضان هذا الحليف الاستراتيجي، مستظلة بجناحيه من عواصف العزلة، ومستفيدة من مساحات أوسع للمناورة في لعبة الأمم.
هذا الالتقاء الذي تجسّد على خريطة التحالفات لم ينبت فقط من تربة المصالح المتبادلة، بل نما من قناعة مشتركة بأن العالم يتشوق إلى نظام دولي أكثر تعددية، يزيح عن كاهله تراثاً من الهيمنة الأحادية، ويفسح المجال لأصوات الأمم المستقلة أن تشارك في نحت مصير البشرية.
وفي خضمّ تصاعد الأمواج في المحيطين الهندي والهادئ، وتكاثر التحالفات الغربية، يبدو أن هذا المحور الآسيوي يكتسب دماء جديدة، منطلقاً ليعلن عن ميلاد مرحلة أكثر تعقيداً في ديبلوماسية العالم. مرحلة لم تعد فيها الحدود ترسم خريطة التحالفات وحدها، بل أصبحت الرؤى المشتركة حول مستقبل الكوكب هي البوصلة التي توجّه مسارات الدول.
بل إن هذا التحالف قد يكون النواة الأولى لتحالف قاري أوسع، يضم تحت لوائه عملاقاً مثل روسيا، وربما دولاً أخرى ترفع راية الاستقلال عن النسق الغربي. تحالف من هذا النوع لا يكتفي بإعادة ترتيب الأوراق على الطاولة الدولية، بل قد يقلب الطاولة بأكملها، ليعلن نهاية حقبة السيادة الأحادية، وبداية عصر التعددية القطبية.
وفي الخلفية، تطل الولايات المتحدة كحليف أمني لا يتزعزع بالنسبة لسيول، خاصة حين تعلن كوريا الشمالية عن تجاربها الصاروخية ملوحة بالخطر. ورغم أن واشنطن قد تقدمت خطوة إلى الوراء على المسرح الإقليمي، إلا أن مكانتها في الاستراتيجية الكورية تبقى أشبه بقلعة حصينة، كما هي في نظر طوكيو.
أما اليابان، فهي الطرف الثالث في هذه المعادلة، تشترك مع جارتها الكورية في المظلة الأمنية الأمريكية، وتتقاسم مع خصمها الصيني روابط اقتصادية وثيقة. هذا الموقع المتوسط يجعلها حريصة على ألا تتصدر مواجهة بكين أو تضغطها للتراجع عن دعمها الشمالي، في لعبة دبلوماسية بالغة التعقيد.
هكذا تتداخل الخيوط في نسيج هذه العلاقات، حيث يصبح كل طرف خيطاً في نسيج متعدد الألوان، تتحكم فيه حسابات الجغرافيا وتوازنات القوى ومصالح الاقتصاد، في مشهد شرق آسيوي تتقاطع فيه التحالفات والتنافسات في آن واحد.

الصين والشرق الأوسط: تطوير العلاقات الصينية العربية:
بينما كانت العلاقات الصينية العربية تنسج خيوطها الذهبية في منتصف العقد الأول من الألفية، شهد العقد اللاحق (2005-2015) تحولاً كمياً ونوعياً تجاوز كل التوقعات. لم تكن الأرقام مجرد إحصاءات، بل كانت تعكس قصة صعود شراكة استراتيجية.
ففي مسيرة عشر سنوات، قفزت التبادلات التجارية بين الجانبين قفزة كبرى، متضاعفة تسع مرات متتالية، كالنهر الذي يفيض بغزارة بعد سنوات من الجريان الهادئ. وفي ظل هذه الطفرة، شهدت عقود المشاريع الهندسية والمقاولات التي تنفذها الصين في الدول العربية نمواً مطرداً، بلغ ثلاثة عشر ضعفاً، كاشفاً عن عمق التعاون التقني والإنمائي.
الأكثر لفتاً كان مسار الاستثمارات الصينية المباشرة، الذي سجل وتيرة متسارعة تجاوزت مئة واثنين وعشرين ضعفاً، في مؤشر على الثقة المتزايدة والرغبة في المشاركة العميقة في بناء المستقبل. هذه التحولات الجذرية دفعت بالصين لتصبح الشريك التجاري الثاني للعالم العربي بأكمله، بينما احتلت الصدارة كأكبر شريك تجاري لتسع دول عربية، مما رسم خريطة جديدة للتبادل الاقتصادي تعكس عمق الروابط ومتانة الجسور التي بنيت على أسس المنفعة المتبادلة والرؤية المشتركة.

الصين المعاصرة:
أما التجربة الصينية المعاصرة، فهي تتبلور في أيامنا هذه ضمن ما يمكن وصفه ب«تطور لايخضع البتة لشروط التطور الإمبريالي» وهي صيغة مختلفة جذرياً وجوهرياً عمّا مثّلته اليابان في تجربتها التوسعية في عهد أسرة ميجي (1868–1912)، وهو من أهمّ الفترات التي شهدت تحوّل اليابان من نظام الإقطاعية إلى قوة حداثية مع ما رافقه من عدوان استعماري انتهى بالبلاد لحكم فاشي إمبريالي فهذه الصيغة التطورية تنبع من تاريخٍ طويلٍ من الخضوع للاستعمار الأجنبي، الأوروبي والياباني على السواء، خلال ما يُعرف في الذاكرة الصينية ب((قرن الإذلال ((الممتد من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين، حتى انتصار الثورة.
إذ تركز الصين في صعودها أيضاً على التحديات البنيوية التي تواجهها الثورة الصناعية الحديثة ((التقنية العالية )) المعاصرة ضمن شروط التطور الرأسمالي على الأقل منذ بداية الثمانينيات وهذا كان السبب المباشر في تحقيق عوامل وقفزات النهوض فالرأسمالية الغربية تجد في الصين بيئة مثالية لنقل مصانعها بفضل انخفاض كلفة الإنتاج ووجود نظام سياسي ذي طابع مركزي يضمن انضباط القوى العاملة وانتظام سلاسل الإنتاج والتوريد، غير أنّها لا تنظر بالارتياح نفسه إلى احتمال تحوّل الصين المعاصرة من مجرد مصنعٍ للعالم إلى مركزٍ للابتكار التكنولوجي المستقل، قادر على منافسة الغرب في إنتاج المعرفة والتقنية العالية، وبذلك يمكن القول أنّ التجربة الصينية تمثّل مفارقة تاريخية: فهي تسعى إلى تموضع وموقع غير إمبريالي في النظام الدولي، وهي تفعل وتحقق ذلك من داخل إرث تاريخي مابعد كولونيالي لم يُمحَ تماماً، ومن خلال أدوات اقتصادية وسياسية وطنية تحمل في طياتها توترات رأسمالية الدولة ونظام الحزب الواحد داخلياً و احتمال مواجهة مفتوحة مع قوى دولية مهيمنة ومتربصة، ما يجعل من «التجربة الصينية» ظاهرةً مركّبة معقدة يصعب اختزالها في قراءة يغلب عليها النظرة السطحية والاختزالية للعقل الثقافي الغربي. هذه التجربة التي استطاعت خلال العقود الأخيرة أن تؤمّن حدودها وتنتقل من مرحلة الدفاع الداخلي إلى الانفتاح الخارجي المدروس، مدفوعةً بطموحات متنامية تشبه — في بعض ملامحها — تلك التي كانت لدى الولايات المتحدة قبل قرنٍ من الزمان، لكن بدوافع جيوسياسية مختلفة تماماً. فالصين اليوم لا تتبنى مشروعاً تبشيرياً يسعى إلى تصدير نموذجها السياسي أو فرض منظومتها الثقافية القيمية على الآخرين، بل تنطلق من مقاربة براغماتية تركّز على تحقيق أمنها القومي وضمان استدامة نموها الاقتصادي.
فجوهر التوجّه الصيني يتمثل في تأمين الموارد الحيوية — كالطاقة والمعادن والفلزات الاستراتيجية — الضرورية للحفاظ على مستوى المعيشة المتنامي لشعبها، الذي يمثل خُمس سكان العالم وطبقة وسطى لها حاجات وتطلعات حياتية ملحة. ومن ثمّ، فإن تمددها الاقتصادي في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية لا يعكس سعياً للهيمنة بتاتاً، بل استجابةً منطقية لحاجاتها التنموية وموقعها المتصاعد في نظام دولي في خلل وأعطاب متعددة ومع ذلك، فإنّ ما يُميز العقل الجيوسياسي الصيني هو الجمع بين متطلبات الاستقرار السياسي الداخلي والتخطيط الاقتصادي طويل المدى في إطار رؤية إستراتيجية متكاملة تُعرف باسم «الحلم الصيني»، الذي صاغه الرئيس الحالي السيد شي جين بينغ، ويهدف إلى إحياء استمراري للأمة الصينية بوصفها قوة حضارية واقتصادية مستقلة. تقوم هذه الرؤية على ثلاثة أعمدة: التنمية التكنولوجية المستقلة، تعزيز السيادة الوطنية، والانفتاح الانتقائي على النظام العالمي بما يخدم المصالح الصينية دون الاندماج الكامل في منظومة الغرب الليبرالية.
تتجلّى في السياسة الخارجية الصينية ملامحُ استخدامٍ مزدوجٍ للقوة الناعمة والصلبة بقالب هادئ ومتزن بهدف تعزيز مصالحها. فمبادراتٌ ك«الحزام والطريق» تعبّر عن مساعٍ منظّمة لبناء شبكةٍ واسعةٍ من النفوذ الاقتصادي تمتدّ عبر قاراتٍ عدّة، بما يُسهم في ترسيخ موقع الصين ضمن النظام الدولي ومع قادم الأيام سيبدد القطبية الأحادية. وقد جعلت هذه الاستراتيجية من الصين، إلى جانب مواقفها الحازمة في القضايا الإقليمية، فاعلاً دوليّاً يصعب تجاهله في معادلات السياسة العالمية.
يرى عالم الاقتصاد المصري الراحل سمير أمين أن نجاح التجربة التنموية الصينية لا يمكن تفسيره من خلال الانفتاح الاقتصادي أو تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، بل من خلال الأسس التي أرستها المرحلة الماوية في بناء قاعدة صناعية وطنية مستقلة وتنمية بشرية واسعة النطاق، فالصين – بخلاف كثير من دول الجنوب – لم تخضع لمنطق العولمة المالية، بل شاركت فيها بشروطها الخاصة، محافظةً على سيادتها الاقتصادية، ونظامها المصرفي الوطني، وسياستها النقدية المستقلة، فهذا التحكم الواعي والسيادي جعل من الانفتاح وسيلة لخدمة المشروع الوطني، لا أداةً لفرض التبعية، ويؤكد أمين أن الاستثمار الأجنبي استفاد من بيئة النجاح التي أنتجها المشروع الصيني ذاته لا العكس، بينما فشلت دول أخرى أكثر انفتاحاً في تحقيق نتائج مماثلة لافتقارها إلى قاعدة إنتاجية وطنية.
وفي سياق تحليله الأوسع للرأسمالية، ينتقد أمين النزعة التقديسية التي يحيط بها النظام الرأسمالي حول التكنولوجيا، حيث تُقدَّم بوصفها خلاصاً من تناقضاته البنيوية، في حين أنها تُسهم في تعميقها، فالرأسمالية في سعيها لزيادة الربح، ترفع من شأن “العمل الميت” المتمثل في رأس المال والتكنولوجيا على حساب “العمل الحي” أي قوة العمل البشرية، مما يؤدي إلى تفاقم أزماتها البنيوية وانكماش قدرتها على تحقيق الربحية المستدامة.
وهكذا يخلص أمين إلى أن الرأسمالية، مهما تجمّلت بإنجازاتها التكنولوجية، تظل نظاماً قائماً على الاستغلال والتناقض الداخلي، في حين أن التجربة الصينية تمثل نموذجاً فريداً لإمكانية التنمية المستقلة داخل عالم تهيمن عليه الرأسمالية العالمية.
عبّر سمير أمين عن دعمه الصريح لما وصفه ب “التجاوز الصيني لإجماع واشنطن”، في إشارة إلى رفض الصين الخضوع للسياسات النيوليبرالية التي روجت لها المؤسسات المالية الدولية في تلك الحقبة. ورأى أمين في تجربة الملكية المختلطة التي جمعت بين آليات السوق ودور الدولة عنصراً جوهرياً في نجاح الصين في الحفاظ على سيادتها الاقتصادية والاجتماعية، دون التفريط في مبادئ العدالة والتنمية الوطنية الشاملة وهذا محرك العقل السياسي الصيني مع بدأ مرحلة الإصلاح الاقتصادي . نبع اهتمام سمير أمين بالصين، جزئياً، من قناعته الراسخة — التي كررها في أكثر من موضع من كتاباته — بأن الفترة الممتدة بين القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين، حين كانت الصين دولة متخلّفة وهامشية وخاضعة للهيمنة الخارجية، تُعد استثناءً تاريخياً لا يمثل طبيعة الصين الحقيقية. فبرأيه، إنّ تلك المرحلة لم تكن سوى انقطاع مؤقت في مسارٍ حضاري طويل هيمنت فيه الصين، على مدى أكثر من عشرين قرناً، على قلب العالم اقتصاداً وثقافةً، بوصفها أكبر وأقوى دول العالم، وأضخم سوق، والمحرّك المركزي للتجارة والتبادل في حركية الاقتصاد العالمي.
ومن هذا المنطلق، يرى أمين أن ما يحدث اليوم لا يمثل “صعوداً جديداً” بقدر ما هو عودة تاريخية إلى الوضع الطبيعي للصين في منظومة العالم. فالصين، في تحليله، ليست قوة ناشئة بالمعنى التقليدي، بل حضارة عائدة إلى مركزها التاريخي بعد قرنٍ من التهميش المفروض عليها بفعل الهيمنة الغربية. لذلك، يعتبر أمين أن استعادة الصين لمكانتها ليست مجرد احتمالٍ نظريٍّ بل كواقع مادي مباشر.

كونفوشيوس معاصراً:
تحمل كلمة تيانشيا (Tianxia) معنى «كل ما تحت السماء»، أي العالم بأسره وكليته وجميع البشر، كما تشير إلى أطروحة «المؤسسة العالمية» أو البنية الحاكمة للإنسانية جمعاء، ويُعد هذا المفهوم إطاراً فلسفياً وسياسياً ضارباً في القدم نشأ خلال حكم أسرة تشو في الصين (1046–256 ق.م)، حيث تم تصوّره كمرتكز لنظام عالمي شامل تدور الصين في قلب مركزه.
في رحلة العودة إلى ينابيع الحكمة الصينية، يستحضر الخطاب ثلاثة عمالقة من تاريخ الفكر التشريعي، تتدافع رؤاهم عبر القرون كموجات نهر يانغتسي المتلاحقة.
يطل شانغ يانغ من عصور ما قبل الميلاد، حاملاً مشعل المدرسة القانونية التي أسسها لاوتزي. ينحت الحكيم في رؤيته تماثلاً كونياً بين نظام السماء ونظام الأرض، فيصبح الحاكم خادماً للمملكة حين ينساب مع سنن الكون، ويصيغ قراراته انعكاساً للقانون الطبيعي. تتبلور الغايتان العظميان في فلسفته: تحويل الطاقة البشرية إلى قوة منتجة في الداخل عبر الزراعة، وإلى قوة دفاعية في الخارج عبر الاستعداد للحرب.
بعد قرون، يصل صدى هذه الحكمة إلى مفكر أضاف للبناء التشريعي طوابق جديدة. إنه وانغ آنشي في القرن الحادي عشر، الذي يرى أن استقرار “تيانجيا” – هذا العالم تحت السماء – مرهون بانتظام شرعه، وأن تطبيق القانون القويم هو الجسر الذي يعبر به المرء إلى وحدة الدولة.
أما الحلقة الثالثة في هذه السلسلة الذهبية، فهي زهانغ جوزهينغ في القرن السادس عشر، الذي يضع يده على الجرح الحقيقي: ليست الصعوبة في وضع القوانين، بل في إنفاذها بحزم واستمرار، حيث يصير الحكم وفق القانون هو العمود الفقري لأي دستور.
هكذا تتراصف هذه الحكمات الثلاث كحبات مسبحة، تنتقل من فلسفة الحكم الكونية إلى آليات التنفيذ العملية، منسوجة بخيط واحد يجمع بين الحكمة القديمة والتطبيق المعاصر.
في رحاب الفكر الصيني القديم، يتشابك نهران فكريان متعارضان حول أسس بناء الدولة المثلى. يلحظ الباحثون أن ترجمة هذه المفاهيم إلى اللغات الغربية غالباً ما تُختزل في إطار “دولة القانون”، لكن هذه الترجمة تحجب جوهر الجدل العميق الذي شغل مفكري الصين لقرون.
كان السؤال المحوري يدور حول الآلية الأمثل لضبط إيقاع المجتمع: أيقوم النظام على تربية النفوس عبر الشعائر والموسيقى والإقناع، كما دعا كونفوشيوس؟ أم يتحقق عبر القصاص والجزاءات الصارمة، كما رأى المشرّعون؟
من جهة، تتصدر المدرسة الكونفوشيوسية بدعوتها إلى “سلطان المعيار”، حيث يضبط الإنسان نفسه بنفسه، في نموذج للحكم الأخلاقي الذي يستند إلى الحق الطبيعي المتجذر في القيم الإنسانية.
وفي الجهة المقابلة، تنطلق المدرسة القانونية من رؤية مختلفة، فترى في التشريع الوضعي والأحكام الصارمة الوسيلة المثلى لمراقبة المحكومين وممارسة السلطة. هنا تتحول الدولة إلى آلة قانونية محكمة، حيث يخضع الجميع لسيادة القانون الذي يسنّه الحاكم.
هكذا يتجلى الصراع الفكري بين نهجين: أحدهما ينظر إلى الإنسان ككائن أخلاقي قابل للتربية والتقويم، والآخر يراه بحاجة إلى نظام صارم يحدد له مساره ويضمن انضباطه.
بينما كانت مملكة تشو تعيش فصولاً مضطربة من تاريخها، شهدت أرض الصين ميلاد واحدة من أعظم الفلسفات التي ستشكل وجدان الأمة لآلاف السنين. في مدينة تشوفو بمقاطعة شاندونغ الحالية، عام 551 قبل الميلاد، ولد كونفوشيوس ليرسم برؤيته مساراً جديداً للحكمة الإنسانية.
عاش هذا الفيلسوف العظيم في حقبة “الربيع والخالي” التي اتسمت بالاضطراب السياسي، لكنه استطاع أن يصوغ من هذه الفوضى نظاماً أخلاقياً متكاملاً. لم تكن الكونفوشيوسية مجرد فلسفة نظرية، بل نمط حياة يركز على بناء الذات والعلاقات الاجتماعية المتوازنة.
كان كونفوشيوس معلماً وباحثاً وأخلاقياً وسياسياً، واشتهر بأنه أبو النظام التعليمي في الصين القديمة. جمع تلاميذه حكمته في مؤلفات عديدة، يأتي كتاب “لونيو” في مقدمتها، حاملاً خلاصة رؤيته حول الأخلاق والسلوك القويم والبناء الأخلاقي للشخصية.
تقوم الرؤية الكونفوشيوسية على عدة ركائز أساسية: العناية بالفضائل الداخلية، والتأكيد على القيم الأخلاقية، واحترام نسيج المجتمع وتماسكه. كما أولت الفلسفة أهمية كبيرة لتبجيل الأسلاف، مع تركيزها على الفضائل الإنسانية التي تضمن للبشرية عيشاً في ظلال السلام.
ومن أبرز ما تميزت به هذه الفلسفة “القاعدة الذهبية” التي تدعو إلى ممارسة ما نتمنى أن يُمارس معنا، واجتناب ما لا نريد أن يقع علينا. هذه القاعدة الأخلاقية البسيطة في صياغتها، العميقة في دلالاتها، تجسد جوهر الرؤية الكونفوشيوسية للتعايش الإنساني.
غادر كونفوشيوس العالم عام 479 قبل الميلاد، قبل نحو عقد من ميلاد سقراط في اليونان، تاركاً إرثاً فلسفياً استثنائياً استمر يؤثر في الحضارة الصينية ويتجاوز حدودها ليغذي الفكر الإنساني العالمي.
أعاد الفيلسوف الصيني تشاو تينغيانغ (Zhao Tingyang) الذي يُعَدّ من أبرز الفلاسفة المعاصرين في الصين، ويُركّز في أبحاثه على الفلسفة السياسية، فلسفة التاريخ، والأنطولوجيا، عمله الأبرز والرئيسي لإحياء هذا المفهوم عام 2005، مقدماً تصوراً جديداً لنظام عالمي بديل عن النموذج الغربي القائم على مفاهيم الصراع الحتمي بين القوى المهيمنة، طارحاً رؤية أكثر عدالة وعقلانية وسعى تينغيانغ في مشروعه الفكري، الذي عرضَه في كتابه المعنون ((إعادة تعريف فلسفي من أجل إدارة العالم، (Redefining A Philosophy for World Governance)، إلى استلهام استعادي من التراث الفلسفي الصيني القديم لطرح نظرية حديثة للحوكمة العالمية قادرة على مواكبة كل تحولات العالم في عصر ما بعد الحرب الباردة، وتمهّد لإيجاد صيغة اجتماعية وسياسية مثلى وعادلة لمجتمع عالمي يتجاوز مفاهيم و حدود الدولة القومية التقليدية، إذ يرى أن هناك حاجة ملحة لمستوى تنظيمي أممي جديد يتجاوز الدولة القومية: نظام عالمي أو مؤسسة تُمثّل “الكلّ”.
يقوم هذا الطرح الفلسفي على قلب المنظور الغربي السائد الذي يعتبر “الدولة” الوحدة الأساسية في التحليل السياسي ويستبدلها بمفهوم “العالم” نفسه كوحدة مركزية تحتاج إلى مؤسسة عالمية تضطلع بوظيفة التنظيم والتنسيق ويرتكز ذلك على منظومة قيم ومبادئ تهدف إلى ضمان واستمرارية الانسجام والاستقرار العام، وتعظيم مفاهيم الخير المشترك للإنسانية جمعاء، بحيث تكون مصالح العالم بأكمله هي المعيار الأعلى والأسمى، لا مصالح الدول أو الجماعات أو الأفراد منفردين. الكونيّة/شمولية (inclusion of all) أي أن لا كيان يسقط خارج الحساب أو الاستثناء مهما كان عرقه أو لونه وانتمائه، وهنا النظرية تمثل دعوة مفتوحة للتعايش وليس السعي المحموم القائم بصلبه على النموذج الصراعي الذي يركّز على «الدولة الأقوى تفوّقاً» أوالهوس بمفاهيم ك «ميزان القوى»، فالنظرية التي يقدمها البروفيسور تينغيانغ تضع التعاون والتداخل السلمي وغير الصدامي كأطار نظري عام رغم الشمولية والمثالية العالية، فهي لا تدعو إلى محو الفوارق الثقافية أو القوميّة على الإطلاق، بل إلى احترامها ضمن إطارٍ عالمي أوسع قائم على مايسميها ب»المحاكاة المشتركة«(common imitation)، فيما يمكن تشبيهه ب”لعبة فكرية” يتخيل البروفيسور تينغيانغ ماتمثّله العلاقات الدولية، إذ أنه يتخيّل كياناتٍ (دولاً، شعوباً، أنظمة مؤسسات) تسعى كلٌّ منها لتحقيق مصلحتها الذاتية الخاصة، لكن هذه الكيانات تلاحظ وتولي استراتيجيات الآخرين أهمية بالغة، وتقلِّد ما يبدو “ناجحاً”، لكنه يؤكّد في ذات الوقت أن إستراتيجية ناجحة واحدة لا تكفي ما لم تكن قابلة للتقليد من جميع الكيانات الأخرى.
بمعنى آخر: ليس المهم أن تكون الاستراتيجية مفيدة لفردٍ أو دولةٍ واحدة أو كيان بذاته مستقل عن الآخرين بل يجب أن تكون وصفة جمعية للنجاح، بحيث عندما يكرّرها الجميع فلا تنهار وتتبدد، ولا تتحوّل إلى كارثة أي أن جماعيتها هو شرط وجودها واستمراريتها.
في هذا السياق يرى تينغيانغ أن النظام الدولي المعاصر القائم يحوي استراتيجيات قد تكون “ناجحة” في لحظة إنسانية وتاريخية معيّنة، لكن إذا تبنّاها الجميع فإن الاحتمال الأكبر أن تتحوّل إلى سباق تنافسٍ أو صراعٍ مدمر، لذا، نحتاج إلى استراتيجية “محاكاة مشتركة” تكون بنيوية، شاملة، قابلة للتبني من الجميع، وتُنتج توازناً أو سلاماً كلياً.
التحسين الكنفوشيوسي:(Confucian Improvement)

في عوالم الكونفوشيوسية، حيث تتداخل الأخلاق مع الحياة اليومية، يبرز مفهوم “اليي” كنجمٍ أخلاقي يضيء الدرب. إنها ليست مجرد استقامة ظاهرية، بل هي بوصلة داخلية ترشد الإنسان نحو السلوك القويم، وتُمثّل الجاهزية الأخلاقية العميقة لفعل ما هو صائب، مقترنةً بالإدراك الواعي لصحته.
وفي مسرح الحكم والسياسة، ترسم الكونفوشيوسية لوحة “التماثل الأعظم” – تلك المدينة الفاضلة التي تُحاكي في روحها النظم الاشتراكية، حيث المساواة تُنسج خيوطها بين جميع الأفراد. في هذه الجمهورية الإنسانية الشاملة، ينهض الحكم على قاعدة اختيار الأكفاء، بينما يتحمّل الحاكم عبئاً أخلاقياً جسيماً، تستمد شرعيته من نبع ثقة الشعب الذي يُكلّفه.
هنا، حيث تتصاهر الأخلاق مع السياسة، يظهر للحاكم المثالي مسؤولياته في تسعة أبعاد:
• يبدأ بنفسه فيصقل سلوكه الشخصي
• يحيط الموهوبين بهالة من التبجيل
• ينسج خيوط التعاطف مع نسيج أسرته وعشيرته
لتتشكل من هذه الخصال نسيجٌ حاكمٍ يكون فيه الأخلاقي سياسياً، والسياسي أخلاقياً، في تناغمٍ كونفوشيوسيٍ فريد.
تينغيانغ يقصد أن يتم تحويل مفهوم المصلحة من مصلحة فردية آنية أو قومية ضيّقة تنافسية إلى مصلحةٍ مشتركةٍ عمومية تبادلية أوسع، بمعنى إن أيّ تحسّن يَحصل عليه طرف يجب أن يعود بالفائدة على الجميع في الوقت ذاته، أو على الأقل أن يجعل إمكانية تحسّن الجميع حقيقية واقعية وملموسة والآلية التنفيذية تكون صناديق تضامن تعاونية، وفي اقتراحٍ فريدٍ من نوعه يقترح أن تنشأ آليات تقاسم وتبادل الخبرة التكنولوجية، تمويل المشاريع الدولية بشرطية المنفعة المشتركة، حوكمة عالمية تشترط أن أي نموذج تقني حداثي تنتجه أحد الكيانات وأثبت هذا المنتج تفوق في الكفاءة والأرباح يجب أن تُتاح ترخيصاته بأسعار ميسّرة للدول النامية مقابل مساهمتها في توفير العامل الجغرافي لبنية تحتية عالمية مشتركة لصناعة التقانة الفائقة التي تمثل اليوم عالمياً ما يمكن اعتباره الثورة التكنولوجية الجديدة. هذا برأيه يحوّل الابتكار التقني إلى «تحسين كنفوشيوسي» بدلاً من كونه مصدر احتكار و تنافس نزاعي أي أنه عبر مزيج من آليات القوة والنعومة (hard & soft power).
باستطاعة دولة أو تكتل دول أن تقود عملية التحسين الجمعي عن طريق تقديم نماذج عملية بدلاً من أن تكون مفروضة فرضاً سياسياً مباشر تقوده المنظومات التقليدية القائمة ((كالأمم المتحدة .منظمة التجارة العالمية )).
وعليه «التحسين الكونفوشيوسي» هو طموح فكري طوباوي يحوّل المصلحة من معطي خاص إلى معطي عام ججمعي الطابع؛ هدفه الرئيس ليس إلغاء الخصوصيات بل الاستفادة منها عبر تبادلها بمؤسسات تعمل على إعادة هندسة الحوافز و التعاون بحيث يصبح تحسّنُ أحدٍ من أفراد المجموع سبباً لتحسّن المجموع ككل.
ينتمي البروفيسور تينغيانغ إلى تيار الكونفوشيوسيون الجدد:
ظهرت الكونفوشيوسية الجديدة كتيار ثقافي في ثمانينيات القرن العشرين مع تنامي الاهتمام بالدراسات المعنية بتاريخ البلاد الكلاسيكي، بما في ذلك ذروة إنتاجه ممثلة بالفكر الكونفوشيوسي، كردّ فعل على تجاوزات الثورة الثقافية ستينيات القرن الماضي، فمنذ عشرينيات القرن الماضي تخلَّت النخبة السياسية والفكرية في الصين ونبذت إلى حدّ كبير الكونفوشيوسية، معتبرةً إيّاها عبئاً ثقافياً أعاق تنمية البلاد وتحديثها، فالأمة الصينية الحديثة التي انهارت أمام الغزو الأجنبي، في حاجة إلى تغيير في صلب عقيدتها الكونفوشية القائمة على الوسطية والبساطة تأملية الطابع إلى نظرية حداثية، مع ذلك، لم تخلُ كتابات الزعيم ماو تسي تونغ ومنظّري الحزب الشيوعي الصيني من الإشارات الإيجابية عن الروح الكونفوشيوسية وتأثيرها الواضح في تاريخ البلاد، خصوصاً خلال حرب التحرّر الوطني ضدّ اليابان.
يرتكز هذا التيار على هدفٍ يتمثَّل في بناء فهم وصياغة جديدين للفلسفة السياسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، عبر تجاوز ثنائية اليسار واليمين، وجعل الماركسية أيديولوجيا بطابع قومي صيني أكثر منها بطابع أممي دولي، لذلك يفسّر الكونفوشيوسيون الجدد صعود الصين بخصوصية حضارتها التي تمكّنت من تجاوز قرنٍ ونصف من الإذلال والعنف المنفلت على يد الغرب، وأن الماركسية لم تكن السبب الرئيسي في هذا التحول، ويميل أصحاب هذا التيار أن المهمة الملقاة على عاتق الجيل الحالي من المثقفين الصينيين تتمثل في «إضفاء الطابع الصيني على الماركسية» عبر جعلها كونفوشيوسية الجوهر لأن الكونفوشيوسية بما فيها من قيم براغماتية قادرة على تحقيق التوازن بين الفرد والنظام، وترسيخ الجدارة كمفهوم جماعي وسيادة الفضيلة كمبدأ عام، ويُرى أن الماركسية أدّت دوراً حاسماً في التاريخ الصيني من خلال إسهامها في الثورة التي أفسحت المجال لظهور الصين الحديثة المستقلة، غير أنها باتت بمعايير اليوم فلسفة قديمة ولا تتلاءم مع طبيعة وروح العصر الرأسمالي، وينبغي أن تُستوعَب((الماركسية)) داخل الحضارة الصينية كما استوعبت الصين البوذية خلال العصور الوسطى وأضافت لها خصوصيتها عندما قام الرهبان الصينيون بنقل النصوص البوذية ترجمةً، وإعادة صياغتها بما ينسجم مع المفاهيم الكونفوشيوسية والطاوية لبلادهم.
تيار الكونفوشيوسية الجديد يعتبر أن أهم المميزات الحضارية للصين تتجلى بكونها لا تستورد الأفكار والإيديولوجيات بشكلٍ خام أو كنماذج مكتملة جاهزة قابلة للتنفيذ بحذافيرها، بل تخضعها لآلية استيعاب معمق تُعيد موضعتها وقولبتها داخل منطقها القيمي المعرفي والحضاري الخاص، فالفكرة الوافدة تُحتضَن بالبداية، ثم تُهذَّب قبل أن تُدمَج في بنيتها الحضارية المتكاملة لتغدو عنصراً أصيلاً من عناصر هويتها، ومن خلال هذه العملية التحويلية المتدرجة تعود الفكرة إلى العالم وقد اكتسبت طابعاً صينياً أصيلاً كأنها وُلدت من جديد داخل سياق ثقافي مختلف وإن ظلّت تحمل جذرها وروحية منشأها الأصلي.

البراكسيس الجيوسياسي :
الفكر والنظرية بوصفهما مكوّنين أساسيين في عملية صنع القرار السياسي الصيني. فكل خطوة تُناقش في ضوء الإطار النظري والتراث الفكري الذي يستند إليه نظام الدولة. وعلى عكس ما يعتقده كثيرون، فإن الماركسية لا تقدّم “دليل استخدام” جاهزاً لإدارة المجتمع الاشتراكي أو نقله للشيوعية، بل تمثل منهجاً في التفكير أكثر من كونها وصفة تطبيقية جاهزة معلبة هي اليوم بمثابة البراكسيس والإطار المعرفي الفاعل ك “فلسفة عمل” ومظهراتها عديدة في حاضر الصين فلسفة عمل تحدد ,أشكال النشاط الإنساني الموضوعي الحسي، شأنها شأن كل النشاطات الإنسانية. غير أن خصوصيتها تكمن في كونها نشاطاً إنسانياً هادفاً لتغيير نمط علاقات الإنتاج الاجتماعية وتنظيمها بما ينسجم مع تطور القوى المادية في المجتمع. فالحياة الاجتماعية، في منظور ماركس، ليست مجرد بنية نظرية أو انعكاسٍ فكري للواقع، بل هي أحد أشكال العمل والممارسة في جوهرها، تتجسّد من خلال الفعل البشري الواعي الهادف إلى تحويل الواقع وإعادة بنائه على أسس أكثر عدالة ومساواة، لا تُستخرج وتستنبط السياسة في الصين من نصوص جاهزة أو نظريات مسبقة، بل تُستنبط من قراءة دقيقة علمية للواقع الملموس، أي أن النظرية تُستخرج من الواقع، لا العكس. وهذه هي القاعدة الأولى في الفهم والممارسة الصينية لفكر كارل ماركس، البراكسيس كفلسفة عمل هي التي مكّنت الحزب من تكييف الماركسية مع ظروف الصين وتحويلها من تعاليم عقائدية جامدة إلى منهج عملي للتنمية والتحول الاجتماعي قادة الصين وهم حزبيون بالمناسبة يعون أن المنجز الأساسي لماركس بما قدمه من تشريح عميق لبنية المجتمع الرأسمالي الأوروبي في منتصف القرن التاسع عشر، بينما قام البلاشفة من بعده بتشخيص البنية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا في مطلع القرن العشرين. وعلى المنوال ذاته، صاغ ماو تسي تونغ قراءته الخاصة للواقع الصيني في منتصف القرن نفسه، ثم جاء دنغ شياو بينغ لاحقاً ليعيد تحليل الظروف الجديدة التي واجهتها الصين مع بدايات العولمة، مؤسِّساً بذلك مرحلة جديدة من التطور الماركسي التطبيقي تستجيب لتحولات العصر دون أن تفقد صلتها بجوهر “المادية الجدلية” وتتجلّى أهمية البراكسيس الجيوسياسي هنا في أن الفكر الصيني المعاصر لا ينظر إلى النظرية بوصفها منظومة مغلقة أو نموذجاً استيرادياً جامداً، بل كأداة لفهم التناقضات الداخلية والخارجية وإعادة صياغة الموقف الصيني منها على نحو واقعي ومرن. فالتاريخ لا يُعاد إنتاجه من خلال النقل، بل من خلال الفعل الواعي الذي يربط النظرية بالممارسة. ومن هنا تنبع قدرة الصين على تحويل الماركسية إلى أداة سيادية معرفية، تُستخدم لتفسير العالم من منظورها الخاص لا من منظور المركز الغربي.
إنّ البراكسيس الصيني، في جوهره، هو عملية جدلية مستمرة بين الفكر والفعل، بين النظرية والممارسة، تسعى لتحقيق الانسجام بين المادي والمعنوي، بين الاقتصاد والسياسة، وبين الإنسان والواقع الاجتماعي. هذه الجدلية هي التي سمحت للنظام الصيني بأن يبلور مقاربة فريدة للعلاقات الدولية تقوم على “النهضة السلمية” و”مجتمع المصير المشترك للبشرية”، بوصفها امتداداً طبيعياً لفهم فلسفي موسع يرى في التفاعل والتوازن بين القوى أساساً للوجود، لا الصراع والإلغاء.
وعليه، فإن البراكسيس الجيوسياسي ليس مجرد تطبيقٍ عملي للفكر الماركسي بنظرياته وأطيافه المتعددة، بل هو صياغة صينية خاصة للماركسية؛ صياغة تعيد الاعتبار للواقع بوصفه منبع النظرية وهدفها في ذات الوقت. وعليه فكل قرارٍ سياسيٍّ، مهما بدا تكنوقراطياً أو اقتصادياً بحتاً، يستند إلى رؤية فلسفية ترى أن التاريخ حركة واعية للروح في بعدها الاجتماعي — روحٌ تسعى لا إلى الهيمنة بل إلى التوازن والانسجام المتعقل. ومن هنا تكتسب الماركسية الصينية طابعها المميز كفلسفة عمل، وك”براكسيس حضاري” يتجاوز التجريب السياسي نحو تشييد نمطٍ جديدٍ من التفكير العالمي.
“إذا كان قاموس نيوطن يمكننا من التكهن بأحوال العالم أفضل من قاموس أرسطو، فإن هذا لا يعني أن العالم يتكلم النيوطونية. إن العالم أخرس. فقط نحن الذين نتكلم“.
Richard Rorty. Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge University Press, 1989, p. 6.
في متاهة الزمن، حيث تتصارع المسارات وتتشابك الخيارات، تنبعث من أعماق التاريخ أربع ثقات تشكل دعامات الوجود. فهناك ثقة في النفوس، وثقة في العقل، وثقة في المؤسسات، وثقة في الروح.
إن الثقة في الطريق هي النبع الأول الذي ينضح منه كل يقين، فهي اللحظة التي يلتقي فيها ماضي الأمة بمستقبلها، حيث تذوب قرون من التراث الحضاري في بوتقة التجربة المعاصرة. إنها الحكمة التي تتشكل من خلال خمسة آلاف عام من الإرث الثقافي، مختزلة في سبعة عشر عقداً من البحث والتمحيص عن المسار الأفضل.
لقد ولدت هذه الثقة من رحم المقارنة التاريخية، من حوار الأجيال المتعاقبة، من محاولات السقوط والنهوض، من تمحيص المسارات واختيار الأكفأ. إنها ليست مجرد شعار يرفع، بل هي خلاصة رحلة إنسانية طويلة، حيث تلتقي حكمة الماضي بضرورات الحاضر، وتنصهر في بوتقة واحدة لتشكل يقيناً لا يتزعزع.
فالثقة هنا ليست وهماً يُتخيل، بل هي حصاد تجربة إنسانية عابرة للقرون، هي الجسر الذي يربط بين تراث الأمس وطموح الغد، بين أصالة الماضي وابتكار المستقبل. إنها البوصلة التي تشير دوماً إلى اتجاه التطور، المرسومة بخطوط من ذهب التاريخ وبألوان من أمل المستقبل.
في عصر تتسارع فيه وتيرة التطور العسكري، تبرز الحاجة الملحة للتدبر في سيناريو الصراع المحتمل بين القوى العظمى. لقد بلغت تقنيات الاستشعار وتوجيه الذخائر والشبكات الرقمية – تلك العيون والسيوف الرقمية في ساحة المعركة الحديثة – مرحلة متقدمة جعلت القوات الأمريكية والصينية في وضعية تهديد متبادل لا سابق لها.
هذه الثورة التقنية لم تقدم فقط الأدوات للضربة الاستباقية، بل ولّدت دافعاً لا يُقاوم لاستخدامها. فأمام هذا التوازن الهش، يجد الطرفان نفسهما مدفوعين نحو سباق محموم لإنزال الضربة الأولى، في سباق ضد الزمن يخشى فيه كل منهما من تفويت الفرصة.
وهكذا يولد منطق غريب للحرب: اندفاع نحو حافة الهاوية، حيث تتبادل الضربات الموجعة منذ اللحظات الأولى، دون أن يمتلك أي من الخصمين ميزة حاسمة. يتحول الصراع إلى معادلة مرعبة: قدرة مستمرة على القتال رغم تنامي الخسائر، وإصرار على المواصلة بغض النظر عن التكاليف الاقتصادية والبشرية. إنها حرب لا غالب فيها ولا مغلوب، فقط خسائر متراكمة ودمار متبادل
في عالم اليوم، لم تعد السفن التجارية الصينية تبحر محملة بالحرير والخزف فقط، بل تحمل الآن أرصدةً تجاريةً ضخمةً تمتد عبر المحيطات. فما أن يرفع جيرانها في العالم شعارات التبادل التجاري، حتى تتدفق الأرقام لتكشف عن فجوة هائلة – فوائض تجارية تتجاوز ال 380 مليار دولار في مواجهة واحدة فقط، كأنما الاقتصاد الصيني يشبه نهراً يفيض بلا توقف.
حيث لم تعد المنتجات الصينية مجرد سلع رخيصة تأتي من بعيد، بل تحولت إلى استثمارات ذكية تنطلق من مراكز التسوق في باريس إلى المصانع في فرانكفورت، من ناطحات السحاب في لندن إلى موانئ روتردام.
الأرقام تتحدث عن قصة نجاح مبهرة: من 840 مليون دولار إلى 42 ملياراً خلال ثماني سنوات فقط، كأنما الاستثمارات الصينية في أوروبا تشبه بذرة نمت فجأة لتصير شجرة عملاقة، جذورها تمتد في التربة الأوروبية، وأغصانها تظلل أسواق القارة العجوز.
هكذا تنسج الصين بطريقتها الهادئة الواثقة لوحة اقتصادية جديدة، حيث تتحول من دولة تنتظر المستثمرين إلى شريك اقتصادي يضع بصمته في كل بقعة من العالم.

الصين في واقع جيوسياسي متغير عن الصراع الأميريكي الصيني :
بينما كان العالم ينسج خيوط اقتصاده على منوال النمر الآسيوي، وجد نفسه فجأة في حبال السَّراة يعتمد على عملاق واحد يسهم وحدده بنحو خمس الاقتصاد العالمي. لم تعد الصين مجرد شريك تجاري، بل تحولت إلى القطب الذي تدور حوله عجلة الصناعة العالمية، فأصبحت المصنع الذي لا يعرف السكون.
لكن هذا الارتباط الشديد أشعل القلق في قلب العملاق الآخر وراء المحيط. رأت الولايات المتحدة أن الاعتماد المفرط على محور واحد يشكل ثغرة في جسد الاقتصاد العالمي، فبدأت تدفع بأذرعها الدبلوماسية والاقتصادية نحو تشجيع الشركات على التنويع، وعدم وضع كل البيض في السلة الصينية. وزاد من حدة الموقف قدوم رئيس أمريكي جديد، يحمل في جعبته وعوداً صريحة بفرض رسوم جمركية إضافية، كسهام موجهة نحو قلب الصناعة الصينية.
لم تنتظر كثير من الشركات طويلاً، فبدأت رحلة الهجرة الصناعية من موانئ الصين إلى مرافئ جديدة في آسيا. حتى بعض الشركات الصينية نفسها انضمت إلى الركب، خوفاً من أن تتحول الاشتباكات السياسية إلى نار حرب مشتعلة حول تايوان، وهو ما قد يعطل تدفق أشباه الموصلات التي تعتمد عليها التقنية العالمية.
وفي خضم هذه التحولات، انتبهت دول آسيوية عديدة إلى الفرصة الذهبية، ففتحت أبوابها على مصراعيها لاستقبال الاستثمارات الهاربة. ففي الهند، رفع عملاق التكنولوجيا “أبل” رايته، وبدأ في إنتاج ربع هواتفه الآيفون هناك. بينما احتضنت إندونيسيا شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، وأصبحت محطة جديدة لسلاسل توريد الطاقة النظيفة.
أما تايلاند، فقد ركزت على صناعة السيارات، في حين استفادت فيتنام من انخفاض تكلفة اليد العاملة وقربها الجغرافي من الصين، فازدهرت لديها الصناعات الخفيفة. ولم تبتعد بنغلاديش عن السباق، بل ركزت على صناعة المنسوجات والملبوسات، لتثبت أن لكل دولة دوراً في هذه الخريطة الصناعية الجديدة.
رغم رحيل عدد من الشركات الأجنبية عن الساحة الصينية خلال عام 2023، إلا أن البلاد حافظت على موقع تنافسي متفرد بين نظيراتها الآسيويات. فمقومات الجذب لا تزال قوية، تجسدت في بنية تحتية متكاملة، وأنظمة لوجستية متطورة، وقوى عاملة عالية التخصص، إلى جانب سوق محوري يتسم بطلب محلي متصاعد.
من جهة أخرى، يواجه مسار انتقال الشركات إلى دول أخرى جملة من التحديات، حيث تثقل تكاليف النقل والترحال كاهل هذه الخطوة، ناهيك عن استثمارات التعلم في بيئات جديدة، وإعادة تأهيل الكوادر، واستيعاب التقنيات الحديثة. كما تظل مخاطر الاختلافات النظامية وهشاشة حماية الملكية الفكرية عوامل مثبطة لأي تحول سريع.

خاتمة الكلمة:
في ختام هذه الأطروحة، يظهر جليا بأن التجربة الصينية لا تمثل مجرد قصة نجاح اقتصادي، بل هي “ظاهرة تاريخية وحضارية”، تمثل مساراً فريداً من نوعه في تاريخ الأمم. النظر إلى مسار الصين التاريخي من الضعف في امبراطورية “تشينغ” المتداعية، مروراً بقرن من التدخل الأجنبي، وصولاً إلى مكانتها كقوة عظمى في القرن الحادي والعشرين، يكشف عن قدرة صينية استثنائية على استيعاب الصدمات التاريخية وتحويل فترات الضعف والاستتباع إلى دافع ومحفز للنهوض القومي.
هذه العملية لم تكن إصلاحات سياسية او ثورات ثقافية، بل كانت تمثل حالة إحياءً حضاري قومي_اممي. أوصلت الصين اليه إرادة صلبة لنظام سياسي مركزي، عازم على استعادة مكانتها التاريخية ووضعها في طليعة القوى التي تجدد كل المفاهيم في العالم ارتكازا على التجربة والقدرات والمشروع والمراكمة.
لقد نجحت الصين في صياغة نموذج ناجح للدمج بين النظرية والممارسة، وهو مفهوم أصبح اليوم منهجاً متكاملاً للعمل السياسي والاقتصادي عالميا. حيث تتم المزاوجة ببراعة بين النظرية الأيديولوجية للحزب الشيوعي والبراغماتية الاقتصادية التي أطلقها الرئيس دنغ شياو بينغ تحت شعار “اشتراكية ذات خصائص صينية”.
بهذا، تجاوزت الصين الثنائيات التقليدية التي حكمت الفكر السياسي الغربي، مثل ثنائية الشرق والغرب، لقد قدمت نموذجاً تنموياً بديلاً يرتكز على التعبئة العامة والشاملة للموارد البشرية والمادية، والاستفاده من كل عناصر المجتمع والأرض والدولة. والتخطيط طويل الأمد الذي امتد وسوف يمتد لعقود، مما جعلها تتمكن من تحقيق قفزات تنموية واقتصادية ومالية لم يستطع أي نظام آخر أن يحققها.
إن تحليل هذا النموذج يؤدي إلى فهم الانتقال المنهجي من مرحلة “النهوض” (ماو تسي تونغ)، التي وحدت البلاد وأرست دعائم الدولة الحديثة القادرة على “الحشد القومي” إلى مرحلة “الانجاز” (دنغ شياو بينغ)، التي حررت الطاقات الاقتصادية وأطلقت المعجزة التنموية، وصولاً إلى مرحلة “القوة الراسخة” (شي جين بينغ)، التي تركز على الابتكار التكنولوجي، ومكافحة الفساد، وتأكيد النفوذ الجيوسياسي العالمي من خلال مبادرات مثل “الحزام والطريق”.
هذه التجربة الصينية لم تعد شأناً داخلياً، بل صارت تحديا عالميا أعاد تشكيل الخريطة الاقتصادية والجيوسياسية للعالم وطرح على العالم لغة سياسية وافكار واساليب وقدرات جديدة وهائلة، مما اثار الذعر لدى النظام الليبرالي الغربي الذي ساد في القيادة الاممية منذ نهاية الحرب الباردة. الأمر الذي ترجمه الغرب من خلال اعتبار الصين التحدي الأخطر في كل استراتيجيات الأمن القومي لحكومات الغرب في العشرين سنة الماضية. وعلى هذا الاساس يخوض الغرب اليوم حروبه ويغذي الصراعات السياسية والعسكرية ذات الابعاد الجيوسياسية للحد مما يسميه مخاطر التمدد الصيني ومشاريع الصين العملاقة في مختلف دول العالم.
والحال هذه فإن فهم الصين يتطلب التحرر من الأطر التحليلية التقليدية. لانها ليست مجرد دولة تسعى للاصلاح السياسي والاقتصادي والنمو، بل هي حضارة عريقة تعيد اكتشاف ذاتها وتطرح نموذجاً بديلاً للحداثة وفق الرؤية الغربية. إن استمرار نجاح هذا النموذج، وقدرته على معالجة تحدياته الداخلية والخارجية، سيؤثر ليس فقط على مستقبل الجغرافيا السياسيةحول الصين، بل على مستقبل النظام العالمي، وما المخاضات التي يعيشها العالم منذ سنوات إلا ممر اجباري للوصول خلال سنوات مقبلة إلى نظام عالمي متعدد القطبية بدأت ملامحه تظهر بوضوح. نظام عالمي قائم على موازين قوى جديدة تنبثق عنها شراكات متوازنة عادلة للجميع ولا تقوم على منطق الهيمنة والاخضاع والاستتباع.
المراجع والمصادر باللغة العربية:
- إدوارد سعيد — الثقافة والإمبريالية، ترجمة كمال أبو ديب، دار الآداب، 1997
- الأستاذ محمد الداودي أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا، شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها في موضوع النزعة الكارثية لفكر ما بعد الحداثة ” ، بجامعة محمد الخامس بالرباط.
- ترجمة عربية لــHardt & Negri — Empire عنوانها بالإنجليزية – Michael Hardt & Antonio Negri — Empire. Harvard University Press, 2000. موجودة (راجع فاضل جتكر/الطبعات العربية).
- صموئيل هنتنغتون. صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي. ترجمة طلعت الشايب، مؤسسة الهنداوي، 2004.
/83793037/https://www.hindawi.org/books
- طارق علي — صدام الأصوليات: الحروب المقدسة وصناعة الإرهاب، دار الساقي، 2003.
- عبد الله العروي — الإيديولوجيا العربية المعاصرة، المركز الثقافي العربي، 1992.
- عبد الوهاب المسيري — الفكر الغربي: رؤية نقدية، دار الشروق، القاهرة، 2000.
- فرانسيس فوكوياما — نهاية التاريخ والإنسان الأخير، ترجمة حسين الشيخ، دار سطور، 2018.
المراجع والمصادر باللغة الإنجليزية:
- 2lbardisy, R. (2016). “A Clash of Civilizations’ or a ‘Clash of Ignorance’?: Edward Said’s critique of Samuel Huntington.” Journal of Women’s Studies, Faculty of Women, Ain Shams University. Retrieved from :https://opde.journals.ekb.eg/article 106574 e936ac94397776385d6d53073a636e10.pdf
- Alexandre Kojève — Introduction to the Reading of Hegel: Lectures on the Phenomenology of Spirit. Cornell University Press, 1980.
- Daniel Vukovich — Illiberal China: The Ideological Challenge of the PRC. Palgrave Macmillan, 2019.
- Duke University Press, 2004.
- Edward S. Herman & Noam Chomsky — Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon Books, 1988
- Homi K. Bhabha — The Location of Culture. Routledge, 1994.
- Immanuel Wallerstein — World-Systems Analysis: An Introduction.
- Jon Stewart (ed.) — The Hegel Myths and Legends. Northwestern University Press, 1996
- Joseph S. Nye Jr. — Soft Power: The Means to Success in World Politics. PublicAffairs, 2004.
- MORIN Edgar, (Entretien), Communications, n°57, octobre 1993, p136 -3
- Puranen M.: Warring States and Harmonized Nations. Tianxia Theory as a World Political Argument (Doctoral Dissertation), JYU Dissertation. Retrieved from: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71032.
- Puranen M.: Warring States and Harmonized Nations. Tianxia Theory as a World Political Argument (Doctoral Dissertation), JYU Dissertation. Retrieved from: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71032.
- Richard Rorty. Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge University Press, 1989, p. 6.
- Shih Shu-mei — Visuality and Identity: Sinophone Articulations across the Pacific. University of California Press, 2007.
- Shih, S. (2017). The Concept of the Yellow Peril: An Analysis of Western Discourses on Asia. Journal of Asian Studies, 76(2), 345–368.
- Shih, S. (2017). The Concept of the Yellow Peril: An Analysis of Western Discourses on Asia. Journal of Asian Studies, 76(2), 345–368.
- Xiaomei Chen — Occidentalism: A Theory of Counter-Discourse in Post-Mao China. Oxford University Press, 1995.
- Xiaomei Chen — Occidentalism: A Theory of Counter-Discourse in Post-Mao China. Oxford University Press, 1995.
جميع الحقوق محفوظة لمركز كلمة للدراسات والبحوث الجيوسياسية 2025©

